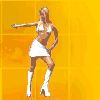|
|
|
|
|
|
آليات الفن الجماهيرى
دراسة على
النوع الوحيد من الفنون القادر على
أوسع وأعمق تشكيل ممكن
لوجداننا وربما أيضا عقولنا :
الفن الهابط !
( الجزء الأول )
Popular Art Mechanisms
A Study on the only Type of Arts That Is Able to
the Widest and Deepest Possible Formation of
Our Senses and, Maybe, Our Minds Also:
The Low Art!
(Part I)
| FIRST | PREVIOUS
| PART I | NEXT | LATEST |
NEW: [Last Minor or Link Updates: Monday, October 31, 2011].
![]() February 7, 2002: A HISTORY MADE: Videogame business tops film industry for
the first time. Are we talking about ‘the’ new main form of Human Culture?
February 7, 2002: A HISTORY MADE: Videogame business tops film industry for
the first time. Are we talking about ‘the’ new main form of Human Culture?
![]() January 14, 2002: Citizen, Detective and Thief, a historical
conciliation between Intellectual, Authority and Religion or just another
troubled movie?
January 14, 2002: Citizen, Detective and Thief, a historical
conciliation between Intellectual, Authority and Religion or just another
troubled movie?
![]() December 13, 2001: Believe it or not? The new Egyptian model of hero: Hajj
Metwally, the husband of four!
December 13, 2001: Believe it or not? The new Egyptian model of hero: Hajj
Metwally, the husband of four!
![]() June 22, 2001: A STAR IS TORN: The most popular actress in Egyptian film
history died. Not an accident. Not a suicide. Just a plain vanilla murder.
June 22, 2001: A STAR IS TORN: The most popular actress in Egyptian film
history died. Not an accident. Not a suicide. Just a plain vanilla murder.
…
![]()
ê Please wait until the rest of page downloads ê
Cover Story:
(The Second
Half of Year 1999) صحوة السينما المصرية Egyptian Cinema Awakening
أشكر صاحب فكرة هذه الندوة محسن ويفى [ سكرتير الجمعية ولاحقا ‑2009‑
رئيس مجلس إدارتها ] ، لالتقاطه خيط محاولاتى
المستمرة لتفسير هذه الظاهرة ورغبتى فى كسر تجاهل النقاد لها ، وأحد مظاهره
المسابقة السنوية للجمعية لاختيار أفضل فيلم والتى لا تهتم إلا بأفلام لا تؤثر
بالمرة فى عموم الشعب ، وتتجاهل الأفلام الأوسع أثرا كما تنكر عليها
تقاناتها العالية ومضامينها الجيدة فى أغلب الأحيان .
هذه منطقة بكر ، وما أقدمه ليس إلا اجتهادات
أولية كأرضية أملى أن تساعدكم على التفكير فى المشكلة من بداية ملموسة ما ،
وبالمقابل مشاركتكم سوف تساعدنى تأكيدا على التنقيح والتعميق ( وساندرا پوللوك
قالت مؤخرا إن الذكاء أن تحيط نفسك بأناس أفضل منك ! ) . السؤال الأول : ما هو التوصيف الأولى
للظاهرة ؟ هل ’ تفشى الطابع الهزلى ‘ كما يقول بيان
جمعية النقاد كل سنة ؟ الحقيقة أن علاء ولى الدين أو حتى هنيدى ليس
هزلا ! التوصيف المقترح : - انفجار فجائى من قلب سينما متداعية كان قد انفض
عنها الجمهور بالكامل تقريبا ، باستثناء أفلام نجم واحد هو عادل
إمام .
- عودة
الطبقة الوسطى لمشاهدة الأفلام المصرية وخروج أسر الطبقات الفقيرة لأول مرة
للسينما . فبعد أن اعتدنا عقودا القول إن الجمهور هو جمهور الحرفيين ،
أصبح الحرفيين وغير الحرفيين زائد ‑ولأول مرة‑ زوجاتهم
وأولادهم ، ولولا كل هذا معا ما تتحقق أبدا عشرات الملايين . السؤال الثانى والأكبر هو بالطبع : ما هو
التفسير ؟ أولا : هل هى ظاهرة اقتصادية عامة ، جاءت
فى وقت حكومة الدكتور الجنزورى الإصلاحية المحاطة بالآمال والطموحات الكبار .
بمعنى هل كان الناس فى مزاج جيد وأوضاع مادية أفضل نسبيا تسمح بالإنفاق على
الترفيه أكثر مما سبق ؟ الواقع أن حكومة الدكتور الجنزورى لم يحتملها أحد
وسقطت سريعا ، وأخذت مصر المستسلمة بعدها مسار القصور الذاتى نحو هاوية
اقتصادية ، لكن ظاهرة الرواج السينمائى لم تتراجع . إن لدينا من عام
2001 تحليلات أميركية تقول إنه فى ظل تراجع اقتصاد الولايات المتحدة لا تزال
صناعات الترفيه تتقدم بقوة . الحقيقة أن السينما اعتادت فعل هذا بدرامية
مثيرة منذ عصرها الذهبى المنبثق من قلب الكساد الكبير للثلاثينيات وحتى فبراير
هانيبال الأسود ! ( الحقيقة أن بيزنسات بعينها تزدهر فى ظل ظروف
البطالة القاسية ، وعندنا حاليا مثلا لذلك تجارة نبات البانجو وبيزنس
المقاهى ، وصفحات الجريمة بالصحف تخبرنا كيف أن الحصول على النقود نادرا ما
يكون هو المشكلة ! وتكرار ما حدث للسينما فى الثلاثينيات اليوم ،
يرتقى بالأمر من مجرد ظاهرة ، إلى مصاف القانون [ تابع بالأسفل ] ) .
ثانيا : هل هى ظاهرة تتعلق بصناعة السينما
تحديدا ، بعد أن وصل عدد شاشات السينما الحديثة المفتتحة فى التسعينيات إلى
العشرات فى سنة الانفجار 1997 ؟ غير صحيح ، فتلك الشاشات بناها موزعو
الأفلام الأجنبية لأفلامهم متواضعة الجماهيرية أصلا . بالتالى
’ إسماعيلية … ‘ ومع إهمال أنه هبط بخجل أمام غول إعلامى يحظى بكل طبل
المثقفين اسمه ’ المصير ‘ ، لم يكن يعرض إلا فى 11 دار عرض منها
7 فى القاهرة وحدها و4 فقط فى كل الجمهورية ( ’ المصير ‘ كان
يعرض فى 19 شاشة ، وهو يساوى تقريبا الرقم القياسى المسجل قبل أسابيع قليلة
باسم عادل إمام وفيلم ’ بخيت وعديلة 2 ‘ والأزيد بشاشة
واحدة ) . إذن الأرجح العكس ، أن الظاهرة هى التى عززت الصناعة
بحيث تسارع افتتاح الشاشات ، واليوم الرقم القياسى بنظام النسبة وحده هو 55
شاشة ، ’ لبلية ودماغه العالية ‘ ذلك فى الأسبوع الثانى له خلال
يوليو 2000 . ثالثا : هل هو محتوى الأفلام ؟
الإجابة للوهلة الأولى هى نعم : فهنيدى نقطة تحول فى التعبير عن قيم
الطبقات الدنيا ، ومدافع صريح عن هذه القيم المتوجسة الجاهلة والمعادية
للغير وللتقدم ، بحيث يمكن تصنيفه بدقة مدهشة كالمناظر الكوميدى لكاتب
الدراما الپارانويى الرجعى أسامة أنور عكاشة ، حيث كلاهما أبوى متسلط منغلق
ولا شغل شاغل له إلا الدفاع التفصيلى عن ’ الهوية ‘ ومفرداتها ،
رغم علمهما اليقينى أن هذه الهوية هى تحديدا سر كل الخراب والتخلف الذى نحن
فيه . فى ’ بلية … ‘ يصفع محمد هنيدى صبيا على وجهه ،
وفى حدود علمى لا توجد سابقة لتبنى صفع الأطفال كأسلوب تربوى ، إلا أشغال
أسامة أنور عكاشة ومنها مثلا مسلسل ’ أرابيسك ‘ ، حيث على الأقل
كان أبو بكر عزت قد فعل ذات الشىء . الفارق الوحيد أن هنيدى فعلها لردع ضعف
الإيمان بالرب ، وأسامة أنور عكاشة يفعلها لردع ضعف الإيمان بالوطن !
’ امرأة من زمن الرعب ‘ ‑والأخطاء المطبعية تحدث ، أحيانا
منا وأحيانا أكثر من المسلسلات‑ فعلت أشياء أشد شناعة بخلاف الصفع على
الوجه ، منها التجسس والتآمر والترهيب ، لكبح تمرد الأبناء والبنات
وانطلاقهم ومحاولتهم الانفتاح على العالم المتقدم ، والذى لا يرى السيد
عكاشة شاغلا أو وظيفة له فى الكوكب إلا تصدير العقاقير المخدرة للشعب
المصرى . وها هى نفس القصة عادت لتطل من جديد بدماغ عالية ، بعد أن
كانت تفعل كل ذات الأشياء ’ تحت الصفر ‘ . إنها إذن منظومة كاملة
من الترويج للقهر والإرهاب والبطش ، ليس وراءها إلا هدف واحد ، هو
توريث أحقاد وهزائم ذلك الجيل إلى الأجيال الأحدث ، ولإحكام السيطرة عليهم
تارة باستخدام الدين وتارة باسم الوطنية . بدأنا الكلام بعبارة ’ للوهلة الأولى ‘ ،
ذلك أن الصورة سرعان ما تعقدت وأصبح هنيدى أقرب لصبى لقيط تائه ، وسط حشد
من النجوم يمثلون الطبقة الوسطى ويتبنون قيما تقدمية بما لايقارن ، ومن
خلفهم كاتب أو أكثر بالغو الاستنارة مثل أحمد عبد الله ، صاحب السخرية
المقذعة المطولة من محمد متولى الشعراوى فى ’ ألاباندا ‘ ، ومن
كل التاريخ المصرى فرعونى وإسلامى ووطنى فى ’ الناظر صلاح
الدين ‘ ، ويعهدون بأفلامهم لموجهين مثل شريف عرفة ممن يملأون غرف
أبطالهم بصور ضخمة لنجمات هولليوود غالبا ما يأتون بها من غرفهم هم
الخصوصية ، أو مسار الصوت بأفضل ما يمتعهم شخصيا من الأغانى الغربية من
أحدث طراز . أصبح أولئك النجوم أكثر نجاحا من هنيدى نفسه بمرور
الوقت ، ولم يعد البطل هو ذلك المنتمى لقاع المجتمع ، والمصدوم دوما
بالطبقة الأرقى من زملائه فى الجامعة الأميركية ، ويغنى بالتالى
’ نفسك فى إيه ؟ ‑كامننا ! ‘ ، بعد أن تحول
الفوارق الطبقية بينه وبين الفتاة التى يحبها لأنه مجرد أسطى سيارات . إنما
هو بالعكس تماما ’ ابن عز ‘ ، يمثل له دخول الجيش أو معايشة
المسخ المدعو ’ اللينبى ‘ الكابوس الذى يراود الطبقة الوسطى كل
ليلة ، ناهيك عن طبقة ’ الأيدى الناعمة ‘ ! ( من ذى
الدلالة أن لجأ هنيدى لمحاولة مجاراة زملائه ومغازلة الميول التحررية ، ذلك
من خلال عنوان فيلمه الأخير ’ دماغه العالية ‘ لكن مع الإبقاء على
الفيلم نفسه متزمتا جدا . إلا أنه فى السينما ، وهى فن قائم بالكامل
على خلق‑ثم‑إشباع التوقعات ، لا تنطلى مثل هذه الحيلة على
أحد ، بل وتأتى تحديدا بنيران عكسية . أضحى ’ بلية … ‘
أفشل أفلامه ، ولا نقصد أن السبب أفضلية هذا المحتوى أو ذاك ، بل هو
مسألة تقانية technical محضة تخص توقعات الجمهور من الوسيط
ومفرداته ، وأن يفقد هنيدى جمهوره أسهل ألف مرة من أن يجتذب جمهور نادية
الجندى بمجرد عنوان مضلل ! ) . أيضا لاحظ أن الصورة معقدة من الأصل ولطالما كانت
محسوبة لصالح الفكر التقدمى : أولا ، قالب ’ إللى يبص
لفوق ‘ ليس رجعيا فى حد ذاته ، فهو قالب الريحانى وعادل إمام والجميع
تقريبا ( قبل أن يخترع علاء ولى الدين من الصفر تقريبا القالب
العكسى ) ، ولم يحدث قط أن حملوه نفس أفكار محمد هنيدى الذى يحرص على
أداء الصلاة قبل تصوير أى لقطة . إن عادل إمام ( ومن ورائه وحيد حامد
ولينين الرملى ) مدرسة تقدمية كبيرة قائمة بذاتها وكانت الأنجح لعقدين بما
لا ينافس ( وبالمناسبة الكلمات جميعا كالتقدمية والرجعية حسب المعجم
العام ، وليس ميراثا للاستعمال المقلوب للكلمتين الدارج من عصر لوى الكلمات
الناصرى‑الهيكلى ، حيث بالمثل كانت النكسة والثغرة كلمات بديلة عن
الهزيمة المنكرة ، والاستعمار والامپريالية تشير لأشياء سيئة على عكس
المعجم العادى كما كان يستخدمه الجبرتى مثلا … وهكذا . مثلا فى المعجم
كلمة تقدم تعنى getting better ، وهى تأكيدا أقرب لفحوى مسعى العصر
الليبرالى ’ الرجعى ‘ السابق على 1952 أو لبقية النظم الملكية العربية
الباقية بعدها ، منه إلى سلاسل الحروب والتأميمات الحمقاء
’ التقدمية ‘ التالية لتلك السنة فى مصر أو فيمن سار على نحوها ! ) .
ثانيا : قبلات نادية الجندى ورقص فيفى عبده هما بكل المعايير أشجع فعل وقع
على أرض مصر وتحدى القوى السلفية طوال عقد كامل هو عقد التسعينيات ، كما
وتمثلان بشخصيتيهما القويتين امتدادا لسعاد حسنى وليس حتى لفاتن حمامة ،
ومع تقدميتهما هذه وتلك كانتا تلقيان اقبال الجمهور كصف ثان بعد عادل إمام
مباشرة ( لم يعد ذا معنى الكلام عن المرأة كسلعة ، بينما شارون ستون
تفتك بالرجال على الشاشة وفى مقاعد المشاهدين ووراء مكاتب رؤساء هولليوود .
أما بالنسبة للشجاعة فالتالى لتلكما السيدتين مباشرة ، نصر حامد أبو زيد ،
شخص لا يكاد يعرف الجمهور العريض عنه شيئا ! ) . ثالثا :
انكسار السينما التى كانت متحررة بكل اتساع الكلمة ، لم يبدأ بـ
’ إسماعيلية … ‘ أو ’ بلية … ‘ ، إنما توجد
له نقطة تحول تاريخية حاسمة ومعروفة فى مسيرة السينما المصرية أقدم من هذا
بكثير ، هى واقعة البطش برقباء فيلم ’ المذنبون ‘ .
رابعا : ما حدث فى السنوات الأخيرة فى الساحة السينمائية ليس انقلابا بمعنى
الكلمة ، لأن إمام والجندى وعبده أكثر نجاحا حاليا من أى وقت مضى .
هل يعقل أن الشعب المصرى انقلب الآن تقدميا متسامحا
منفتحا محبا للطبقات والأمم الأعلى ، مستعدا للسخرية من نفسه
لحسابها ؟ بالتأكيد غير صحيح ، والتشبث بالتدين والكلام المجانى عن
الفساد ، و’ الغزو الثقافى ‘ و’ طمس الهوية ‘
و’ الاستهداف ‘ من أميركا وإسرائيل أو حتى من العرب ، والاستمراء
المتواصل للهزيمة والشكوى والانقهار لدى كافة الطبقات ، كلها تعنى استشراء
الپارانويا لحدود تكاد تكون مزمنة وبلا علاج . والتعبير الذى تردده أغلب
الرموز العربية المثقفة منذ سنوات ، فقط إعجابا ببلاغته وليس لجعله منهاجا
للتغيير وإلغاء الهوية ( أو قل اكتساب هوية أفضل ، هوية عملية علمية
علمانية عالمية ) ، هو أن هذه حالة شعب خرج طوعا من التاريخ ،
ويعلم أن الخطوة المنطقية التالية ، وهى أن يأتى من يطرده من
الجغرافيا ، هى مسألة وقت وليس إلا ! هل هناك جمهوران ؟ واحد أكثر تعليما وثقافة من
الآخر ومن يذهب لمشاهدة هذا النجم لا يذهب لذاك ؟ أيضا لا توجد شواهد على
هذا ، ولو صح مع أفلام هنيدى الأولى لا يصح الآن حيث الكل يشاهد كل
الأفلام . هل الجمهور مصاب بفصام فكرى ؟ هذا مرجح ، لكن الأرجح
منه أنه لا يهتم كثيرا إن لم يكن لا يفهم أصلا مضامين الأفلام . الواقع
يقول أن لا دخل للمحتوى فى نجاح هذه الأفلام ( إن لم يكن معظم أفلام تاريخ
السينما فى كل العالم فيما عدا فترة أواخر الستينيات ربما ) . هذه
الورقة التى تروج بكل النضالية الممكنة لأهمية دراسة الثقافة الجماهيرية لا
تنطلق بالضرورة من أى احترام للجمهور ، باستثناء تقدير ضخامته واتساعه
زمانا ومكانا ، بملايين الأفراد وعشرات الآلاف من المعتقدات وآلاف السنين
من التاريخ ، أى عامة مقومات الكم لا الكيف فيه . ولا تتملكها سلفا
أية أوهام عن تقدمية محتوى ذلك التاريخ أو التراث أو الحاضر ، أو كونه ‑أى
الجمهور‑ قوة عظيمة أو فاعلة مستقبلا ، أو حتى فى إمكانة تنويره إلا
فى حدود ضيقة وبطيئة للغاية . فقط واجبنا الكبير أن نمتعه كما يريد هو
المتعة ، وواجبنا الصغير أن ننقل له بعض المعلومات والأفكار الجيدة
المفيدة . باستثناء الجملة الأخيرة التى تعبر
عن خاصية قاعدية للفنون ، فإن الكلام السابق عام فى مجمله ، وتتفاوت
درجة انطباقه على الشعوب المختلفة ، وعلى الطبقات المختلفة لذات
الشعب ، وعلى اللحظات التاريخية المختلفة له ، وستأتى بعض التدقيقات
والأمثلة عندما تحين مناسباتها .
توضيح آخر : فيما سبق وفيما سيأتى نرجو أن يكون التمييز واضحا
بين الفن كتعريف أى من حيث كونه إمتاعا إنفعاليا و / أو وجدانيا ،
وبين تحليل المحتوى الذى ستدور حوله بعض أجزاء هذه الورقة . فالمحتوى قد
يكون جيدا وقد يكون رديئا ، لكن قد يكون فى كلا الحالتين ممتعا . أو
العكس حيث قد نجد محتويا جيدا فى أفلام غير ممتعة ولا يصلح اعتبارها أفلاما ولا
فنا من الأصل . للتوضيح بأمثلة نقول إن أفلام يوسف شاهين لا تمتع ولا
تهم أحدا ومن ثم لا تعد أفلاما ولا فنا من الأصل بغض النظر عن محتواها الجيد
أحيانا والردئ غالبا . أم كلثوم رجعية بليدة أطالت ‑وبدعم كامل من آلة الإعلام الناصرية
المخيفة‑ عمر موسيقى متخلفة بدائية السلم والآلات وكل شىء هدفها
التنويم تمهيدا لممارسة السلطان للجنس وكانت بالفعل على وشك الانقراض ،
وأجهضت أو على الأقل حجمت محاولات التحديث الأولية للخروج من إطار الليالى
والعيون المخجل ، من أمثال سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وغيرهما ،
حاربت أم كلثوم التحديث بكل رجعيتها وعنفوانها وظل لها أثرها الطاغى إلى أن
قهرها بنجاح ساحق جيل الشباب فى أواخر القرن العشرين . وبدأت خطى التحديث
متسارعة رائعة ، عالمية الإيقاعات ، خالية من الآلات الضحلة ذات
الأصوات المثيرة للغثيان كالعود والقانون والرق ، وخالية من ربع النغمة
التى يجب فى رأينا أن تعلن جريمة ضد الإنسانية . مع ذلك كان لها ‑أى
أم كلثوم‑ جمهور بالملايين لا شك أنها أمتعته وأشبعته ومن ثم لا مراء فى
أنها كانت تقدم فنا ، حيث أن ذلك الإمتاع هو على أية حال الأهم والأساس فى
الفن . بعبارة أخرى : صحيح فن أم كلثوم فن هابط ، سواء كموسيقى
متخلفة أو كآراء تعتز بهويتنا وثقافتنا الماضويتين ومعادية للتحديث والانفتاح
على العالم المتقدم ، لكنه بالتأكيد فن . بمعنى أن لأم كلثوم الفضل
الأكبر لأنها أمتعت ، لكن ليس لها الفضل الأصغر وهو المحتوى التقدمى الجيد . المثال المقابل من ذات الحقبة هو أسمهان التى كان لها
الفضلان معا ، الفضل الأكبر للفن الممتع واسع الجماهيرية ( الفن
الهابط فى المصطلح الدارج ) ، والفضل الأصغر للمحتوى التحررى الحداثى
المتقدم ، والموسيقى العصرية التجديدية ذات المرجعية الغربية بل تحديدا أرقى
قطاعاتها الراقصة وحتى الكلاسية ، بما فى ذلك نقل كامل نمط الحياة الغربى
من خلال الأزجال lyrics التحررية الجريئة . ولا شك أنها كانت
ستمثل جزءا من ثورة ثقافية لو طال بها العمر ، ولو لم تجهض قوى البداءة
والديماجوچية السياسية تلك الثورة الليبرالية فى مهدها من خلال ما سمى ثورتى
1919 و1952 ، وما هما بثورات على الإطلاق ، إنما ردة للماضى . رابعا : ماذا إذن ؟ أستميحكم صبرا لأن
الأمور ليست بسهولة ما سبق !
السينما ثقافة جماهيرية = الفن للمتعة = الجمهور عاوز كده =
البحث عن الإشباع
ما معنى هذا ؟ لنبدأ بالتعريفات : التقسيم السوسيولوچى للفنون : فنون النخبة أو
الفن الفنى artistic art ، فنون الحضر أو الفن الجماهيرى popular art ، فنون الريف والأقليات وحرفيى المدن أو الفن الفلكلورى folk art . والفواصل بين الفنون الثلاثة غير قاطعة ،
وأيضا متغيرة عبر الزمن ، زائد الحراكية العالية والسريعة فى انتقال فن من
تصنيف لآخر أو حتى العودة له بعد قليل : - الچاز مثلا تحول من فلكلور لفن جماهيرى بينما فشل
البلوز رغم أصلهما الواحد . الآن هو أحد فنون النخبة . - بعض الفنون تولد جماهيرية وتتحول للنخبة إذا ما
خلدت وهى إحدى الصفات الأساس للفن الفنى ، مثال ذلك شيكسپير وپوتشينى
( بالتأكيد كان ينظر لشيكسپير فى حينه باعتباره فنا سوقيا هابطا ، إن
لم يكن بسبب الميلودراما والكوميديا الفاقعين فيه فعلى الأقل لأنه كان بلغة
العموم السوقية المسماة بالإنجليزية ، وليس باللاتينية لغة الثقافة
والمعرفة والعلوم . نفس الكلام يسرى على فن الأوپرا الذى كان يمزق دموع
وضحكات المشاهدين بلغتهم العامية جدا المألوفة ! ) . - أحيانا يحدث العكس مثل موسيقى العصر الرومانسى
التى لم يكن مقصودا فى الأصل أن تذيع بين العموم . - أيضا التحور أو التطفر قد يحول الفلكلور لفن
جماهيرى ، مثل الشيكاجو بلوز . - بالمثل تهجين الفنون الفلكلورية قد ينتج فنا
جماهيريا ، مثل الروك . - التقنية قد تحول الفن من فلكلورى لجماهيرى ،
مثل طباعة قصص الحب القديمة لشمالى المتوسط أو مغامرات الغرب الأميركى أو الـ Sagen الألمانية كالنيبلونجين ، أو مثل عمل مستنسخات مما يسمى بالفنون
المرئية visual arts كالرسم والنحت والعمارة ( آلاف الناس
يقتنون فوق مكاتبهم مصغرات من المونا ليزا وتمثال التحرر ، أو نماذج من برج
إيفيل ودار أوپرا سيدنى ، أو من الطرازات الغابرة للميرسيديس والبوينج
والسپوتنيك ) .
-
السينما لها الأفضال الكاسحة التى لا تبارى فى حقل أثر التقنية على رواج الفنون
هذا ، والأمثلة لا تنتهى نذكر منها إنتاج أساطير فرسان فنون القتال
الجوالين الصينيين والياپانيين أو القصص المرعبة وحواديت المسخوطات fairy tales
الخيالية من وسط وشمال أوروپا كأفلام سينمائية ، وما أدى له هذا من طفرة
هائلة لقصص ريفية محلية الذيوع فى الأصل كتلك . - هذا غير صحيح دائما فاهتمامات الطوائف cult لا تنتج أفلاما جماهيرية بالضرورة . - أحيانا تقوم الترجمة بنفس الدور فى تحويل
الفلكلور لفن جماهيرى مثلما حدث بأقدار متفاوتة مع الكتب الثلاث العربية
والفارسية التى عصفت على سبيل الحصر بالفكر الغربى الحديث . ألف ليلة وليلة
ورباعيات الخيام باتا فنا جماهيريا يعرفه الجميع ، ومثلهما وإن بدرجة أقل
كتاب النبى رغم ولع النخبة الغربية الجنونى به . الصورة فى الشرق تبدو أكثر
إثارة ، فأشعار الخيام بسبب الاستعقاد البالغ لمحتواها الوجودى الطليعى
ورغم بساطة بل بداءة قالبها الفنى ، انحصرت فى دائرة اهتمام النخبة ،
ويقال إنها اندثرت كلية لولا اكتشاف فيتزچيرالد لها . حينئذ ارتدت للشرق
مرة أخرى فى ترجمات لا حصر لها أثارت ولع النخبة العربية ، لكن ما لبثت أن
حولتها أم كلثوم بترجمة جديدة وبالغناء شيئا جماهيريا للغاية ، ثم أخيرا ها
هى أم كلثوم تنسحب تدريجيا لتصبح فنا طوائفيا لا يروق إلا لدائرة أتباع
مخلصة . - الفلكلور فن شفاهى متوارث غير معروف المؤلف
الأصلى فى الغالب ، لكن استلهامه ومحاكاته وتطويره بواسطة مؤلفين معروفين
لا يخرجه بالضرورة عن دائرة الفلكلور . مثلا لا ينظر لأغانى الريف الأميركى
الحديثة المنسوبة لأسماء معروفة والمطبوعة فى ألبومات كفن جماهيرى ، ذلك
أنها فشلت فى غزو ثقافة التيار الرئيس للمدن والإعلام الكتلى .
- الفن
الجماهيرى ربما عابر وربما غير عابر للمكان ، فالسينما الأميركية فن
جماهيرى فى أغلب بلاد العالم لكن ليس فى الهند أو مصر مثلا ، حيث تحظى
السينما المحلية بالأولوية ، وتعد الأفلام الأميركية فنا للنخبة . - طبقا للنظرية الوظيفية functionalism فكل مكون ثقافى يخدم
وظيفة اجتماعية ما ، هذه غالبا ما تكون مادية محضة فى الفلكلور كأن يؤدى
الفن مصاحبا لأداء الأشغال ، لكنها فى الفنون الجماهيرية عادة ما تحقق
بجانب الانفعال البدنى المحض إشباعا معنويا ووجدانيا . - رقى الفن الجماهيرى مرتبط بمدى نضج وتمكن الطبقة
الوسطى فى العصر المعطى . استثناء مما قلناه عن انكسار الأوهام وأن لا
افتراضات مسبقة أو أيديولوچية عن تقدمية الجمهور ، فإن الوضع الطبيعى أن
تكون الطبقة الوسطى بالذات ، قوة تقدم وتحديث قادرة وواعية . لكن لهذا
أيضا استثناءاته ، وعلى الأقل التآكل المادى غالبا ما يؤدى لتآكل
ثقافى . مثال كبير لهذا الردة التى شهدتها الطبقات الوسطى المصرية والعربية
عن الهوية الغربية العلمانية إلى الهوية العربية الإسلامية أو على الأقل تمزقها
بينهما ، والتى ترجمت بوضوح إلى تحولات ومتناقضات فى توجهات ومضامين
المسلسلات والأفلام المصرية الجماهيرية ، وميل بعض أنجحها إلى قيم معادية
للتحديث منحطة أو متخلفة .
[ إجابة أسئلة
طرحتها الندوة : إن لم تكن ردة فأقله أن كان
التمزق بنسبة 90 0/0 لصالح الأولى فأصبح 90 0/0
لصالح الثانية . وقارن بين عصر البراءة ونجماته المستقيمات المتصالحات
بالكامل مع ذواتهن وأجسادهن وجنسويتهن sexuality ، أولئك الحسيات فاتنات
الشكل والروح فى ’ أبى فوق الشجرة ‘ و’ امرأة ورجل ‘
و’ العاطفة والجسد ‘ و’ نساء الليل ‘ و’ حمام
الملاطيلى ‘ و’ بمبة كشر ‘ و’ المذنبون ‘ ، عصر
الأفلام الوحيدة من كل تاريخ السينما المصرية التى بقت ثلاثين عاما متصلة فى دور
العرض بلا انقطاع رغم أنف الجميع ولا تزال ، عصر المينى چوپ فى كل الأحياء
ومغازلة البنات تمارس بمرح على جميع النواصى ، عصر فشل فيه الريچيم المهزوم
ورموزه الثقافية الصماء فى الحيلولة بين الشباب المصرى والثقافة الغربية
المتحررة ؛ قارن بينه وبين رياء عصر النفاق الدينى والاستغلاق الاجتماعى
وغطرسة الجثث ، عصر الملابس التى تخفى الجسد وأشياء أخرى ، عصر الآذان
فى التليڤزيون والميكروفونات كأشياء لم يفكر أحد من قبل أن تستخدم يوما فى
غرض كهذا ، عصر الصلاة فى أماكن الشغل بل أداء الصلاة أصلا ، عصر
الجهر بصوم رمضان بعد أن كان شيئا مخجلا فى أيامنا … وهلم جرا .
لقد ورث القومجيون العرب المنجزات
العلمانية عن العصور التى انقلبوا عليها ، لكن مستواهم العلمى والثقافى
والطبقى لم يؤهلهم للإيمان بها إيمانا حقيقيا قط ، ففرطوا فيها عند أول
هزيمة بثمن بخس للغاية ، هو مجرد الإبقاء على كراسيهم المتهالكة .
الأدهى أحيانا أن كانوا مستعدين لفعل ذلك حتى قبل وقوع الهزيمة ، مثل هرولة
عبد الناصر للأزهر قبل تعرضه لأى طلقة سنة 1956 ( ! ) .
دارس الثقافة الجماهيرية يجد ارهاصات مبكرة ومفاتيحا رائعة فى اللحى البيضاء
وعلامات الصلاة السوداء التى نبتت فجأة فى وجوه غالبية نواب رئيس الجمهورية
وكبار مساعديه فى النصف الثانى من عام 1967 ، أو فى العبارات التى ظهرت
بفجائية أكبر فى العلم العراقى أثناء ’ أم المعارك ‘ ، أو فى أن
وسيلة الريچيم السورى ’ العلمانى ‘ الوحيدة فى محاربة إسرائيل هى منظمة
دينية لبنانية متطرفة . هذه دلالات رمزية ثرية ومثيرة ، وغالبا ما
تكون نقطة البداية التاريخية لما هو أسوأ ويعتور بعد قليل بالانحطاط ساحة
الثقافة العريضة للشعب . أليس من كبير المغزى أنه بعد ما جرى من تنكيل
بالسينما المتحررة فى النصف الثانى للسبعينيات ، أن قررت أفلام جمال
الليثى ، أكبر شركة للإنتاج السينمائى فى مصر آنذاك ، وربما فى نوع من
الاتساق غير المعهود مع الذات عندنا ، وقف كل عملياتها ، والتحول
لمجرد توزيع ذات الأفلام التى أحبها الناس على شرائط ڤيديو ، وكأنها
تعلن : ’ … وإلى هنا تنتهى نشرة أخبار السينما المصرية ،
وننتقل الآن إلى هذه الفقرة من أحد المتاحف ! ‘ . فى
المقابل ، لكن ليس آخرا ، قال مدير مهرجان سينمائى عربى انتقل مؤخرا
من لندن إلى إحدى العواصم الخليجية ، مبررا منعه للأفلام التونسية :
[ إن العرى شىء ممتع فى السينما ] ، لكننا [ لحسن
الحظ ] لسنا مجبرين أن تكون هذه العارية امرأة مسلمة . عزيزى
القارئ : هل معدتك متينة بما يكفى لسماع المزيد من قصص الازدواجية الرائعة
فى حياة أكثر أمة اتهمت غيرها بالكيل بمكيالين ، أم أنك تعرفها أكثر
منى ؟ ! ] .
المهم تعريف الفن الجماهيرى ’ الحالى ‘
يميل لما يلى : المنتجات الثقافية الموجهة لأهل المدن ، من أبناء
الطبقة الوسطى ، المتعلمين ، التى تعتمد لإعادة الإنتاج
( التوزيع ) على أحدث التقنيات الكتلية المتاحة ، وتتماشى مع الأفكار
والأهواء السائدة غير المختلف عليها كثيرا ، ومن نتيجة كل هذا أن تكون
واسعة الجماهيرية .
إذن المعيار فى الفن الجماهيرى : 1-
مكانى ، 2- طبقى ، 3- تعليمى ، 4- تقنى ، 5- قيمى ، 6-
انتشارى . وتنطبق كلمة الفن الجماهيرى على فن ما ، بقدر انطباق معظم
هذه الشروط عليه ، وإن كان الشرط الأخير ضرورة فى كل الأحوال بحكم
التسمية . والطباعة والراديو كانا أول وسائط للفن الجماهيرى بالمعنى
المعاصر للكلمة ، والذى يحوى بالضرورة كلمة تقنية اتصال كتلى ، والتى
أتاحت وصول القصص أو التمثيليات إلى أوسع قطاع من الجمهور ، بل وعابرة
للمدن وحتى الدول ، ومتخطية إطار التوزيع الضيق جدا لفنون العروض الحية
السابق . ملحوظات عن السينما كفن جماهيرى : - السينما كانت فنا جماهيريا بمعنى الكلمة فى
عصورها الذهبية ، والآن كثيرا ما تميل لفنون الخاصة . كانت تذاكر
السينما داخل أميركا سنة 1946 أربعة بلايين بمعدل دخول 30 مرة فى السنة من الرضيع
حتى الكهل ، أصبحت سنة 2000 خمس مرات فقط . فى مصر كان الرقم الأقصى
75 مليون تذكرة فى أواخر الخمسينيات بمعدل 3 مرات سنويا منها 1.2 للفيلم
الأجنبى ، أصبح مرة كل 3 سنوات منها مرة كل 20 سنة للفيلم الأجنبى !
ولاحظ أننا نتحدث عن سنة الأحلام 2000 ، ذات الستين مليونا للفيلم المصرى
والثلاثين مليونا من الجنيهات للفيلم الأجنبى ، فقبل عقد ونصف كان معدل
دخول المواطن المصرى للأفلام الأميركية مرة كل قرن . إذن فالسؤال مشروع
للغاية : هل لا تزال السينما حقا جزءا من الثقافة الجماهيرية ؟ ! - السينمات القومية فقدت أهليتها كفن جماهيرى بمولد
حركات ما يسمى بالسينما الجديدة فى أواخر الخمسينيات ( جودار ،
فيللينى ، شاهين … وشركاهم ) ، وقتلها الديماجوچى الأهوج
للسينما الجماهيرية القديمة بالغة النجاح لبلادهم .
[ إجابة أسئلة طرحتها
الندوة : هذه الحملة المتخايلة الصاخبة انتهت بأن
جعلت من صناعة الأفلام ( ناهيك عن التجريب الفنى ) ، مرتعا لكل
من هب ودب ، بعد أن كان هذا قصرا على من هم فى القامة الإبداعية
’ للمواطن كين ‘ ، ويحمل إجازة مباشرة من ستوديوهات هولليوود
نفسها . من ثم ، وفى صناعات السينما الأضعف نسبيا ، أفلحت العملة
الرديئة فى طرد العملة الجيدة فى نهاية المطاف . ولم تنج تقريبا إلا
هولليوود التى قيل ساعتها إنها ماتت إكلينيا ، لكن لم يعدها للحياة إلا
كونها مفهوما تكون فى وجدان العشيرة الإنسانية . فأصبحت هذه ملاكها الحارس
الوحيد من هجمة التشريعات الحكومية ، ومما سمى أميركيا بالسينما
المستقلة ، وكذا من غوغائية سينمائيى ونقاد ومهرجانات أوروپا عاليى
الصوت ، ومن انتشار التليڤزيون … إلخ . المدهش أكثر أن هذا العقد نفسه هو
الذى شهد تأسيس سينمات قومية جديدة من الصفر تقريبا ، بفضل عباقرة فهموا ما
تعنيه السينما ، وأخلصوا لأصولها بقدر ما أبدعوا وطوروا فيها . أبرزهم
بالطبع موجه فنون القتال كاسح الجماهيرية ، والملهم الأكبر فيما بعد لأنجح
الناجحين أمثال لوكاس وسپييلبيرج ، والتى أصبحت بلده بعد قليل وإلى اليوم
ثانى أقوى قدرة سينمائية على وجه الأرض ، إن لم يكن ملهما بدرجة أو بأخرى
فى عقد الخمسينيات عينه ، لتأسيس ثالث أقوى قدرة سينمائية حاليا وهى هونج
كونج ، والتى واصلت من بعده ، وبدرجة عالية من التخصص ، المسيرة
المظفرة لسينما فنون القتال التى كان قد أسسها كفن جماهيرى وأرسى كثيرا من
تقاليدها ، ، ، بالطبع : موجه الياپان الكبير أكيرا
كوروساوا . ومثل ‑وإن بمجال أقل اتساعا من حيث الجمهور
المستهدف ، لكن ليس أقل استحواذا وصنعة وإحكاما للحكى والبنى الدرامية‑
السويدى إنجمار برجمان . أحد أكبر الألغاز التى فشلت فى حلها فى
حياتى ، هو فهم كيف أعجب النقاد الأوروپيون ومن سار على نحوهم فى العالم
الثالث ، بهذين السينمائيين العظيمين فائقى الاحترافية ، الكلاسيين
لأبعد حدود التعريف ، بذات القدر الذى أعجبوا به بطوفان الأسماء المخربة
السائبة فنيا ، كتلك المذكورة أولا . فى مداخلة لى فى ندوة أخرى
للجمعية ، قوبل ربطى بين كوروساوا وأفلام فنون القتال بصيحات استنكار شبه
جماعية . أليس هذا فى حد ذاته دليلا على لأى مدى أفلح غسيل المخ الذى أجراه
هؤلاء ، حتى لعقول من يفترض أنهم أكثر الناس اطلاعا ، لدرجة أن أمكنهم
بسهولة شطب عقود كاملة من تاريخ موجه ستوديوى عملاق ، هى المفتاح لفهم كل
أشغاله المنتمية فى غالبها لضربى النشاط والحرب ، والمهمومة دوما
بالجماهيرية ، ذلك فقط كى يكرسوا نظرياتهم الخبيثة ؟ ! الخلاصة : لا شك أن
الخمسينيات دخلت التاريخ كالعقد الذى فتح أكبر بوابات الجحيم التى عرفتها
السينما : سينما الأوتير ! ] . - إذا كان التعريف الكلاسى يقول إن الفن هو اكتشاف التميز ‑ويقصد
به الجماليات‑ (
- التليڤزيون
هو حاليا الفن الجماهيرى بمعنى الكلمة ، ومن دلائل هذا أن أصبح يطلق عليه
الجميع تلقائيا وببساطة كلمة ’ الـ ‘ وسيط 'the' media ، كذلك هناك من ينظر لأننا نعيش ثقافة
الصورة تجاوزنا مرحلة الثقافة النصية ، وأننا بتنا فى مجتمعات ’ بعد‑نصية ‘
post-textual ،
- ألعاب
الڤيديو ‑باعتبارها الوسيط الأسرع نموا فى
الوقت الحالى‑ تتجه بسرعة لأن تصبح أكبر الفنون الجماهيرية جميعا ،
ومن المحتمل أن تتبلور سريعا كالحاضنة أو كالصيغة الرئيس للثقافة
الإنسانية ، متفوقة على الكتب والصحف والغناء والأفلام وحتى التليڤزيون ،
وباختصار كل شىء ( الآن هامش : ليس هذا موضوعنا لكننا لا بد وأن نلقى ‑بالمناسبة‑ بهذه
النبوءة أيضا : قد تصبح
ألعاب الڤيديو القاطرة التى ستربى جيلا جديدا لدى أعراق الحضارة ،
يحب العنف والقتل ويعيدها ‑أى الحضارة‑ للعسكرة القديمة التى كانت
حارسا لا بد منه لبنائها فى أطوارها الثلاثة ( الرومانية والبريطانية
والأميركية ) ، ذلك بدلا من دعاوى السلام والخنوع التى بثها اليسار
منذ الستينيات مخترقا وناخرا بها ثقافة أمم الحضارة ، تمهيدا منه لانقضاضته
هو العنيفة عليها فى الوقت المناسب .
هذا هو التمديد الطبيعى لمصطلح التسعينيات infotainment على استقامته ، وهو لا يشمل فقط الترفيه وتشكيل الوجدان ،
بل أن يضم التعليم نفسه ( هل يوجد فارق حقيقى بين اجتياز مجموعة ألعاب
مايكروسوفت Age of Empires ، وبين الحصول على دكتوراه فى علوم
الستراتيچية ؟ ) . مع ذلك لا زلنا فى مرحلة أشد بدائية
بكثير ، ولا يزال الجدل هائلا عندنا حول قصاصات الڤيديو videoclips ،
التى يبدو أن أحدا لم يستوعب وقعها بعد ، ولا يزال يتساءل هل الأغانى ترى
أم تسمع ! عامة يمكن برصد أولى لخصائص
الصيغة الرئيسة الجديدة للثقافة الإنسانية هذه ، ألعاب الڤيديو ،
ملاحظة عدة سمات ، منها أنها الأكثر تفاعلية بما لا يقارن مع كل ما سبقها
من وسائط ( بما يعيدنا ربما لكلام ماكلوان عن الوسيط البارد والوسيط
الساخن ، لكن على نحو ربما لم يخطر بباله قط ) . ومنها أنها
الأكثر خيالا ونأيا عن الواقع . أيضا لا يجب أن ننسى أن غالبية مبتكريها
الأوائل فى عصر إنفجارة الحاسوب الشخصى فى مطلع الثمانينيات ، لم يكونوا
أكثر من صبية فى طور الطفولة بعد ، وإن أصبحوا مليونيرات من حيث لم
يحتسبوا ! ومنها أن تكاد تصنف كلها تحت حقل الصيغ الفانتازية ، وفى
الأغلب منها السيريالية . فأنت تملك عدة حيوات وتتحرك بسرعة فائقة وتعيد
تموين سلاحك فى رمشة عين ، ومن تقتلهم يتبخرون من فوق الأرضية ، هلم
جرا . فى المقابل الأشرار خارقون للغاية ومدججون بقدرات ميكانية
هائلة ، ورغبة فى القتل لا مثيل لها ، ناهيك عن أشكالهم
المسوخية .
من هذه بالأخص بالتوالى التوصل
لتميز ألعاب الڤيديو على نحو خاص بالعنف البالغ . حتى إن البعض يقول
إن السادية هى اسم اللعبة ، وإن حتى السينما نفسها لا توفرها على هذا
المستوى أبدا . وهناك من يبرهنون على هذا بلعبة Doom أو شبيهاتها ، لأنها كانت بالذات اللعبة المفضلة
للطالبين اللذين قتلا زملائهما بالجملة فى مذبحة مدرسة كولومباين ، فى دنڤر
‑كولورادو ، فى أپريل 1999 [
[ تابع
التحديث الخاص بألعاب الڤيديو بالأسفل . أما
بمناسبة قصاصات الڤيديو ، فلن نفيض هنا فى أثرها الفنى الكاسح على فن
السينما نفسه ( اقرأ مثلا مراجعتنا اللاحقة لفيلم ملائكة تشارلى 2 ) . إلا
أنه يعادل على الأقل سبقها إليه فن الإعلان . اليوم كلها تجتمع معا فى شىء
جديد بدأ الحديث عنه فى صيف 2003
كشىء تحت الإعداد للموسم الجديد فى شبكات التليڤزيون الأميركى ، يدعى
minimovies . هذه عبارة عن مسلسل قصير من أربع أو خمس حلقات طول كل
منها نصف دقيقة أو أكثر قليلا ، تذاع على امتداد اليوم بهدف إبقاء المشاهد
دون تغيير المحطة . فقط حاول تخيل كيف يجب أن تكتب الدراما اليوم ، أو
كيف يجب أن يكون الإيقاع أو التكثيف ، أو حتى ماذا تبقى من فنون الحكى لم
يخترع بعد . أو لتسأل على الأقل ما هو قدر البراعة والإبداع فى كل هذا الذى
تراه الغالبية عندنا ’ أغانى شبابية ‘ بمعنى تافهة ومسفة . بينما
كلها ببساطة إخلاص بديع لأخص خصائص الفن الجماهيرى ، هذا الذى يتفرجون هم
قبل غيرهم عليه ، ذلك أنه ببساطة فن المتعة للمتعة ] .
-
الطريات الحاسوبية software نفسها كوسيط اتصال قائم بذاته ( أو كمجرد
حاضنة لجميع الوسائط السابقة multimedia ) ، يمكن
بالمثل تصنيفها ما بين فن نخبوى وما بين فن جماهيرى . والانقسام الكبير للحوسبة
الشخصية فى الثمانينيات ما بين معسكرى أپل ومايكروسوفت يعكس بوضوح وجود وتمايز
هاتين المدرستين . فبينما برمجيات الأبل ‑الرائدة الأولى للحوسبة
الشخصية‑ تبدو عليها ملامح الصقل اليدوى وتخلو من العيوب وباهظة الثمن
جدا ، كانت خطة مايكروسوفت خلق المواصفة القياسية بعيدة المجرى لحوسبة أبد
الدهر ، بأن جعلت البرامج رخيصة وغير محمية بالمرة من الاستنساخ غير
القانونى . وطبعا لولا هذا لما أصبح هناك أكثر من مائة مليون حاسوب شخصى فى
غصون سنوات قليلة من إعلان بيلل جيتس شعاره الشهير لتلك الفترة ’ حاسوب لكل
نضد مكتب ، حاسوب لكل بيت ‘ . أپل لا تزال تعتمد فى مبيعاتها على
حفنة صغيرة من الأتباع المخلصين لحد الإيمان ، أو ما يسمى طائفة cult ،
وشعارها هو Think Different ، وطبعا ليس لديها الوفرة المالية
لملاحقة ما تقوم به مايكروسوفت من تنمية هائلة لبرامجها واسعة الأسواق ،
وبالتالى مآلها الانقراض أو مجرد الانخراط بتواضع فى التيار الرئيس ! - الإنترنيت منذ نشأتها فى أواخر الستينيات كان
يقصد بها أن تكون وسيطا للاتصال . أما أن تبدو كمصدر أو كبنك ضخم
للمعلومات ، فلا يعدو هذا أكثر من أحد الآثار الجانبية الثانوية لهذه
التقنية . ولم يكن هذا الأمر قد خطر جديا ببال الكثيرين قبل 20 أكتوبر 1999
عندما وضعت الموسوعة البريطانية بالمجان عليها ( وإن كانت مجانية المعلومات
المهمة مسألة مشكوك فى استمراريتها على أية حال ) . لا شك أن
الإنترنيت سوف تتدعم ‑وإن ببطء نسبيا‑ كوسيط اتصال هائل ’ عريض
العصابة ‘ broadband ، رخيص وجلوبى المجال . كما أنه
بدأت بالفعل تتبلور طبيعة المحتويات contents التى ستنتجها ، مثل
أفلام الإنترنيت والأفلام التفاعلية وغيرها . ولا يعتقد أنها ستتعرض
لمنافسة جسيمة على لقب الفن الجماهيرى رقم 1 من أى وسيط آخر ، باستثناء
ألعاب الڤيديو .
- فى
نفس السياق لاحظ أن تنوع القنوات الزائد الذى نراه فى السنوات الأخيرة ، هو
إرهاصة بتحول التليڤزيون من فن جماهيرى إما إلى فلكلور شديد المحلية أو
لفن للخاصة عاليى التذوق والتخصص . - بالمثل السينما قد تكون فلكلورا إذا ما أنتجت
للطبقات المنتجة‑المستهلكة للفلكلور ، بل من الجائز فى رأيى أن نتمثل
ناصر حسين أو حتى بعض أفلام محمد هنيدى ، كأشغال أقرب للفلكلور منها للفن
الجماهيرى . وأفلام ما يسمى بالمقاولات فى الثمانينيات كانت إحياء للسينما
كفلكلور بعد موتها كفن جماهيرى . لى مع هذه الأفلام تجربة شخصية مسهبة طوال ذلك
العقد ، بالذات من خلال سينما أوديون فى حى معروف الحرفى بوسط
القاهرة ، وقد ألحت على طويلا بتأليف كتاب عن ناصر حسين كظاهرة متفردة
أعتقد أن سوف تعتز بها يوما السينما المصرية ، على الأقل حين كانت أفلام
بتكلفة عشرة آلاف جنيه تغزو جميع البلاد العربية ، بينما يعز التصدير اليوم
فى عصر أفلام الملايين ، وبالكامل تقريبا . ما كنت أراه هو الاندماج
والتهليل الذى يكاد يصل لحد الجنون لكل الفيلم من بدايته لنهايته ولرقصات البطن
على نحو خاص ، والمدهش أكثر أن هذا كان يحدث رغم أن ما يعرض من الفيلم لا
يزيد عادة عن نصف ساعة ، إذ كان يوضع على نحو رمزى فى برنامج العرض الأول
للفيلم الأجنبى لأسباب ضرائبية محضة ! مع هذا فهى أفلام متواضعة إنتاجيا
شبه بدائية وإيراداتها ككل تافهة للغاية ، وهو أمر يجهض كلية ما ظل أغلب
النقاد يروج له لعقود طويلة من أن نجاح الأفلام المصرية يتناسب مع عدد الرقصات
فيها ، ذلك أن هذه النظرية كانت كفيلة بجعل ناصر حسين ‑صاحب مرحلة
’ الانتشار ‘ لهياتم وفيفى عبده والعشرات غيرهن‑ أنجح موجه فى
تاريخ السينما المصرية ! الحقيقة أنها ببساطة أفلام لجمهور يمثل له عادل
إمام المعروض على بعد أمتار سينما مستعقدة sophisticated للغاية ، يستحيل
عليه فهمها أو محاولة هضمها !
هذه المحاضرة بكلمة : السينما فى مصر عادت
لتصبح فنا جماهيريا بعد نجاح ما يسمى بأفلام الكوميديا الجديدة ، ومن الآن
فصاعدا ما يحدث هو فقط أن انطبقت عليها كل آليات الفن الجماهيرى ، أى ما
يلى : 1- واسع الجماهيرية : بمعنى أن ينتج بطريقة الخط التيارى streamline production الكتلية الصناعية
الاقتصادية عالية الكفاءة ، والتى تتطلب بالضرورة استثمارات سخية وطويلة
المجرى ، ومن ثم يوزع بعد ذلك على نطاق واسع فى دور كثيرة ومريحة ،
كما تقوم على خدمة هذه الصناعات بيزنسات أخرى متعددة . 2- الإبهار المرئى ( بمعنى
البهرجة ، أو ’ اللعلعة ‘ ، أو زواق الصفيح الذى اكتسبت منه
هولليوود اسمها Tinseltown ) :
هذه كلها مقومات أساسية ، والسينما
الجماهيرية ، مثلها مثل الڤودڤيل والسيرك والسحرة والكوميديا
الموسيقية منذ جذورها الإليزابيثية ، فن ألعاب نارية أكروباتى سطحى يقوم
على الزغللة ولا يسمح كثيرا بالعمق . إنها إجمالا تنتمى لچيم كارى أكثر من
انتمائها لإنجمار برجمان ، وللعالم المرئى لمجلة ’ ماد ‘ منها
لأدب ديستويڤسكى .
3- الانفعال العالى ( بمعنى الاستحواذ العضلى أكثر منه
الوجدانى ، والوجدانى أكثر منه الذهنى ، ولعل هذه هى بيت القصيد دون
كل ما عداها لأنه منها تحديدا نشتق تعريفنا للفن الهابط : الفن الهابط
هو الفن الذى ينطوى على أكبر قدر من تحريك المشاعر والانفعالات ! ) :
إنها تنتمى ليوسف وهبى أكثر مما تنتمى لتشيكوڤ ،
وتقترب من عنف طقوس الزار أكثر مما تميل لصفاء لوحات رينوار . مكونات
الفارص أقوى من مكونات الكوميديا الذكية ، والميلودراما ضرورة تتسيد الموقف
طوال الوقت ، والتهليل للبطل مشروعية حتمية . فقط لاحظ أن هذا لا يعنى
الهزل ، ولا علاقة له بالمحتوى الذى من الممكن أن يكون تقدميا جدا أو رجعيا
جدا أو لا وجود له بالمرة ! ولو تحولت مغنية الريف الأميركى أو فنان
الربابة بصعيد مصر ، من فطرة وخجل وحزن وتأملية أدائهما المنفرد ، إلى
بهاء شونايا توين وتريشا ييروود أو صخب محمد طه ومتقال قناوى وما يحيط بهم جميعا
من تواجد كثيف للآلات ، يصبحون استعراضا show ، مرشحا للانخراط بعد
قليل تحت لافتة الفن الجماهيرى منه عن البقاء فى دائرة الأضواء الخافتة
للفلكلور .
4- الافراط فى الصنعة ( بمعنى الاستعقاد
التقنى ) : بصريا الخيال وقطعاته أكثر من
الواقع ورتابته ، والأصوات الاصطناعية تصم الآذان ، والمؤثرات تنافس
التمثيل ( المؤثرات هى بالفعل ما سوف يتجه له منتجو وموجهو الكوميديا فى
مصر فى السنوات القليلة القادمة ) . مرة أخرى الوسيط هو
الرسالة ، والخيال والقطع والصوت والمؤثرات هى أخص خصائص الوسيط
السينمائى ، وهى تحديدا ما لا يقوى على منافستها فيه أى وسيط . إنها
ببساطة نوع من ’ الحتمية التقنية ‘ إن جاز التعبير ، أو لا أكثر
أو أقل نوع من ’ الإخلاص للوسيط ‘ ، إن جاز هذا التعبير
أيضا . ( لعلك عرفت الآن السر فى تكاثر مشاهد تكسير الزجاج بدرجة
ملفتة فى الأفلام منذ اختراع الصوت الرقمى ؟ ! ) . ألا ترى معى أنه الآن فى عصر الإنترنيت المنجزة
الغائية لحلم القرية الجلوبية ، أن مثقفى الغرب محقون فى إعادة اكتشافهم المتوهجة
للمتفجرات الفكرية لمارشال ماكلوان تلك التى احتقروها ذات يوم ؟ ! أنا
أرى الأمر من زاوية أخرى ، ذلك أن هذا هو بالأحرى عصر چيرى بروكهايمر الذى
لم يمتلك يوما فى حياته حاسوبا ، لكنه من عادت تنسب الأفلام من خلاله رسميا
لمنتجها وليس لموجهيها ربما لأول مرة منذ السينما الصامتة . كلا هذين
الأمرين ينطوى على دلالة رائعة قائمة بذاتها تعصف بالدماغ ، لكن النقطة أن
كل ما فعله هذا المنغمس كلية فى السينما ، صاحب ’ الصخرة ‘
و’ أرماجيدون ‘ و’ پيرل هاربور ‘ ، هو أن فهم أبعد ممن
سواه لأى مدى يمكن إطلاق الوسيط السينمائى من عقاله ، متجاوزا فى هذا لوكاس
وسپييلبيرج وكاميرون أنفسهم ، وربما بعدة مراحل أقلها تفجير كل ركن فى
الشاشة بالحركة طيلة كل لحظة فى الفيلم . أبرز من ينفذ له هذا ، مايكل
باى القادم من قناة الـ MTV وعالم قصاصات الڤيديو videoclips ،
موجه مثله الأعلى الدينامية الفائقة لفيلم ’ قصة الجانب
الغربى ‘ ، ويمتلك نظرية متكاملة تقول إن تصوير الموسيقى هو الذى يفتح
عينيك إلى أى مدى يمكنك أن ’ تدفع وسيط السينما ‘ و’ إلى أين سوف
تأخذه ‘ و’ كيف تستخدمه بكامله ‘ و’ تتحرر من قيود الواقعية
[ فى حركات وزوايا الكاميرا وما إليها ] ‘ ، وغائيا يحقق
’ الهروبية الكاملة للمشاهد ‘ . هذه العبارات مات مارشال ماكلوان
دون أن يحلم حتى بسماعها من أى من معاصريه . والأبعد أن اكتشف مايكل باى
بمرور الوقت ضربا سينمائيا آخرا يحقق له كل هذا ، هو أفلام النشاط
( والبقية تأتى ، إن آجلا أو عاجلا فى راينا ! ) . أنا أرى
فى ذلكما الرجلين ‑بروكهايمر وباى‑ آفاقا بل وتعريفا جديدة لمفهوم
الوسيط هو الرسالة ، لا يخص فقط حقل السينما بل المبدأ فى العموم . 5- إخفاء الصنعة ( بمعنى
الاندماج المطلق للمشاهد ) : إنها سينما
استحواذية overwhelming ، تنتمى لعز الدين ذو الفقار ،
وتطلق النار فوريا بدون تحذير وفى مقتل على برتولت بريخت وبمجرد أن يلوح فى مرمى
التصوير ، بمعنى التعويل بالكامل على أن السينما كذبة وأن الجمهور يرفض أن
يشترى إلا الخداع ! إنه فئران التجارب التى قال عنها هيتشكوك إنها تتلذذ
بالصعقات الكهربية ( ونحن بالمناسبة نريد دائما دراسة الثقافة الجماهيرية
بهذه الروح اليمينية الأرستقراطية . عفوا ، أقصد الروح العلمية
المجردة ، التى تنأى بنفسها عن التبنى الأيديولوچى أو الانغماس العاطفى مع
المادة موضوع الدراسة ) . هو الجمهور الذى تقاطر أفواجا لمشاهدة
’ المدمر 2 ‘ ، وبعده بشهور قليلة كاد أن يفلس ستوديوهات
كولومبيا ، حين أشاح كلية عن نجمه الأول وشبه الأوحد عندما أصبح ’ آخر
أبطال النشاط ‘ ، فقط لأنه أراد أن يحدثه عن سحر السينما لا أن يمارسه
عليه ! بمعنى آخر ، هل كانت أعظم منتجة مصرية ستفلس لو امتد العمر
بصاحب ’ رد قلبى ‘ ليصنع لها فيلمها التالى ’ الناصر صلاح
الدين ‘ ؟ بالتأكيد لا ! مفاجأة ! ، أليس
كذلك ؟ ! ، أن تكتشف أن هذه الورقة التى تعزى للحقبة الناصرية
مسئولية التدهور المتواصل للثقافة المصرية فى النصف الثانى للقرن العشرين ‑مثلما
يفعل ذلك دائما ببساطته المثيرة ليبرالى مصر الأول نجيب محفوظ ، أو فقط على
غرار جزع د . زكى نجيب محمود المبكر جدا مما رأى أن سيؤول إليه مستوى
التعليم ، وكلها طبعا بدون الخوض فى كوارث الناصرية المعروفة فى المجالات
الأخرى‑ هى ورقة لطالما جنح صاحبها لاعتبار فيلم ناصرى حتى النخاع هو
’ رد قلبى ‘ ، كأعظم فيلم مصرى ، وكأنضجها فهما لما تدور
حوله السينما ! آمل أن ينير لك هذا أكثر ، المنطق الذى تسير عليه
الورقة ، والذى لخصته المعادلة سداسية الحدود أعلاه ، والتى ليس من
بينها المحتوى . 6- قوالبى مقيد الإبداع : أنصار الفلكلور الأصلاد يرون فى تسجيله ( أى محاولة تحويله لفن
جماهيرى ) إطلاقا لرصاصة الموت عليه وتحنيطه ، لأنه يقتل أخص خصائص
الأغنية أو الدراما الفلكلورية وهى الارتجال المتواصل عبر الزمن بل وعبر الحدود
الأممية . التعليب القوالبى أحد أخص خصائص خطوط الإنتاج ، والفن
الجماهيرى لا يعدو إلا واحدا منها . كتاب ’ ضروب الفيلم الأميركى ‘ ينظّر لأن
ما نراه كمثقفين كأعظم الأفلام إبداعا ( ويسترنات چون فورد ، ذهب مع
الريح ، الصقر المالطى ، كازابلانكا ، غناء تحت المطر ،
بونى وكلايد ، الأب الروحى … إلخ ) ، ما هى إلا تنويعة على
القالب ، كل ما فعلته أن فهمته أكثر مما يفهم هو نفسه . هنيدى الطفولى لامع العينين صغير الحجم مع ذلك
المتوقع طوال الوقت أن يسخر فجأة من أى أحد ، ولى الدين ضخم البنية صارم
الملامح لكن دائما البائس فى مأزق ما ، هانى رمزى ساذج وجبان معا ويوحى
دوما بأن أحدهم سينقض عليه ليمسكه من قفاه فى أية لحظة ، أحمد السقا بوهيمى
يسير على الخيط الرفيع بين البلطجة ونبل التمرد أو بألفاظ أخرى الـ
’ رِوِش ‘ أو الـ cool أو الـ ’ تقيل ‘ الذى دائما ما
يأتيك من الأفعال الكثير مما يتمناه عقلك أو عقلِك الباطن المكبوت . فى كل
جملة مما سبق توجد دائما كلمة ’ دائما ‘ ، ذلك أن هذه الشخصيات
ما هى إلا قوالب حكى narrative patterns رسمت ونميت ثم عززت
ببراعة واقتدار هائلين ، بحيث بات تغييرها خطرا جدا أو على الأقل يحتاج
لإبداع أكبر ! مرة أخرى المهم البراعة الفنية أو : التقانة أولا
التقانة أخيرا . مشكلة بروكهايمر وموجهه مايكل باى مع النقاد ، هى
حرصهما شبه المبدئى ، على الكليشيهات السينمائية فى صورها الأصلية الخالصة
القديمة ، حتى لو بدا فى نظر الكل أن محاولة إثرائها أو تعميقها أو على
الأقل إخفائها ستكون أفضل للجميع ! أنا شخصيا أميل فى أشياء معينة لهذا
الرأى ، لكنى أردت القول إن طاغوت قوانين الثقافة الجماهيرية يجُب كل
الآراء . إن الشباب فى عصر الأكشاك arcades أضحى يستهين بكافة أشكال الترفيه التقليدية ، ولم يعد يقبل من
الفنون بأقل من أن تعيشه بكافة حواسه الخمس فى واقع فضيل virtual
reality بالكامل ،
لا يمت بصله لما سبق وعهده كوكب الأرض من أشكال مألوفة للحياة . هذا هو القالب السينمائى الجديد
الذى يتبلور بسرعة ، وباتت تتحرك فيه كل الفنون . ودعنا نضم اسم
سايمون ويست ، الذى تعاون يوما مع بروكهايمر فى أنجح أفلامه بدون مايكل باى
’ كون إير ‘ ، وها هو يفتح اليوم آفاقا مثيرة لهذا القالب اليافع
من خلال ’ لارا كروفت ‘ ، مشيرا بجلاء للجذور الطبيعية لهذه
السينما فى دنيا القصص المصورة للثلاثينيات ، ثم فى روح ألعاب الڤيديو
منذ انفجارة الأكشاك فى السبعينيات ، فالحواسيب الشخصية والكنصولات consoles
بدءا من الثمانينيات . هذه الروح التى تحطم الواقعية وتنحو للتجريد تارة
وللسيريالية تارة ، وللكاريكاتورية دائما ليس فى الصورة بل فى الشخصيات
والدراما نفسها ، هى الشىء المهم والأصيل حقا فى ’ لارا
كروفت ‘ ، والذى لم تمسك به الأفلام السابقة المأخوذة عن لعبات
حاسوبية مثل ’ الأخوة ماريو ‘ و’ الاشتباك المميت ‘ ،
أو حتى تلك التى أخذت عن الشرائط strips أو ما يسمى
الكوميكس ، والتى سعت فى الاتجاه العكسى بمائة وثمانين درجة ، إلى
إضفاء الواقعية عليها ( مثال تلك الأخيرة أفلام سوپرمان الكبيرة .
وحتى أفلام ممتازة مثل أفلام باتمان لتيم بيرتون ، لم تحاول الإمساك بالخبل
الخاص لقصص الكوميكس ، وفى النهاية يلوح لك كل منها كمجرد فيلم سيريالى
سوداوى جيد ، أكثر منه فيلم كوميكس ماجن الخيال ) . حتى الآن لم
أعثر ‑وربما غيرى‑ على تسمية لهذا القالب الجديد ، لكن لمجرد
التقريب يمكن وصفه بنوع من التجريد السيريالى المرح . ومن يدرى ، ربما
يؤرخ يوما لويست أو بروكهايمر بپيكاسو السينما ! 7- يصعب تقنينه رغم ذلك : وكلمة تقنين لها أصل تاريخى طريف لا يخلو من مدلول . فعندما
انفجرت جماهيرية الفرق المسرحية الجوالة ، والكوميديات الموسيقية ،
والمنوعات revue, varieties, vaudeville ، والنمر الكوميدية
الاستهزائية أو التحقيرية follies, burlesque, slapstick,
humor, stand-up comedy ، بل وحتى عرض المسرحيات فى ’ مسارح ‘
السينما ، أصبح يطلق على المسرح التقليدى كلمة المسرح الشرعى بل وأصبح يسمى
حاليا legit وليس إلا ! لاحظ أن كتاب ’ ضروب الفيلم الأميركى ‘
يتحدث عن أفلام جامحة الإبداع ، ويدفع بأنه لولا إبداعها لما نجحت كل هذا
النجاح . مرة أخرى التقانة أولا التقانة أخيرا .
إن الفنون فى طريقها للتحرر النهائى والمطلق من
كافة شروط الواقعية ، هذه التى كانت تراعى على نطاق واسع حتى فى الأفلام
الخيالية ، هذا كى تضفى عليها المصداقية . هذه المصداقية ‑وهى
شىء إنسانى وأرضى وليس إلا‑ لم تعد شيئا مطلوبا أو مرغوبا فيه فى سينما ما
بعد چورچ لوكاس ، سينما الواقع الفضيل . فالعنف مثلا قد يصبح أقوى
أثرا بالسيريالية والتجريد منه بالإغراق فى الواقعية ! والحيلة أحيانا ما
تكون بالغة البساطة ، وهى أن يستطيل الشىء ، فتفقد تركيزك
تدريجيا ، وتدخل فى تجربة سيريالية ( سواء كنت فى مقعد للسينما أو
واقعا تحت التعذيب فى أحد سجون العالم الثالث ! ) . ومن ثم قد
تكون الطريقة المثلى لتلقى ’ العصر الذهبى ‘ و’ 2001 —أوديسا
الفضاء ‘ ، أو ’ كاجيموشا ‘ وتلميذه ’ إنقاذ الجندى
رايان ‘ ، أو أخيرا ’ پيرل هاربور ‘ و’ لارا
كروفت ‘ ، أو حتى ’ تايتانيك ‘ و’ ذهب مع
الريح ‘ ، بل والأرجح كل الأفلام مستقبلا ، هو المشاهدة تحت
تأثير الماريوانا ( مباحة حاليا فى
معظم البلاد ، ولا يجب بالضرورة أن تخرق القانون من أجلها كما فعل جمهور
’ 2001 ‘ ! ) . فى كل الأحوال لاحظ أن الفنون المرئية ‑وهى
الأصل‑ بدأت واقعية وطبيعية وانتهت سيريالية تجريدية أو
كاريكاتورية . ولاحظ أيضا أن سر ثقتنا فى الضرب السينمائى الجديد ،
يرجع لكونه يستجلب مئات الملايين بسهولة ، وليس حماسا منا للفن والتجريب
رغم تمتعه بهما تأكيدا !
إذن المطلوب فقط ‑وكما كان الحال دائما‑
هو الانسلاب alienation لأقصى مدى يمكن أن تشتريه النقود .
الجديد فقط أن أصبحت لدينا وسائل أفضل . لكن بعيدا عن القالب الفضيل
الجديد ، نعود لسر إعجاب بروكهايمر ورفاقه بالكليشيهات البالية ،
لنقول إنه ليس فى كونهم أناسا عتيقى الطراز ، إنما ببساطة مذهلة فى :
عدم مصداقيتها ! … ربما
لو امتد العمر بمارشال ماكلوان حتى اليوم لما صدق ما تراه عيناه ! الرجل حين قال الوسيط هو
الرسالة ، لم يكن سوى يصيغ حالة خاصة من قانون أكثر عمومية هو أن التقنية
هى التى تصنع التاريخ . تفرد السينما ، هو تفرد تقنيتها ، خامة
السيلليلويد وماكينة السينماتوجراف ، عن تقنية أى وسيط آخر . هذا يكمن
فى التوضيب editig الذى ينقلك فى جزء من 24 جزء من أقصى الكون إلى أقصاه ، وفى
مؤثراتها effects
التى تخلق من دنيا الخيال ما لا يوجد فى الكون أصلا . حول هذا
دارت السينما ، وستظل تدور !
8- يروق للشباب : وهنا تطول
التحليلات فى مدى عمق علاقة الشباب بهذه الثقافة وهى علاقة جدلية غير
بسيطة ، لأن الفن الجماهيرى يصعب أن يكون جماهيريا وصادما معا . لكن
فى نفس الوقت الثقافة الجماهيرية المتماشية مع فكر وأهواء المجتمع ككل ،
يجب أن تتماشى أيضا مع ذوق الشباب بحكم قوته الشرائية الهائلة لمواد
الترفيه ، لذا فإنها فى نفس الوقت قاطرة لبذور التمرد والتغيير أى بالأدق
خلق ثقافة سائدة جديدة ( ؟ ! ) . عندنا الرقص الشرقى
والغربى معا رغم تباينهما يعدان فنونا جماهيرية ، على الأقل من خلال حفلات
الزفاف والميلاد ، إن لم يكن ممارستها يوميا فى الأماكن الرسمية لفن الرقص
الجماهيرى أى قاعات الرقص الجماعى بالمدن ، والسبب ببساطة أن البنات تحب
الاثنين !
9- دينامى dynamic :
بمعنى يخضع بشدة للمزاج الجماهيرى وهو سريع التقلب
حاليا كل عدة سنوات قليلة . هنا تكمن إحدى السمات الخاصة ، الظهور
الفجائى من سماء صافية أحيانا كثيرة ، وفى أغلب تلك الحالات لا يمكن تفسير
ما حدث إلا بالصدفة ، أو لا يمكن تفسيره إطلاقا .
فيلم ’ 2001 —أوديسا الفضاء ‘ 1968 قصد
أن يكون فيلما للخاصة ، فإذا بالشباب يكتشف بعد أسابيع من عرضه غير الناجح
أنه مثالى جدا للمشاهدة تحت تأثير الماريوانا ، فأصبح إحدى ظواهر الفن
الجماهيرى بل والثقافة الجماهيرية ككل . فيلم ’ الحلق العميق ‘ 1972
فيلم صفرى الميزانية قصد به أن يكون مجرد فيلم پورنو سمة ( طويل نسبيا
مقارنا بما سبقه ) ، يعرض سرا تقريبا وبإدارة مافيا نيو يورك
أساسا . الصدفة هذه المرة أن سعت سلطات المدينة لحظره ، فإذا بأعلام المجتمع الأميركى كله ورموزه
الثقافية الكبرى تتقاطر وتتظاهر لحضوره ، فأصبح أحد أنجح الأفلام فى تاريخ
السينما وكتب بعض سطور لا تمحى فى القانون الأميركى ، كما خلده محررو
الواشينجتون پوست حين أسموا مصدرهم الذى حسموا به أمر استقالة نيكسون باسم الحلق
العميق . فيلم ’ عرض روكى
هورور السينمائى ‘ 1975 قصد به أن يكون فيلم طوائف
cult movie وفعلا
بعض عروض منتصف الليل الأولى له لم تشهد حضورا سوى صناعه ، لكن تدريجيا
اكتشف الجمهور أنه يمكنه ليس فقط تناول العقاقير خلاله ، بل الصعود للمسرح
للغناء مع الشاشة أو سبابها أو فعل أى شىء يعن له تحتها بما فى ذلك ممارسة
الجنس ، وأصبح من التقاليد أن لا يسمح لأى من صناع الفيلم بحضور عروضه حتى
لا يقيدوا حرية الجمهور فى التصرف ، وأن تخصص السينمات أماكن خاصة لتلك
الأغراض الخاصة ، تسمى عادة RHPS-Kits . الفيلم لم يصبح فقط ظاهرة ثقافية جماهيرية ، بل لا
يزال عرضه مستمرا بلا انقطاع للعقد الرابع على التوالى ومن ثم دخل موسوعات
الأرقام القياسية . مثال رابع ، أغنية ذات إيقاعات بدوية غير مطروقة
لمغنى مغمور كلية ، وكلاهما كان مرشحا لدور فى فن الفلكلور المتواضع ،
أصبحتا أنجح أغنية وأنجح مغنى فى تاريخ الغناء المصرى . المغنى اسمه على
حميدة والأغنية عنوانها لولاكى !
هنا فقط تطول وقفتنا بعض الشى . المزاج الجماهيرى كلمة
يقدرها بشدة علماء الاجتماع لأنهم كثيرا ما لا يجدون تفسيرا سواها للأمور . سمعت أحدهم يوما هو الدكتور مصرى حنورة يرجع إليها
فى إحدى المحاضرات فى أوائل التسعينيات موجة التدين المتصاعدة ، وكأنه ضمنا
لا يقتنع بكل ما يقال من أسباب فى تفسير هذه الظاهرة ! غالبا هذا
صحيح ، حيث المعطيات الاقتصادية لم تتغير كثيرا ، كما يصعب تصور أن
جماعة محظورة قانونا أو داعية تلفازى دميما كان أم وسيما أو حتى كل التليڤزيون
الرسمى ، بقادرة على فعل كل هذا التحول وفى تلك الفترة القياسية .
ومؤخرا قالت باحثة أميركية هى رووث كليفورد إينجز فى كتاب يحمل عنوان
’ حركات الحياة النظيفة ‘ ، إنها دورات تستغرق الواحدة من الشىء
وعكسه منها نحو 80 سنة ، وإن التدين الحالى سوف ينتهى على الأرجح سنة
2005 ! صحيح أنى أفضل عادة الحديث فى نوع آخر من الموجات
طوله ألفى سنة أو نحوها ، وأن الأرجح كون حضارتنا على شفا عصور ظلام دينى
جديدة مدتها عشرة قرون ( ما لم تتولى الأرض فى الوقت المناسب كائنات أخرى
غير البشر ! ) . لكن ربما لا يكون هذا هو الوقت بالضبط ،
ولا تزال هناك فسحة من الوقت لبعض من دورات الموجات القصار . وكما بدا لنا
كلام الپروفيسور حنورة مقنعا ، قد يكون ما قالته دكتور إينجز وجيها
أيضا ، وأن الساعة تدق اقترابا من مجرد تكرار لدورة بدأها يوما قاسم أمين
وهدى شعراوى . على الأقل يمكننا فيما يخص الوقت الراهن ،
ملاحظة إرهاصات ثورة جنسية جارفة وعنيفة تتكاثف شواهدها فى شوارع القاهرة ،
وربما كل مصر ( إن لم يكن إيران أيضا ! ) ليلة بعد ليلة ،
ولم تعد تقتصر على المستويات الطبقية الراقية وحدها ، وربما كذلك لم تعد
قاصرة على الحب وحده بل تشمل تجارة الجنس العلنية أيضا ( أعرف آباء
تقليديين وعاديين جدا ، يتوقون لتنفيذ هذه الأخيرة فى أسرع وقت ممكن ،
درءا لخطر الاغتصاب عن بناتهم ، وتخفيفا لضغوط أبنائهم عليهم من أجل
الزواج ) . من الجلى أن هذه الثورة الجنسية أصبحت نوعا من
الحتمية الاقتصادية الماسة ، وذلك كبديل لفكرة الزواج البائدة عالميا الآن
بسبب تبعاتها السكانية الباهظة ( رغم كل التدين الكاسح ، وجزء منه
بالطبع اعتبار الزواج ’ سرا إلهيا ‘ ، فإنه طبقا لتعداد سنة
2000 ، هوى عدد الأسر النووية إلى 23.5 0/0 فقط من
المنازل الأميركية أى للنصف فى حوالى 40 عاما . فى المقابل ، وفقط
خلال سنوات التسعينيات ، زاد عدد النساء المستقلات وغالبيتهن أمهات لم
يتزوجن قط ، بمعدل الربع ليصبح 12 0/0 من عدد
البيوت ، أما عدد منازل الخلان بلا زواج فقد زاد بنسبة 72 0/0
خلال هذا العقد مفرط التدين وحده ! ) . لكن بغض النظر عن الأبعاد
الاقتصادية فإن الأهمية الأكبر لها من زاوية الثقافة الجماهيرية ، أن تلك
الثنائيات أو المجموعات الشبابية التى أصبحنا نراها بكثافة ، لم تعد كما
كان سائدا تلجأ للنفاق أو الظهور بوجهين ، التى هى أمور ليست من طبيعة
الشباب الأصلية الأميل للمثالية . هذا الشباب إذن حاول عبثا لعقود أن يقنع
نفسه بالعكس أو بـ ’ كبر دماغك ‘ ، وتقرأ : افعل كل شىء لكن
فى الخفاء . بصياغة أخرى : لقد حاول هذا الشباب دون جدوى التماشى مع عصر بريتنى سپييرز
تلك المتباهية بعذريتها والتى تعظنا بالعفة ، هذا وذاك وهى شبه عارية
( ربما كى تعطينا تصميمات السراويل التى تمسكت بها طويلا فى حياتها
العمومية اليومية ، الفرصة للتأكد من وجود غشاء البكارة عندها
بأنفسنا . وليس مستغربا أن تكون دائرة الرياء كاملة متكاملة ، فتدل
الأرقام
دعنا نصيغ الوضع بطريقة ثالثة : فى كل شىء ، من السياسة إلى الفكر ،
طالبنا بشىء اسمه سؤال المحتوى ، وطالما قلنا وسنظل نقول عبارة أثيرة هى المهم المحتوى ، بل وطالما
ذهبنا لما هو أبعد وقلنا إن الديموقراطية خطأ ،
لأنك تستدعى الناس لتسألهم فيما لا يفهمون وكان يجب أن تذهب بأسئلتك لخبراء
الاقتصاد والتقنية وغيرهما . الشىء الوحيد الذى لا نطالب فيه بأى محتوى على
الإطلاق ونطالب فيه بالديموقراطية كل الديموقراطية ، هو الفن
الجماهيرى . السبب فى هذا بسيط ، أنه الشىء الذى يخص الناس
فعلا . هم ربما لا يفهمون فى العلاقات الدولية ولا بالجيل القادم من
الحواسيب ، لكنهم بالتأكيد أدرى بما يحبون مشاهدته وما يريدون الاستماع
إليه ، أدرى بكيف يرقصون وكيف ينتشون ، وأدرى بكيف يقعون فى الحب وكيف
يمارسون الجنس . هذه حياتهم الخصوصية وتلك حرياتهم الشخصية . والفن الذى
يستهلكونه ويدفعون فيه نقودهم شىء ملكهم بالكامل ومن حقهم بالكامل ، هم
الذين يحددون مواصفاته وأنواع المتعة التى يقدمها . كذلك لو حدث وشاءوا أن
يكون به محتوى فمن حقهم أيضا أن يحددونه ، ولا يصح مطلقا لنا كمثقفين أن
نتعالى عليه . أعتقد أننا ، ومرة
أخرى ، لم نفعل سوى شرح عبارة ’ الوسيط هو الرسالة ‘ من
جديد : فى الفن لا مكان للمحتوى !
[ خريف 2002 شهد تطورات
درامية للغاية . بينما سقطت پريتنى سپييرز بذات السرعة التى ظهرت
بها ، بدأ يحل محلها أسماء أكثر اتساقا بين زيها العارى ومضون
أغانيها ، أمثال رباعى النجمات اللاتى تقاسمن جائزة جرامى فى 27 فبراير
الماضى عن تعاونهن فى أغنية پوپ ، عن Lady Marmalade من فيلم موولان
رووچ ، پينك وميا والسمراء ’ سيئة السمعة ‘ ليل كيم وكريستينا
أجيليرا . هذه الأخيرة بالذات تربعت على عرش لا الغناء العشرى Teenagers
فقط ، بل كل الغناء النسائى بجدارة هائلة . هذا بينما لاح نفس مصير
بريتنى سپييرز تنظر كل مثيلاتها من المنافقات المرتدات من العفة للفحش دونما
قناعة حقيقية بأيهما ، مثال فريق ديستنى تشايلد وهلم جرا . تابع هذه القصة
المنفصلة مطولة ومعززة بمزيد من الصور بالأسفل ] . إن المزاجية نحو السينما ونجومها مثلما هى فى تناول
الطعام وممارسة الجنس ، تعبر بالأساس عن آلية بيولوچية قاعدية هى الإشباع
عندما ينقلب لنفور . وحالات قليلة التى يمكن فيها صنع فن جماهيرى
موجه ، أى دون الانطلاق من مزاج الجمهور ( مبدأ ’ الجمهور عاوز
كده ‘ المسلم به فى كل مكان ) . والحالة الشهيرة هى هولليوود
التى بفضل جبروتها الإبداعى يقال إنها هى التى تريد ما للجمهور أن يريده ! 10- العابرية أو الزوالية ephemeral أو impermanent أو transient : أو بالأحرى disposable مثل علب وجبات الـ take-away ، لا يخلد
بالضرورة ، وليس مطلوبا من الثقافة الجماهيرية هذا ، إنما مطلوب فقط
من فنون النخبة الكلاسية . كما الظهور الفجائى الذى تحدثنا يوجد أيضا
الاختفاء الفجائى ( هل منكم من يذكر أغنية اسمها
’ لولاكى ‘ ؟ للعلم هذه باعت 7 مليون شريط ليس بعيدا جدا ،
إنما فى صيف سنة 1992 ! ) . قديما كان البعض ينظر لأفلام السينما
كبوابة لخلود الفنان . اليوم
العمر الافتراضى لأى فيلم هو ثلاثة أيام . انظر
سجل إيرادات الأفلام هذا الصيف أو أى صيف فى السنوات الأخيرة أو مستقبلا ،
وستفهم ما نقصد . خمسون أو مائة مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع
الأولى ، ثم لا شىء بعد ذلك ، لسبب بسيط للغاية ، هو أن فيلما
آخر قد ظهر !
السينما
ثقافة جماهيرية = الفن للمتعة = الجمهور عاوز كده = البحث عن الإشباع مرة أخرى : ما معنى هذا ؟
فى مقابلة شهيرة للمضيف التليڤزيونى مفيد
فوزى مع نجيب محفوظ بُعيد فوز الأخير بجائزة نوبل ، ظل يلاحقه الأول بكلمات
الاستنكار والاندهاش من تعوده الاستماع للمغنى الشعبى‑الفلكلورى أحمد
عدوية ، وبعد نفاذ صبر نجيب محفوظ قاطعه بلهجة حاسمة قائلا إن عدوية لم
يجبر أحدا على سماعه ، إنما هو يشبع تأكيدا شيئا ما لدى هذا الجمهور . نعم ، إن الإشباع هو ما تدور حوله كل الفنون
بل وكل السلع . لاحظ أن هنيدى المتدين هو نفسه الذى قام بدور المحاكاة النسائية
الساخرة للداعية الشعراوى ، فى مسرحية ’ ألاباندا ‘ لكاتب علاء
ولى الدين أحمد عبد الله . هذه مفارقة مذهلة ، مع ذلك تفسيرها سهل هو
مجرد ما يلى : إن المسرح وسيط آخر . هذا الوسيط يسعى جمهوره المرفه أو
السياحى ، لتهكمات أكثر فحشا ولنكات أكثر بذاءة لا يجدها بسهولة فى الوسائط
الأخرى أو فى البلاد القادم منها . لو لم يفعل هنيدى هذا لما وجد لنفسه
مكانا على خشبة المسرح مهما كان قدر جماهيريته فى الوسائط الأخرى . للمرة
الألف الوسيط هو الرسالة . إذن ودائما ، المهم فقط شىء واحد ، هو
كيف يتمثل الجمهور الوسيط الذى يذهب إليه .
ما هو المطلوب من چوليا روبرتس حتى تدفع فيها
الستوديوهات 20 مليونا ؟ ( المطلوب أدوار كوميدية جنسية خفيفة ،
ومهما أتت من خوارق فى التمثيل الدرامى ، فلن يذهب الكثيرون لمشاهدتها
كخادمة بائسة لدكتور چيكيل ، أو كامراة وسواسة اسمها ’ إيرين بروكوڤيتش ‘
شغلها الشاغل ’ نظرية مؤامرة ‘ عن ’ طيور
الپليكان ‘ ) . ما هو المطلوب من عمرو دياب حتى يدفع الناس فيه
ثلاثة ملايين فى ثلاثة أيام ( المطلوب فتى وسيم عاشق تحيطه صبايا
فاتنات ، وهذا الوضع يشبع الجنسين معا رغم أنه ليس حتى شرطا للفن
الجماهيرى ) . وما هو المطلوب من شعبان عبد الرحيم ( أن يغطى على
صخب وعصبية قيادة سيارة مايكروباص فى قلب القاهرة . لاحظ أبعد من هذا أن
مصاحبة الفن لأداء الأشغال تكاد تكون تعريفا للفن الفلكلورى . ولاحظ أيضا
أن اكتشاف المثقفين له فجأة تبعا لأچندتهم الخفية الخاصة وبعد سنوات من زوال
بريقه فى أعين جمهوره ، شىء بلا قيمة إطلاقا من منظور الثقافة الجماهيرية
وربما من أى منظور ! —ذلك البريق كان قد وصل لذروته أيام الخيال الرائع
الذى جعل شارعا من حى شبرا يمارس الجنس مع المزلقان المجاور الذى يحمل اسم
امرأة ‑لاحظ الهيئة التشريحية لطرفى العلاقة ! ،
والاستثناء الوحيد المحتمل لأهمية اكتشاف هؤلاء له ، أن يؤدى من خلال
إدخالهم إياه لوسيط آخر كالسينما مثلا ، إلى تحوله من فنان لطبقات الفلكلور
إلى فنان جماهيرى ، أى ذى جماهيرية عابرة للطبقات أوسع من كل ذى
قبل ) . فى كل من حالات روبرتس ودياب وعبد الرحيم لاحظ أن
المتعة الجنسية غير المباشرة هى هدف شبه ثابت فى كل الفنون ، بما فيها حتى
الغناء الدينى شرقه وغربه ( فقط تفرس فيمن حولك ، وستكتشف أن فرويد
أيضا قانون إنسانى طاغوتى ) . أيضا لاحظ أن آخر الأشياء أهمية فى
تفسير النجاح هو المحتوى الذى يقال . فدائما أبدا المهم التمثل ، وأن
الوسيط هو الرسالة ، إن لم يكن من الممكن فى كثير من الحالات اختزال هذه
المقولة لما هو أبعد : النجم هو
الرسالة . وكلا تلكما الأمرين ( الجنس وكون
الوسيط أو النجم هو الرسالة ) يؤشر فى نفس الوقت لشىء ثالث هو الوظيفية
التى طالما بشر بها برونيسلاڤ كاسپر مالينوڤسكى ، حتى أفلح فى
نهاية المطاف فى ترسيخها كنظرية قاعدية للأنثروپولوچيا الثقافية ، ولم تعد
كما كانت فى البداية ساحة لاختلاف اليمين واليسار مثلا ( داروين هو أحد
أكثر القوانين طاغوتية إطلاقا ، هذه المرة ليس إنسانيا أو أرضيا
وحسب ، بل فى كل الكون ، ومالينوڤسكى هو همزة الوصل الأولى جدا
بين عالمه البيولوچى والفلسفى ، وبين دنيا الثقافة أو ما تحورت لاحقا فى
العصر الچيينى لتسمى دنيا الميم meme أو المماثلات . أيضا لعلنا نجد فى نظرية
الوظيفية ، وكون كل تلك الوظائف أسطورية بالأساس ، تفسيرا للماذا كل
الأفلام الفائقة ‑500 مليون فأكثر بالذات‑ تدور حول أساطير ،
كما حروب النجوم الأوديسى ، أو إى تى المأخوذ عن قصة المسيح ، أو
تايتانيك عن حواديت جنون الحب وتضحياته ، وهلم جرا [ طبعا لا بد وأن
نضيف لاحقا فيلمى البليون لكل جزء من أجزاء أيهما ’ هارى پوتر ‘
و’ لورد الخواتم ‘ ] ) .
فى هذه ( الموسيقى ) ، وفى السينما
ليست لدينا قياسات رأى عمومى دقيقة لمسألة التمثل تلك ، لكن من خلال
الحوارات الفردية مع الأقارب أو الجيران فى كرسى السينما أو فى البيت لا تبدو
المسألة صعبة ، بالذات بالنسبة للكوميديا الجديدة ونجومها . الإجابة
شبه واحدة : أول ما بأشوفه بأضحك ! الحقيقة هذا أعظم مدح وبرهان ممكن
على براعة تقانة رسم الشخصيات‑القوالب تلك التى تحدثنا عنها قبل
قليل ، وفى نفس الوقت الحل لكل أجزاء معادلتنا عن الجماهيرية والتمثل والإشباع
والوظيفية والوسيط والتقانة : المهم الضحك ولا شىء إلا الضحك ، يستوى
فى هذا هنيدى المتزمت مع ولى الدين الماجن . [ ملحوظة : لم أجد ما أدافع به فى
الندوة من الناحية العلمية ، عن مصطلح ’ الكوميديا الجديدة ‘
المعتمد صحافيا . من ثم تعدل عنوان الورقة إلى ’ صحوة السينما
المصرية ‘ ، والفضل فى هذا يذهب للزميلة صفاء الليثى ، التى لا
أدرى هل توافق على العنوان الجديد أم لا ، لكنى على الأقل أضمن استعدادى
للدفاع عنه ] . قد يقول قائل إننا لم نجب على السؤال بعد ،
وما قلناه عن تحول ما يسمى بالكوميديا الجديدة لصحوة تندرج تحت الفن
الجماهيرى ، هو كيف وليس لماذا . ربما نعم وربما لا . والسبب
طبيعة الفن الجماهيرى ذاتها . وللأسف قد تنتهى هذه الورقة التى أفاضت فى
الحديث عن الإشباع ، دون أن تشفى غليلك عزيزى القارئ ، بإجابة شافية .
ربما يخضع الفن الجماهيرى بدرجة غير قليلة لنظرية الفوضى ، التى بدأت
بالجسيمات ثم وجدوا أنها صالحة للاقتصاد ، ويوم تخرجت من الجامعة كانوا قد
بدأوا يتحدثون عن تطبيقها على بعض الانهيارات الميكانية ! ثنائية الإشباع‑الملل
قد تكون قانونا ، لكن الأهم هو اللحظة التى يتجلى فيها القانون فى صورة
طفرة مثيرة على أرض الواقع . هنا قد يكمن تفسير التحولات الكبرى فى أشياء
ثانوية جدا ، أو قد تنجم عن عدة أشياء تافهة تراكمت ، أو من أشياء
صغيرة التقت فى ذات اللحظة . ربما لمضامين هنيدى الدونية دور ، ربما
لاقتصاد الجنزورى أو لبطالة من أتى بعده دور ، ربما الملل من بكائيات التليڤزيون
أو اجتماعياته المغرقة ، ربما الملل منه نفسه كوسيط أو كـ
’ الـ ‘ وسيط ، ربما انطلقت الشرارة بسبب إعلان عن فيلم تسامحت
معه رقابة التليڤزيون ، أو بسبب أغنية ، أو حتى ربما بالصدفة
المحضة فالواقع أن الملايين ذهبت لمحمد فؤاد فوجدت محمد هنيدى ينتظرها .
لكن المؤكد أنه لا يوجد عامل حاسم وأن الظاهرة لا يمكن اختزالها فى تفسير
بسيط .
هذا ما أردت قوله ، لتبقى بعده كلمة أخيرة تخص
الزملاء النقاد . الواقع أنه رغم كل ما قلنا عن ثانوية المحتوى فى السينما
وفى الفن الجماهيرى ككل ، فإن هناك دائما هامشا له للتأثير فى فئة الأقلية
الأكثر استعقادا من الجمهور ، زائد الأثر العام الباطنى غير المباشر وربما
غير المحسوس لروح التحرر أو التزمت العامة للأفلام على المجتمع ككل ( وما
يترتب على تحرر المجتمع من تقدم وإبداع علمى وتقنى واقتصادى ، وما يترتب
على كونه مجتمعا بلا ’ ثوابت ‘ ‑كلمة العرب والمسلمين المفضلة‑
من آفاق غير مقيدة التفكير لدى الأطفال ، كلها أمور بديهية
ومعروفة ) . والمهمة المباشرة والمحدقة التى تتضرع لنا بها هذه
الحقيقة ، هى ضرورة تبنى النقاد الفورى لمطلب الإلغاء الكامل
للرقابة ، وإحلالها بنظام طوعى للتوجيه الأسرى يقوم على التصنيف العمرى
ويستبعد تماما المنع والحذف ، وتتولاه الصناعة نفسها ممثلة تحديدا فى غرفة
صناعة السينما ( فى الواقع هذه أچندة چاك ڤالنتى ، ومن ورائه
نصف الكرة الغربى ومعظم الشرقى ، ذلك أن رأيى الشخصى شىء آخر هو وجود بعض
من النفاق فى هذه الفكرة ، وأن جميع الأفلام تصلح لجميع الأعمار ، إن
كنا نريد حقا تصنيع نشء قوى ) . لكنى فى الحقيقة أسعى لشىء آخر أكثر
استراتيچية ، هو الدعوة لأن يهتم النقاد بالثقافة الجماهيرية بدلا من
اهتمامهم بثقافة النخبة . حيث فى كل الأحوال إيمانى الثابت أن من صميم
مسئولية الناقد تقديم الإجابة على لماذا نجح هذا الفيلم ولماذا فشل ذاك . لذا لعل المطلوب أولا قبل أن يتحدث بإعجاب أو
استهجان عن حركات الكاميرا أن يكون محللا أو حتى عالما سوسيولوچيا . وعلما
أيضا بأن رأيى أن صناع السينما المغمورين الذين يستنزفون منا كل الوقت فى لجان
تحكيم جمعية النقاد ، لا يقدمون ثقافة نخبة حقيقية بل مجرد أفلام رديئة
الصنع خائبة الدراما كئيبة المظهر وليس إلا ، هم أنفسهم يتخيلون أنها صنعت
للجمهور العريض وأنها تستحق أن تعرض فى 50 شاشة مثل علاء ولى الدين لولا
’ اضطهاد ‘ الموزعين لهم .
النقاد يحكمون على الأفلام
الجيدة بالكلام ، أما الجمهور فيحكم عليها بنقوده . أيها
السادة ، قليلا من الاحتراز والتمعن ، والأهم منهما التواضع ، فى
التعامل مع ممتعات الجمهور ، فإنها ظواهر سوسيولوچية فائقة الاستعقاد
والرقى ! لطالما باع لنا النقاد أسوأ
منتجات السينما على وجه الإطلاق ، أو قمامتها لو شئت ، تلك التى محتها
ذاكرة التاريخ بسرعة مرعبة : سينما ’ مثقفى ‘ أوروپا والشرق ،
التى طالما طبلوا لها بدوى هائل عبر ما يسمى بالمهرجانات السينمائية . وفى
المقابل جعلوا من السينمات المسماة تجارية فى ذات البلاد أسوأ السينمات حظا
عالميا على الإطلاق ، محاصرة فى بلادها الفقيرة ولا تجد من يلحظها فى السوق
التجارية الأكبر فى أميركا إلا عن طريق الڤيديو أحيانا ، وإلا لو
فرضت نفسها فرضا ، كأفلام برووس ليى مثلا . وهذا إهدار مثير للانقباض
لإبداعات يعيدون هم أنفسهم اكتشافها لكن بعد فوات الأوان وبعد أن مات معظم
أصحابها كمدا . الآن فى هذه المهرجانات يكرمون راچ كاپوور وبرووس
ليى ؟ لماذا لأن صديقهم آنج ليى يصنع أفلاما شبيهة ، والأدهى طبعا أن
غالبية النقاد يرفضون حتى الاعتراف ببرووس ليى مثلا كأستاذ لكل ما امتدحوه من
’ صوفية ‘ و’ باليه ‘ … إلخ ، فى ’ النمر
الرابض التنين الخفى ‘ . أيتها السينمات القومية الموصومة بالتجارية
لك السماء ولك جمهورك المخلص على فقر موارده ، ولك كوينتين
تارانتينو !
مع ذلك لا تتخيل الموقف النقدى
موقفا متماسكا على طول الخط أو مبدئيا يروج لأشياء محددة . بالعكس حين
يتعلق الأمر بخصائص الفن الجماهيرى تراه لا يخلو من تناقض ظاهر طوال
الوقت . حين يأتى أصدقاؤهم ’ الفنيون ‘ بمشغولة بها بعض
التسلية ، ينطلق منهم قاموس غريب خاص وجديد نسبيا ، يتحدث عن
’ الدهشة ‘ وعن ’ البهجة ‘ ، تحاشيا لاستخدام كلمتى
إبهار ومتعة الهولليووديتين سيئتى السمعة ، أو كلمتى ميلودراما وكوميديا
لأنهما عورة ، أو ربما فقط هو قاموس مستعار من أقرانهم نقاد الأدب والشعر
ممن أحسوا بالهوة الساحقة بين منتجات فنونهم وبين الجمهور العريض ،
فاخترعوا مصطلحات من قبيل الواقعية السحرية والبوح ( كلمة ثالثة يقصدون بها
الپورنوجرافيا لكن عندما تأتى من الرفاق الأيديولوچيين ! ) ، ذلك
كى يجملوا بضاعة هى على العكس راكدة تماما . فعلا هذا تجمل لا أكثر ،
وليس قبولا بحال لمنطق الفن الجماهيرى ، لأنهم ينطلقون ‑وربما فى ذات
المقال‑ للهجوم على الأشغال ذات الجماهيرية الحقيقية التى تمتع الناس
و’ تدهشهم ‘ و’ تبهجهم ‘ و’ تسحرهم ‘
و’ تبوح ‘ بوحا حقيقيا بما يعتمل فى غرائزهم ووجدانهم ! يقولون عن اليمين لو دافع عن حق
المستهلك فى شراء السلعة الفنية التى يشاء مقابل نقوده ( الجمهور عاوز كده ) ،
يقولون إنها سلع تستخف بهذا الجمهور تخدعه وتغيبه وتحط منه وتنحط به . ليس
الفن الجماهيرى من يحتقر الجمهور . اليسار هو الذى يحتقر الجمهور ذلك أنه
ينصب نفسه وصيا عليه . ربما يقرون بحق البهائم فى برسيم شهى مغذى نظيف منمى
چيينيا تحبه لكنهم ينكرون على عموم البشر اختيار برسيمهم الخاص والاستمتاع
بتناوله . نحن من نسمى باليمينيين نحترم الجميع ، نحترم
رغباتهم ، نحترم حقهم فى المتعة وفى اقتناص كل لحظات السعادة
الممكنة . ونرفض كل الرفض الغش التجارى أو خرق قانون المستهلك ببيعه سلعة
مزيفة أو غير مرغوب فيها أو مكتوب على غلافها ما هو خلاف ما بداخلها . نحن
ببساطة ندافع عن حق هؤلاء البسطاء الذى لا ينازع فى الحياة طالما هم مسالمون
يحترمون بقية الطبقات ولا يريدون فرض تخلفهم ‑الذى يتحدث عنه اليسار أكثر
من اليمين بمراحل‑ على بقية المجتمع . أما اليسار فهو يبيع برسيما
أيضا لكنه برسيم فاسد وغير مرغوب فيه ، فقط يريد انتزاع نقود هؤلاء الناس
مقابل السلعة الوحيدة التى يملكها : النكد !
وبالعودة لسينمانا الجديدة البازغة فى مصر ، ليسمح لى الزملاء على الأقل بسؤال أخير أوجهه لضمائرهم هذه
المرة : من الأكثر ترشيحا للاغتيال والبطش بواسطة قوى التخلف ، هل
هؤلاء المغمورون أيا كانت الجرأة المتوهمة فى أفلامهم ، أم أمثال عادل إمام
ونادية الجندى ووحيد حامد وأحمد عبد الله أيا كانت بساطة الأفكار التى
يقدمونها . بالتأكيد فى كلتا الحالتين النقاد أنفسهم فى أمان تام بعيدا عن
معركة الحياة والموت ، هذه الدائرة فى حلبة السينما الجماهيرية .
مثلهم الأعلى فى ذلك هو نقاد أوروپا ، كل ما يهمهم هو إعلاء شعار سينما
الأوتير ، وأن دور الناقد دائما أبدا هو الترويج للسينما الرفيعة
فنيا ، لا أكثر ولا أقل [ رأى دافع عنه بشدة فى الندوة كثيرون فى
طليعتهم الزميل أمير العمرى ] . نعم الفن الجماهيرى سطحى انفعالى وزائل ، ونعم
أنا أرى السينما شيئا يصنع من أجل العامة ، ودور الناقد هو التأكد من أنها
تناسب هذا الجمهور المتواضع ’ إللى عاوز كده ‘ ، لا أفضل ولا
أدنى ( أو للدقة التامة : أفضل قليلا من مستواه ، تحاول الارتقاء
به بعض الشىء فكريا ووجدانيا ، وإن كان كل شىء يخضع لمنطقه هو
بالضرورة . والنموذج المثالى فى هذا الصدد هو منهج
هولليوود الجماهيرى التحررى فى ذات الوقت ) . لكنه ‑أى الفن
الجماهيرى‑ ثقافيا هو ساحة القتال الاجتماعية الحقيقية والوحيدة ،
ولحد بعيد ساحة القتال الإبداعية أيضا . حتى لو نحيت التخاذل الأخلاقى لنا
أمام الصراعات المستعرة فى مجتمعنا ، ستجد على الأقل أن مشكلة نقاد أوروپا
أن ظلوا يروجون لسينما ركيكة يوهمون أنفسهم بأنها رفيعة ، إلى أن أفضت
تبجحاتهم المتشامخة إلى أوروپا خاوية من أى سينما من أى نوع ! [ إجابة أسئلة طرحتها الندوة : للحقيقة
السينما المصرية أنتجت فيلما فنيا واحدا هو ’ المومياء ‘ ،
وبالطبع أصحابه ممن يعرفون المعنى الراقى والحق لكلمة سينما فنية ، ممن
كرسوا عمرهم له كما الهواة ، أناس مهذبون بطبعهم ، ولم يكابروا يوما
بأنه أفضل أو سوف ينافس الكلاسيات الكبرى للسينما المصرية فى إيراداتها أو
جماهيريتها أو أثرها الوجدانى الهائل والمستدام . بل من الملفت أنه عدا
’ المومياء ‘ ، كانت علاقة شادى عبد السلام بالسينما
المصرية ، كشخص رفيع الاحترافية بل ومصمم الإنتاج الوحيد فى تاريخها ،
تنحصر فى أكثر أفلامها كلفة وجماهيرية إطلاقا ، أو بكلمة أخرى أكثرها
’ تجارية ‘ . وهذا كلام يضطرب للحديث فيه مدعو
’ الفنية ‘ وأنصارهم من النقاد ، الذين يتخذون من فيلم
’ المومياء ‘ ، بوابة للحط من شأن السينما الجماهيرية . فى
المقابل أقنعتنى كل حواراتى المباشرة مع صناع ما يسمى بالسينما الفنية من
الموجهين المصريين من مختلف الأجيال ، إلى أن لا ريب لدى أى منهم فى أن
السينما ’ التجارية ‘ هى ’ الـ ‘ عدو ، وهى ما يجب
عليهم القضاء عليه قبل أى شىء آخر . وأقنعتنى بالمثل أن لديهم كراهية وحسدا
لن تهتز يوما لأى رمز أو حتى أى سينمائى صغير مشارك فيها ، وقبل الجميع لمن
يمولونها بالطبع .
أما إذا حدث وواتت أحد العجزة
أدعياء الفن هؤلاء الفرصة للاشتغال بها ، فإنه ينقلب حينئذ شخصا صريح
الادعاء بالكامل ينظّر لعبقرية ’ توازناته ‘ الخاصة ‑فى رأيى لا
لشىء إلا ليبرر فشل الفيلم الذى صنعه . فى بعض بلدان أوروپا المحدودة
سينمائيا تدفع الدولة للأفلام من أموال دافعى الضرائب ، قدر ما تحققه من
إيراد فى شباك التذاكر ، دولارا بدولار ، وليس العكس كما يطالب صناع
السينما الفاشلون عندنا ! … وبعد ، إن كان لنا من معركة نحن
النقاد فيجب ، فى رأيى ، أن تكون مع هؤلاء ! ] . [ المفاجأة الأكبر ‑بالنسبة
لى على الأقل‑ أن أرى الأفكار النخبوية وقد راحت تتردد بسلاسة مدهشة على
الألسنة اليسارية ، وكأن الجميع اتحدوا لأول مرة أمام ما اكتشفوا أنه عدو
مشترك : السينما الجماهيرية . لكن ثم مفاجأة مذهلة أخرى للندوة هى أن
كشفت عن رأى شائع شبه موحد وأقوى مما توقعت ، يقول ببساطة إنه بما أن
الجمهور منحط ، فهذه السينما من ثم منحطة بالضرورة ( والمفارقة أنى لا
أدعى لنفسى الأسبقية فى استخدام هذه الأوصاف ! ) ] . أنا أرى المعادلة على النحو التالى : مبدئيا
لا يصح الاستهانة بسهولة بجمهور الفن الجماهيرى ، أى الطبقة الوسطى الحضرية
المتعلمة ، والتى يفترض أن تنطلق كل برامج النهضة ( بما فيها
الانقلابات العسكرية ! ) منها . لكن ليكن ، فلنسلم معا بما
يمكن تسميته بالظرف التاريخى الخاص ، والناجم عن الهزيمة الحضارية الشاملة
تقنيا واقتصاديا أيا كان المذنب فيها ، ولنقر بما نراه من درجة واضحة من
التخلف فى ذلك الجمهور . لكن رغم هذا بل ورغم كل شىء ، لا تزال الغالبية
العظمى من السينمائيين الناجحين ومن مضامين الأفلام الكبرى متقدمة منفتحة
وواعية ، ومن الحماقة إشاحة البصر ببساطة عن واقع إيجابى جدا كهذا ،
بالذات مع كونه سمة سائدة فى الفنون الأخرى أيضا كالغناء وغيره . أما ثالثا
من حيث التقانة فأنا مستعد للمجادلة حتى آخر المطاف أنها بالنسبة للأفلام
الناجحة ، لا يمكن إلا أن تتمتع بالحدود الدنيا من الاتقان والتمكن ،
مهما كانت درجة تخلف الجمهور ، بل ومهما كانت درجة تخلف المحتوى . إنه
فى أية لحظة بالغة التقدم أو التخلف اجتماعيا ، مصرية كانت أو غير
مصرية ، لا يمكن أن يرقى لمستوى الفن الجماهيرى إلا أفلام متقنة الخداع
والصنعة ، وهذا الأمر ليس بمفارقة إنما هو قانون سينمائى بل ووسائطى أزلى
ومطلق . إن وراء كل تذكرة مفردة من تسعة البلايين وربع المباعة فى العالم
العام الماضى ، سلسلة من القرارات الشرائية الصعبة ، فما بالك بذلك
الشعب الفقير المرهق الذى دفع ستين مليونا لمشاهدة الأفلام المصرية . لا شك
أنه وجد سلعة رائعة للغاية أجبرته على إعادة توجيه جانب من قروش ميزانيته
الأسرية الشهرية القليلة إليها .
هذا يقودنا لأهم إنجاز
لهذه السينما الجديدة المسماة بالكوميدية ، تلك الأموال الهائلة التى أصبحت
تضخ فى شرايين الصناعة . إنها البداية لتأسيس السينما كصناعة لأول مرة فى
مصر ، بالمعنى الاحترافى المعروف عالميا لكلمة صناعة . أرجو ألا يكون
ما سأقوله صادما ، لكنى أخاطر بتجربة حظى فيه . سينمانا المصرية حتى
اللحظة هى سينما هواة لم تصنع سوى فيلما احترافيا واحدا هو ’ لاشين ‘
1939 ( أو بالأكثر إرهاصته ’ وداد ‘ 1936 الذى لم يكن له من
’ مخرج ‘ إنما فقط مدير الستوديو فريتز كرامپ ’ مديرا
فنيا ‘ ) . ما عدا ذلك كلها جميعا أفلام هواة بكامل مواصفات
الكلمة . يصنعها ’ مخرجوها ‘ وليس منتجيها . تصنعها
اجتهادات أفراد وليست رؤية شركات . ولا يقف وراءها أى بناء مؤسسى مما تعارف
عليه العالم للسينما الاحترافية . صحيح هناك بعض الحالات تلحظ فيها ارتقاء
أصحابها بمواصفات أشغالهم لتقارن بأفضل المستويات العالمية . لكن من قد
نذكرهم فى هذا الصدد وليكن عز الدين ذو الفقار وكمال الشيخ ، هم أقرب
للسينما الفنية أو شبه الفنية عالميا ، وليس لسينما التيار الرئيس .
ربما ’ رد قلبى ‘ 1956 يوحى بمستويات الإنتاج الكبير ، كما أن ذو
الفقار خاض فى كل الضروب السينمائية بما قد يعطى الانطباع بأنه أقرب لموجه
ستوديو بالمعنى الهولليوودى للكلمة . لكن هذا الفيلم المذكور يظل كما كل
أفلام ذو الفقار بنى على أكتاف فرد واحد ، وكلها بها كثير من الولع الذاتى
بكل شىء بدءا من الموضوع حتى الوقوع فى غرام البطلة نفسها . كما أن أفلامه
فهى أقرب لتجارب سينمائية لا سيما فيما يخص خلط الضروب السينمائية معا ،
وطبعا هى جهود تستحق كل تقدير وانبهار لأن هولليوود نفسها لم تكن لتجرؤ
عليها ، وحين جرؤ هو لم يأت بكوارث إنما بأشغال مقبولة جدا جماهيريا .
كمال الشيخ لا يذكرنا من قريب او بعيد بموجهى الستوديو ، لم يصنع مثلا
فيلما غنائيا أو ميلودراميات اجتماعية أبدا . شغله الشاغل كان دفع الشق
الإبداعى والفنى لأقصى مدى ممكن ، يؤدى ما بعده لأن يحقق الفيلم
لخسائر . هذا يذكرنا بأمثال ألفريد هيتشكوك وستانلى كيوبريك ومارتين
سكورسيزى ، الذين يدفعون بأشغالهم لآخر نقطة ممكنة فى جبهة التجريب والجدة
والتجديد ، لكن أبدا دون تجاوز الخط الأحمر ، خط الخسارة
المالية . أفلامهم تحقق 50 مليونا فى المتوسط . لم تحقق أبدا 500
مليونا ، لكنها بالمثل لم تحقق خمسة ملايين . وطبيعى أن تكون من
الأكثر خلودا لأنها جمعت الابتكار والأصالة جنبا إلى جنب مع التسلية وإرضاء
الذوق العمومى . ما أردنا قوله هو ما يلى : سينمانا كانت فى أفضل
حالاتها سينما اجتهادات لأفراد ذوى رؤى ، واعين نعم ، أذكياء
نعم ، مبدعين نعم ، لكن لم يكونوا صناعة أبدا . ( حين عرضت
هذا الرأى ذات مرة على الراحل صلاح أبو سيف ، سائلا إياه هل سينمانا سينما
هواة أم سينما حواة ، ضحك ثم فكر لبرهة واختار الإجابة
الثانية ) .
مرة أخرى هذه هى المعادلة إذا كانت لنا رغبة يوما
فى التأثير فى أى من حدودها : جمهور
متخلف لأسباب ما + مضامين بعضها متخلف وأغلبها راقى + تقانة متقنة على طول الخط
الناقد يجلس فى قاعة العرض ليكتب
ما شعر به تجاه الفيلم . هذه ليست وظيفته . وظيفته أن يكتب مشاعر
المشاهد فى المقعد المجاور . مشكلة النقاد أنهم يفترضون أن الأفلام تصنع
لتعزية هواجسهم هم الذهنية ، بينما الحقيقة أنها تصنع من أجل الناس .
فقط دور الناقد التأكد من أنها تناسب المستوى العقلى والوجدانى لهذا العموم من
الناس . دور الناقد ببساطة هو عينه
بالضبط دور عالم النبات أو الحيوان ، عالم وليس مخترعا ، مراقب
محايد ، لم يصنع الأشياء ، وفقط يدرسها ويتأملها . ببساطة جارحة نحن النقاد يعجبنا
من الأفلام ما نستهلكه نحن شخصيا ، نريدها كلها أفلاما ذهنية بطيئة ،
بينما الحقيقة أن الأفلام لم تصنع من أجلنا ، ودورنا الصحيح أن نقيمها
باعتبارها سلعة صنعت أساسا لاستهلاك الجمهور .
( أنا شخصيا لا أعتبر نفسى مستهلكا ‑بمعنى أن أجد شيئا ما يشبعنى
ويزيدنى‑ إلا عامة لدى هيتشكوك
وكيوبريك بعد‑الإنسانيين
فقط . هذا أقصى ما يمكننى الاعتراف به لأنه عدا هذا لا أسمح لنفسى بأكثر من
التعامل المهنى المحض وعن بعد مع أفلام أعلم أنها موجهة لأحد غيرى
بالكامل ، وأقيمها كلية من هذا المنظور ) .
أو باختصار : المعيار الذى يجب أن يحكم به الناقد هو متعة المشاهد ،
وبالنسبة للمحتوى عليه محاكمته من منظور هل يزيد متعة وانفعال واندماج المشاهد
أم ينقصها ، قبل الحكم عليه كمحتوى فى حد ذاته .
هل تذكر تلك الجدلية القديمة حول
الفن للفن والفن للمجتمع ؟ بمرور الوقت اتضح أن واحدة أضيق مما يجب وأن
الثانية ذات أچندة سياسية خفية معادية للفن . وما استقر اليوم واقعيا
وجماليا واجتماعيا ، هو عينه ما كان مستقرا قبل كل التنظيرات وقبل التاريخ
نفسه : أن ما الفن إلا للمتعة . الفن للفن هى ربما نظرية جيدة
للنخبة ، والفن للمجتمع هى ربما نظرية الطبقات الدنيا لفنها
الفلكلورى ، لكن كلتيهما ما يجب أن تمتد قط لحقل فن التيار الرئيس ،
الفن الجماهيرى ، حيث فقط : الفن للمتعة . نعم ، لوحات
پيكاسو مثالية تماما كفن للخاصة ، وأغنية ’ يا مهون هون ‘ التى
يعنيها عمال البناء فى مصر نموذج رائع للفن للمجتمع ، لكن مسلسل دالاس
وفيلم خلى بالك من زوزو لها وظيفة أخرى كلية ، غير هذه وتلك . على
الأقل لأن الأولين لم تنفق أموال تذكر على إنتاجهما !
لو أشبع الفن الغرائز نقول له
شكرا فقد أشبعت وظيفة مطلوبة . لو أشبع الفن الوجدان نقول له شكرا فقد
أشبعت وظيفة مطلوبة . لو أشبع الفن العقل نقول له شكرا فقد أشبعت وظيفة
مطلوبة . لو أشبع اثنتين منهما فى نفس الوقت نقول له شكرا مضاعفة ،
ولو أشبع الثلاثة نقول له شكرا مثلثة . ليس فى هذه الإشباعات واحد أرقى
أو أحط من الآخر ، هذا يعتمد على احتياجات المتلقى نفسه وعلى اهتماماته
ومستوى ثقافته . المعيار فقط هو المتعة ، هى وظيفته المالينوڤيسكية
الماكلوانية الوحيدة . أقصى ما نستطيع قوله إنه فى كل الأحوال لا يمكن لى
أو لأى أحد إنكار أن ثم محتويا فكريا ولو مخففا ، فى كل شغل فنى أيا ما
كان ، وأن من الواجب دوما أن نحفزه نحو أن يكون راقيا تقدميا وحداثيا بقدر
الإمكان . إلا أنه حتى اللحظة نضطر للقول إن موقف نقادنا من النهضة الجديدة
للسينما المصرية ، هو اختزال عودتها المظفرة كظاهرة اجتماعية كاسحة كبيرة
ومتكاملة ، إلى مجرد كلام سفسطات تقانية عن حركة الكاميرا وترحم مثقفاتى
على ذاتية الفنان الضائعة . بل إنهم كما نجحوا تاريخيا فى وضع كلمة
ميلودراما فى القاموس ككلمة سباب ، يحاولون ذات الشىء الآن مع الكوميديا
ويكادون يتحدثون عن الضحك وكأنه عورة !
الواضح أن أحمد عبد الله وعلاء ولى الدين ليسا
منتهى المطاف . الروافد تتسع وتزداد جرأة يوما بعد يوم . فيلم ’ فيلم ثقافى ‘ من
العام الماضى 2000 مثلا ، وآخر ما أتتنا به صحوة الكوميديا هذه ، هو
صرخة هائلة ‑بل ومفاجئة‑ ضد الحرمان الجنسى ، تدين كل شىء بدءا
من الدين ونفاق الدين حتى جبن الشباب نفسه ، ونكوصه عن التصدى للقهر
المجتمعى . وفى المقابل تطرح نموذجا للاستواء والجرأة والتمسك بالحرية
الجنسية ( يسميها شباب القرن الحادى والعشرين ! [ الفتاة الصغيرة المثال هذه
أصبحت بعد قليل نجمة غناء وتمثيل شهيرة
باسم روبى ] ) .
تلك العناصر افتقدناها جمعاء تقريبا منذ صحوة السينما الجريئة جنسيا فى النصف
الأول للسبعينيات ، وهذا الفيلم ‑رغم أن الظروف الرقابية والمجتمعية
الحالية لم تسمح له بتقديم ما كانت تقدمه تلك الأفلام من مشاهد‑ لا يقل
عنها بحال فى تحريضه الصريح على الثورة الجنسية . لا نحب الكلام فى المحتوى كثيرا ، لأننا طالما كافحنا ضد
اعتباره عذرا لتبرير رداءة الأفلام وعدم جماهيريتها ، وكافحنا بالذات ضد
جعله للأفلام critic-proof
كفيلم صعيدى فى الجامعة الأميركية الذى هلل له والنقاد ونسوا
فجأة كل شىء يرفضونه فى الموجة الكوميدية الجديدة لمجرد أن قدم علما إسرائيليا
يحرق ، والمنتجون من الذكاء بحيث يعرفون هذه السكة المضمونة جيدا ويتعمدون
من خلالها حماية أفلامهم من النقد . لكن أيا ما كان شأن المحتوى الواضح أننا لا زلنا فى بداية جبل الجليد . السينما
المصرية يعاد بناؤها الآن ‑وربما لأول مرة‑ على أسس صناعية واتصالية
وتجارية سليمة ، أما النضج الفنى وتنويرية المحتوى وحتى التنوع لغير
الكوميديا ، فهى قطعا أمور كلها لن يطول انتظارها ، ولن تعد مشكلة
طالما بدأ الأساس الحقيقى لبنية تحتية قوية للصناعة ماليا وبشريا . من كل هذا نخلص لأنه ليس بين أيدينا كنقاد
وكمثقفين ، سوى التعلق بأمل الهامش الممكن لأن تلعب الصحوة السينمائية
الحالية دورا تنويريا أكبر ، ولن يتعزز هذا إلا لو تبنينا من موقعنا كنقاد
تحليلها بهدف تحسين مستوى استيعاب الجمهور لها ، وفى نفس الوقت بهدف إقامة
الحوار الذى يحترم من صناعها البارعين والناجحين منهم . والبراعة هى الشرط
الوحيد فى مثل هذا الحوار ، قبل الحاجة مثلا لتصنيف هذه الفئة ما بين
مستنيرين وغير مستنيرين ، فكل أصحاب القدرة الفاعلة فى مخاطبة الجمهور
أصحاب حق علينا فى مثل ذلك التفاعل . نأمل لهم أن يفيدوا منه بعض الأشياء
( ليست بالضرورة ذات الأشياء التى أفدنا بها سعاد حسنى ، التى لأنها كانت
محاولة لتحدى قوانين الثقافة الجماهيرية ذاتها ، انتهت نهاية
كارثية ! ) . ومن الناحية الأخرى نأمل لأنفسنا كنقاد أن يرفعنا
ذلك قليلا من وضعيتنا الحالية ، وضعية الدور المنعدم . كل هذا قبل أن
يفوت الأوان ويعود الجمهور من جديد إلى من حيث أتى . آنذاك سوف نتهافت على
إلقاء اللوم على أى شىء ، ومن الجائز وقتها أن تصبح كلمات مثل آليات
الثقافة الجماهيرية ونهرها الهادر الذى لا يرحم ولا ينتظر ، ذريعة رائعة
نبعد بها الذنب عن تقصيرنا . … أيا كانت الحجة التى ستعن لنا ،
فالمؤكد ساعتها شىء واحد فقط : أن لن يجدى أى ندم ! هل تريد المساهمة ؟ … يمكنك ذلك مباشرة
من خلال لوحة الرسائل إضافة أو قراءة أو بالكتابة عبر البريد الإليكترونى . الجديد : Cover Story:
(Summer 2001)
الحقيقة أن الأمر قضى قبل كل هذا بسنوات
وسنوات . قضى يوم التف البعض حول نجمة وصلت لآفاق من الشهرة والتأثير لا
حدود لها ، ليقنعوها أن كل ما تقدمه محض هراء ، وأنها يجب أن تقدم
أشياء جادة من الآن فصاعدا ( جادة تقرأ كئيبة ، وتقرأ رديئة
الصنعة ، وتقرا أيضا يسارية ، ومما يثير الغصة فى الحلق أن ألمح البعض
لى أن الحكومة المصرية ربما لم تتحمس كثيرا لمواصلة علاجها المكلف فى
الخارج ، لأنها عادة ما لا تصنف كشخص موال تماما ، وذكرونى بأيام
الولاء لمنظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت هذه الأخيرة فى حالة حرب تقريبا مع
مصر ) . أولئك العباقرة المناضلون صنعوا لها ’ شفيقة
ومتولى ‘ الذى لا يعرف أن هناك فارق بين الميلودراما والاكتئاب ،
و’ الجوع ‘ فائق الشعث ، و’ الدرجة الثالثة ‘ الذى ليس
فيلما من الأصل ، و’ الراعى والنساء ‘ الذى لم يهدف إلا للحط من
كاريزمية النجوم باعتبارها رجسا من عمل سينما هولليوود الإمپريالية . إن
القتلة معروفون للجميع ، لكن أحدا لا يقدمهم للمحاكمة . وسعاد حسنى
ربما لم تكن المستهدف الأول لهم ، والمؤكد أنها ليست الأخير ، بل هو
كل نجم أو فيلم ناجح أحبه الجمهور ، ونقض به الطموحات المريضة لأصحاب ما
يسمى بالسينما الفنية . الوقت متأخر جدا أن يكتب بعض هؤلاء أخيرا أن فيلمها
الأشهر ’ خلى بالك من زوزو ‘ يمجد قيم العلم والشغل والفن واستقلالية
المرأة ، ومن ثم يعتبر عملا تقدميا ، ذلك بعد عقود من اعتبار ذوات
الأشخاص له رمزا للسينما المتخلفة . يا له من اكتشاف ! عزاؤنا الوحيد
أن أحدا بعد 20 سنة لن يذكر أى اسم من هؤلاء انصاف الكتاب والموجهين
والنقاد ، وسيذكرون فقط محبوبة الشعب المصرى الأولى سعاد حسنى . اكتب رأيك هنا
نعود للحاج متولى ، والذى تعرفت عليه لأول مرة
من ملف فى نحو الثلاثين صفحة فى مجلة ’ نصف الدنيا ‘ . أقل وصف
أنى روعت . هذا الملف ، ناهيك عن المسلسل نفسه ، يمكن أن ينتج
رسالة دكتوراه عظيمة فى علم الاجتماع عما وصل له المثقفون المصريون من تضارب
وتخبط وفصام وضياع ذهنى . مصطفى
محرم صديق كان مثلنا الأعلى فى الاقتناء والقراءة
والترجمة النهمة جميعا لكل ما يطبع بالإنجليزية عن السينما الأميركية ،
وكنا نعامله من فرط هذا كناقد أكثر منه كمؤلف للدراما . يقول فى هذا الملف
’ إن الله يحب أن تؤتى رخصه ‘ ! هذه بالنسبة لى مفاجأة شخصية ، لكن ليست
مفاجأة عامة ، ونحن نرى التدين يعصف بالمثقفين الواحد تلو الآخر ، بل
والمسلسلات نفسها تتعامل جميعا منذ زمن مع تفاصيل التزمت الدينى اليومية فى
علاقة الرجل والمرأة والتى اعتقدنا أنها انتهت منذ الثلاثينيات ، كأشياء
عادية و’ إكسسوارات ‘ بديهية للدراما التليڤزيونية المعاصرة
( لا بد أن أحيى هنا كاتبا آخر ‑أحس الآن بأسف أن لم جمعتنى به سوى
صداقة سطحية نسبيا حتى الآن‑ كاتب لم يخف يوما إيمانه الغيبى كما كان الكل
يفعل من قبل ، وكان ولا يزال يباهى بأنه يفهم الدين أكثر من أصحابه .
لكنه صاغ رؤية عصرية وشبه علمانية شاملة لكل شىء ، ونظرية بالغة النقدية
ليس للإسلاميين فقط ، بل لكل حالة التخلف ‑هل تذكر ’ النوم
فى العسل ‘ ؟ المهم أنه لم يحد ولم يساوم قط فيما ارتضاه عقله من
استنارة ، سواء بسبب المناخ العام أو لأى سبب . إنه بالطبع وحيد حامد ) . يجب على أن أعترف أنى تخيلت فى البداية أن مصطفى
محرم سيحاكى ستراتيچية فيلم ’ العار ‘ الذى قدم تاجر هيروئين متدين وملتزم بالشريعة ليدين ضمنا هذه
الشريعة . وأنه سيقدم ’ حاجا ‘ يجمع أربع زوجات فى ذات البيت
و’ يعدل ‘ بينهم بالمصطلح الدينى ، ويعيشون جميعا فى
سعادة ، فقط ليسخّف ويدين الفكرة فى النهاية . وبما أن المسلسل لا
يزال تحت التصوير ، أعتقد أنه سيفعل هذا فعلا ، ذلك بعد ثورة الغضب
التى عبرت عنها المرأة المصرية من المسلسلين ، مسلسل مصطفى محرم ،
ومسلسل البيوت التى انهارت فعلا خلال أيام قليلات من بداية شهر
’ الصوم ‘ ’ الفضيل ‘ . ذلك بعد أن ألهب خيال كل أزواج
مصر بعصر الحريم الإسلامى القديم ، وصنع أضخم وأخطر شرخ فى تاريخ أمة
العرب ، بأن شطرها نصفين بالضبط يحارب كل منهما الآخر : مائة مليون
امرأة ضد مائة مليون رجل ( مع طابور خامس محدود الحجم هنا
وهناك ) !
إن الحاج متولى هو نسخة عصر الانحطاط والرياء
الدينى من سى السيد ، وعودة ساحقة للوراء بالواقع الاجتماعى ، وهذا
ليس كلامنا كمثقفين ، إنما كلام الناس البسطاء الذين تتجاوز حياتهم الأسرية
مشتركة الكفاح هذا النموذج بكثير ، مع إقرارنا أنها لا تزال متخلفة
جدا . الفارق بين نجيب محفوظ
ومصطفى محرم أن الأول يعرف التحدى الفنى الجبار فى
تقديم شخصية كاريزمية عريضة أو ’ أفسح من الحياة ‘ كما يقال ،
دون الترويج لها بالضرورة كقدوة تحتذى . وبالتوازى مع هذا الخيط الرفيع
للغاية الذى لم ينجح فيه تاريخيا سوى قلائل عالميا ، هناك فى نفس الوقت
الحرص الواضح على بث قيم تقدمية وعلمانية غير مباشرة بين السطور طوال
الوقت ، أقلها أن السيد عبد الجواد كان أفسح من الدين نفسه أيضا ، ولم
يكن ليهبط أبدا للانصياع لما يقوله أناس مثله ، لمجرد أنهم يسمون رسلا
وأنبياء . كل هذا فى مقابل فجاجة و’ غشم ‘ الأخير فنيا فى
الترويج الصارخ لنموذجه ، ناهيك بالطبع عن أنه استقاه من عقله الإسلامى
الباطن الذى يضرب جذوره قرونا مضت فى عصور الظلام ، وهما قضيتان
مختلفتان ، وحصل فى كليهما على التقدير صفر بجدارة ( دع جانبا تواضح
طموحات الرجل العربى فى اعتبار متولى رمزا للمتعة ، وهو قزم بالنسبة لسى
السيد ، ولا نقول زوربا ورشدى أباظة وبيلل كلينتون ) . لاحظ أن
كل هذا كلام فى المعايير الفنية المحض ، ولم يتطرق للدين أو علم
الاجتماع ، أو أى شىء يخص المحتوى . الفارق الثانى هو الفارق السوسيولوچى . سنواصل استخدام مصطلح سى السيد على سبيل المرح
والتندر لسنوات طويلة ، وسننسى الحاج متولى بحلول رمضان القادم . لكن حتى لو كانت المحصلة الاجتماعية الفعلية فى الحياة
الواقعية لهذا الصراع الذى فجره المسلسل ، إيجابية وفى صالح التقدم
والاستنارة ، فإن وصمة ’ إن الله يحب أن تؤتى رخصه ‘ قد لطخت اسم
مصطفى محرم مرة واحدة وللأبد . لا أحد فى الملف يقول كلاما مفهوما كالذى قرأته
مثلا فى 11 نوڤمبر الماضى للكاتبة إقبال بركة فى عنوان بعرض كامل
الصفحة الأخيرة لصحيفة حزب التجمع اليسارى الجديدة ’ التجمع ‘ : على المرأة المصرية أن تخلع الحجاب . هنا العكس ، لا رأى من أى نوع . كل شخص يقول
الكلام وعكسه بعد سطور . شىء مألوف وطبعا محزن ، لكن لا شىء أفجعنى
قدر وجود رجاء الجداوى وسط هذه المعمعة ، وهى امرأة أعلم أن أنفها لا تزال
شامخة ، ولم تهبط قط لمستنقع التخلف . شاركت فى هذا المسلسل ،
ومن استضافوها فى هذا الملف ، لم يخطر ببالهم ‑وهم مجلة
نسائية ، صدق أو لا تصدق‑ أنها أول موديل مصرية ، ورمز كامل
لعصر تحرر المرأة المصرية . أعتقد أنها كانت ستقول أشياء رائعة لو سئلت
الأسئلة الصحيحة ، بل ربما كان الأصح أن تعطى لها المجلة التعليق الأخير
على كل ما قاله الآخرون فى هذا الملف . بعد ذلك لم يكن أمامى سوى مشاهدة حلقة أو اثنتين من
’ عائلة الحاج متولى ‘ ، ثم الالتفات لتلك البرامج ’ الرمضانية ‘
للبى بى سى . تكتشف أن نور
الشريف أصبح يقرأ القرآن يوميا ، وينادى بإلغاء
الحملات الداعية لتنظيم الأسرة وتوجيهها لإسكان الشباب ( كم شقة يمكن أن
تبنى تلك الإعلانات التليڤزيونية شبة المجانية ، ليست المشكلة ،
المشكلة المؤرقة الوحيدة أنها ضد الشريعة ! ) ، وأنه يرى فى تعدد
الزوجات حلا لمشكلة العوانس ، وإن قال بالنسبة لهذه الأخيرة إنه ليس متأكدا
جدا . زوجته بوسى ، وحبهما الجارف وزواجهما المبكر كان شيئا نمطيا من عصر الحب
لأواخر الستينيات وأوائل السبعيينيات ومثالا احتذاه آلاف الشباب ، أصبحت
تتحدث طوال الوقت بالأحاديث النبوية ، وإن حاولت إضفاء صبغة حداثية على ما
تقول ، و مثلا حاجت بقوة ضد تعدد الزوجات لكن من منظور دينى أيضا .
مضيفتهما عفاف جلال التى كان صوتها رمزا للشقاوة والأنوثة اللعوب ، بحيث لم تسند
لها البى بى سى قط قراءة الأخبار أو أى شىء جاد يوما ، أصبحت الآن الداعية
الكبيرة الشيخة عفاف جلال . وبكل جدارة تفوز تأكيدا فى السباق الكبير
للتأسلم الذى يعصف منذ سنوات بطاقم البى بى سى
العربية ، والذى تحدثنا عنه مرارا .
الخلاصة : الصورة مفزعة ، وإن كانت طبيعية ومتوقعة . والرأى
الصحيح الوحيد لم يطرح قط ، وهو أن يكون العقل مرجعنا ولتذهب كل النصوص إلى
من حيث أتت : للجحيم ! هذا ما يجب أن يكون عليه صراحة موقف الحركات
النسائية من الآن فصاعدا ، تلك التى تهب الآن ببسالة رائعة ضد كل ما يقدمه
التليڤزيون وليس هذا المسلسل وحده . أما لو جروا أنفسهن لمستنقع
مبارزات النصوص الدينية ، فنحن نضمن لهن شيئا واحدا لا غير : الهزيمة
المبرمة . إنها صندوق پاندورا الذى لن يجلب لهن إلا أضعاف أضعاف العبودية
الحالية . المرأة يجب أن تتحرر لا لتكون أكثر قدرة على إسعاد زوجها ،
أو على تربية أطفالها ، أو حتى على خدمة المجتمع والاقتصاد القومى ،
أو خدمة أو إسعاد أى أحد . إنما يجب أن تتحرر حتى تسعد نفسها ، تشبع
غرائزها الجسدية والروحية والعقلية كما تشاء هى ، وبإرادة تامة الاستقلال
منها ، أما خدمة الغير والمجتمع والاقتصاد فأمور تأتى تلقائيا فيما بعد
كآثار جانبية أو ثانوية لسعادتها هى ! أخيرا : دعك من كل هذا ، هل تريد جديا رأينا الشخصى فى موضوع مؤسسة
الزواج ؟ الإجابة : إنه ظاهرة بائدة لا تمثل حاليا أكثر من 23.5 0/0
من البيوت الأميركية ، وتتهاوى للنصف تقريبا كل عشر سنوات .
[ اقرأ هذه الإحصائيات فيما كتبنا فى 23 مايو الماضى فى صفحة الجنس ] . اكتب رأيك هنا [ تحديث : 15 ديسيمبر 2001 :
المدهش لقاء نجلاء العمرى مع مصطفى محرم ، فى البى بى سى اليوم ، وهى
المضيفة التى طالما انتقد هذا الموقع بحدة ميولها
السياسية بما فيه تحولها للإعجاب بالإسلام بعد 11 سپتمبر . كانت صارمة
وحادة فى انتقاداتها لمؤلف الحاج متولى ، وأمتعتنا بأصوات جماهيرية
مختلفة ، ظهرت أكثر وعيا وتحضرا وثقافة من الكاتب بما لا يقاس ، منها
رجل من العراق يباهى بأن زوجته شريكة بالرأى فى كل شىء . المضيفة والضيوف
حاصروا مصطفى محرم بأنه لا يبقى على شىء إلا ما قالته الشريعة بغض النظر عن
فائدته وعمليته ، وأظهروا بجلاء فصامه وأنه يرحب بالعودة لعصر الحريم وأنه
ضد التقدم وتحرر المرأة ’ ناقصة العقل والدين ‘ ، ويعتقد أن مجرد
العداء لليسار هو مسوغ للاتصاف تلقائيا بالليبرالية ( يبدو أن مفهوم
الليبرالية أكثر فكاهة عندنا من إسماعيل يس . إن الكلمة تستخدم بمعنى رائع
الفضفاضية : أن لا تكون صاحب رأى ، أو إن شئت التحديد كل ما هو ليس
يساريا ! لا يا صديقى معاداة اليسار قد تعنى أيضا التأسلم وأشد صنوف
الرجعية ، وهذه حالتك . إن اليسار الذى أقف شخصيا بالكامل ضده
سياسيا ، هو تقدمى بما لا يقاس فى الشئون الاجتماعية . أيضا فلسفيا
إليك شخص مثلى المسمى من البعض يمينيا متطرفا ، أتبنى مثلا حتى اليوم كامل
نظريات ماركس الشاب الفلسفية . ثم ما هى حرية الفنان المطلقة التى تتحدث
عنها . آمل أن يكون التزامك بالشريعة كاملا وتعتزل الفن ، فالدين لا
يعرف حرية مطلقة أو غير مطلقة ، ويعرف فقط انسحاق العبودية مطلقة
الإطلاق ) . قال مصطفى محرم كل شىء
وعكسه ، راوغ ضد كل الأسئلة ولم يرد بكلمة عن معظمها بل راح يتكلم فى أمور
مختلفة تماما . القول المفهوم الوحيد انحصر فى شىء واحد : عدم مناقشة
ما قالته الشريعة ’ هل نلف وندور على ما قاله القرآن ‘ ، بل وشدد
بوضوح على كل شىء فيها حتى نقص العقل والقوامة . ولم يتراجع عن أى شىء ظهر
فى المسلسل مستندا للشريعة الغراء : الزوجة ’ الذكية ‘ هى التى
تهرول لإعداد العشاء لزوجها ثم تهرول لإعداد الفراش أو ببساطة تقضى كل حياتها
هرولة من أجل سيدى المتولى . الزوجة ’ الصالحة ‘ هى التى لا تسأل زوجها عن أين سيذهب حتى لا
تغضبه وهذا حق مطلق له ، آدى إللى ناقص ؟ تسأله رايح
فين ؟ ! الزوجة ’ العاقلة ‘ هى التى توافق على زواجه من
أخرى وإلا ستدخل النار لأنها تقاوم شرع الله ، زائد إنه ’ كده
كده ‘ هيتجوز ، ومن العقل أن تفهم كيف يمكن أن يتراجع ومعه كل هذا
التفويض الربانى . الخلاصة المرأة هى الجارية مطلقة التبعية التى تفكر 24
ساعة فى خدمة زوجها وخدمة من يأمرها بخدمتهم ، ولا تفكر فى نفسها
مطلقا . الواقع هى أشياء تجاوزتها وربما نسيتها ‑أو على الأقل تعامت
عنها‑ المجتمعات العربية منذ عقود ، وتوظف فقط لاستعباد النساء وكبح
شخصياتهن ، ولم تعد للسطح إلا بفضل أمثاله . نجلاء العمرى تأكيدا مضيفة بارعة
مثقفة وباحثة جادة ، لكنها ككل مثقفى ومثقفات العرب فى رأيى
المتواضع ، تتجاذبهم كل المتناقضات ولا يملكون الحسم تجاهها . فى هذه
الحلقة طرحت سؤالا يمس الشريعة نفسها ، عندما سألت وماذا عن حق المرأة فى
حب أكثر من رجل ، لكن ضيفها ادعى الصمم ، أو ربما تخيل أن هذا شىء unspeakable ولا يمكن أن يسأل يوما ، ففهم السؤال بمعنى آخر . آمل فقط
أن تكتسب من الآن فصاعدا شيئا من الاتساق مع نفسها ، وتقيس كل ما دافعت عنه
اليوم مع ما تدافع عنه من تخلف قومجى وإسلامجى فى الحلقات الأخرى من
برامجها ، وتفكر أن تمد الخطوط على امتدادها وتتخيل ماذا لو حكمنا فعلا
القومجيون أو الدينيون الذين تحبهم لمجرد أنهم يقاوموا أميركا وإسرائيل
والغرب . سيدتى ببساطة المشكلة أن هويتنا
وثوابتنا هى الخطأ وهى التخلف ، وأميركا وإسرائيل والغرب هى الصواب وهى
الحضارة ، وكل الخلاف الممكن معها هو فى تكتيكات نشر هذه الحضارة ،
وأنت تريننى من أشد من أناقش هذا . لكن الذى لا نقاش فيه هو المعسكر
الآخر ، معسكرنا . إن أعداء التقدم معسكر واحد أيضا ، ومحاربتهم
جميعا هى ’ حركة التاريخ ‘ التى تحدثتى عنها اليوم بحماس يا سيدتى
الفاضلة . أستاذتى ، بكلمة : اليسار والتقدمية ليستا بالضرورة
كلمتان تعطيان نفس المعنى ، ومن أكثر ما
أفتخر به أنا شخصيا أنى لم أفقد أبدا الخيوط الفاصلة بين
الكلمتين ! ] . [ مفاجأة : 19 ديسيمبر 2001 : انتهى اليوم عرض
المسلسل بتوبة الحاج متولى ، ومشهد مضاف ربما بتعليمات من مجلس الوزراء
المصرى نفسه وليس وزير الإعلام فقط حسبما يشاع ، ينصح فيه ابنه بالاكتفاء
بزوجة واحدة . وفى قول آخر إن التعليمات أتت عنيفة من شخصية أعلى وأعلى
ترعى النشاط النسائى . بعد كل ده تصور مين طلع
الغلطان ، وسبب كل الدوشة الأونطة التى تعبت كل رجالة وستات أمة العرب
الكبرى ؟ عارف مين : ربنا . أيوه ربنا ، هو إللى قال الزواج
من أربعة ، وده ما يجيبش إلا المشاكل . ولو كان خلاهم تلاتة ما كانش
بقى فيه أى مشاكل ، فهذا العدد بتاع الثلاثى المرح والفرسان التلاتة
والثالوث المقدس ، مضمون من حيث السمن والعسل والسكر ، والصابون
كمان ! … إشمعنى صحيح أربعة ؟ ! لا أعتقد أن أحدا سيجيبنا على
هذا ، فكل مسلسلات السنوات القادمة ستتحدث عن حرية واستقلالية
المرأة ، وتعود للترويج لحب وكفاح الشباب ، على الأقل انقاذا لملايين
الشباب الذين تركهم هذا المسلسل فى العراء حرمتهم الشريعة من الحرية الجنسية ثم
ها هى تحرمهم من الزواج أيضا ، بعد أن طفشت كل البنات إلى حرملك حجاج بيت
الله متولى وشركاه . لقد أصبح متولى بالفعل مرة
وعدّت ، ولن تتكرر أبدا . هل لا زلت بعد تباهى بنجاح المسلسل يا أستاذ
محرم ؟ ها أنا أتحداك بشىء بسيط : أن اصنع جزءا ثانيا أو مسلسلا آخرا
يروج لذات القيم ، هذا طبعا أن وثق بك أحد لتصنع له أى شىء بالمرة ] . [ تحديث : 20 ديسيمبر 2001 : ثورة النساء بل وكل المجتمع لا
تزال متواصلة . بذكاء واضح نزلت كاميرات التليڤزيون لترصد ردود فعل
الناس . قلة نادرة للغاية أبدت إعجابها بخجل ، ومع ذلك أفلحت الأسئلة
فى كشف ما يسمى بالعامية ’ زوغان العين ‘ عندعم . أنا أتحدث عن
كل التليڤزيون المصرى ، وآخره اليوم برنامج مطول للقناة الثالثة
المصرية ، وأعلم أن قنوات عربية كثيرة فعلت ذات الشىء ، وأفضت لذات
الاستنتاجات ] . [ تحديث : 21 نوڤمبر 2002 : تعالى اتفرج على مسلسلات السنة إللى بعديها . الحاجان نور
الشريف ومصطفى محرم ، رفعا البقية الباقية من برقع الحياء ، وصنعا
مسلسلا طالبانيا لا ينافس ولا من الحاج الملا عمر . المشكلة الوحيدة أن
الفارس العنترى محمد صبحى بتاع بروتوكولات حكماء رمضان ، حاول ياكل الجو
منهم . الحكاية فيها فضائح دولية ، بجد موش هزار ، ومكانها صفحة الرقابة ! ] .
تجددت هذه الفكرة فى فبراير الماضى عندما حطم
’ هانيبال ‘ حشدا من
الأرقام القياسية ، منها أن أصبح صاحب أنجح افتتاح فى غير موسم
الصيف . وكان ذلك تحديدا فى الوقت الذى انهارت فيه البورصات ، وتأكد
فيه أن الاقتصاد الأميركى قد دخل مرحلة من الركود لا فكاك منها . ثم أتت
شهور الصيف فشهور ما بعد سپتمبر 11 بطوفان من الأرقام القياسية ، أفضت لأن
أصبحت 2001 أنجح سنة فى تاريخ السينما بزيادة 10 0/0 عن
أنجح عام سابق وهو العام السابق 2000 . السينما المصرية لم تخرج عن كونها
صورة طبق الأصل من هذا . بينما كنت أعكف على هذه الأرقام لكتابة تحديث ما
لها فى صفحة الصناعة ، بدأت تتفاعل قضية أصبح اسمها ’ مواطن ومخبر
وحرامى ‘ . الشيوعيون هللوا للفيلم كما
يهللون لكل أفلام داود عبد السيد ودون فهمها بالضرورة . هذا طبيعى جدا ولا
مشكلة ، وكان من ذروته مثلا استضافة مضيفة البى
بى سى إياها للناقد كمال رمزى والموجه داود عبد السيد مستغلة فى هذا كلا
البرنامجين اللذين تمتلكهما . البعض استنفر من مجرد وجود شعبان عبد الرحيم
كرمز لما يسمونه الثقافة الهابطة . وهذا أقل طبيعية لأنه نفاق من ذات الذين
سعدوا يوما بأغانيه المعادية لإسرائيل ( انا شخصيا أحب شعبان عبد الرحيم
وإسرائيل معا ، واقرأ ما كتبته فى الدراسة الرئيسة أعلاه ، وأقله تدفق
خيال كلمات أغانيه وبراعة قوافيها التى تلدغ الأذن برشاقة كبرى ، وكلها معا
تعوض بداءة الموسيقى فيها . أما عن المحتوى فإنه كما قلنا ليس المعيار
المهم مع حقيقة أن الوسيط هو الرسالة ، وإن لم يكن سيئا فى كثير من الأحيان
فى حالة شعبان عبد الرحيم ) . على أنه فجأة ، وبعد نحو أسبوعين من العرض تم
حذف تتابع كامل من الفيلم قرب نهايته ، يقدم الزواج بين ابن وابنه المواطن
والحرامى رغم شبهة زنا المحارم فيها ( وهو غير الحذف الصوتى الأصلى الموجز
الذى شطب هجوما ساخرا من شخصية اللص ضد المسيحيين ) . هنا فقط بدأت
حقا الانقسامات الحادة . المذهل أن المتدينين الذين نجحوا فى فرض هذا الحذف
خلسة من خلف الستار لم يجدوا أنفسهم طرفا فى أى معركة . إنما كانوا السبب
فى انقسام حاد بين المثقفين اليساريين أنفسهم ، حول الفيلم وحول
موجهه . ويقال إن البعض كان يستند إلى هذا التتابع فى تصوير الفيلم على أنه
استلهام مصرى لرواية جارسيا ماركيز ’ مائة عام من العزلة ‘ ،
وأنه بالتالى يشبهها فى تطوره إلى نوع من الإنحلال الخلقى تدريجى
الاستشراء ، وطبعا المدان بوضوح . بينما البعض بالعكس تماما وجدوا فى
الفيلم بصورته الجديدة تأكيدا لقناعتهم الأصلية أن ما يقدمه داود عبد السيد هو
مصالحة تاريخية بين المثقفين وبين ما يسمونه الثقافة الهابطة ، وليس أقل من
هذا . الحقيقة أن المعيار فى الحكم على محتوى فيلم
ما ، بالذات عندما يربكنا الموجهون عمدا أو عندما يكونون هم أنفسهم
مرتبكين ، هو تطوره السردى قبل أى شىء آخر . بمعنى أن المهم هو ما
تقوله الدراما لا ما يأتى على لسان الشخصيات ، لأنك ببساطة تستطيع تمثل هذه
الأخيرة كمجرد كلمة شاردة هنا وأخرى هناك ، أو أنها فقط تعبر عن رأى
الشخصية وليس رأى الفيلم . فى حالة ’ مواطن ومخبر وحرامى ‘ لسنا
حتى فى حاجة لهذا المعيار . فنصفه الثانى احتفالية كبرى واضحة جدا .
لا نرى أحدا يتذمر فيها من هذا الزواج الثلاثى ما بين المثقف ( الذى نتصوره
يعبر عن صانع الفيلم وكل جيل المثقفين الشيوعيين من خلال تعاطفه الواضح مع
الفقراء طوال الفيلم ) ، وما بين السلطة التى تنكل بهؤلاء الفقراء ،
وما بين هؤلاء الفقراء أنفسهم ممثلين فى اللص الأخلاقى بالغ التدين والجهل
معا . الاحتفالية تمثلت فى سعادة المثقف وإنطلاق قريحته كمؤلف بعد أن تبنى
أفكار اللص الأخلاقية الرجعية ، وفى الغناء الجماعى المرح المبتهج بهذه
الوحدة بين المواطنين والمخبرين والحرامية ، وفى رضا الجميع بمن فيهم
المعلق السخيف الثرثار غير المبرر أصلا ، على النتائج الطيبة والنهايات
السعيدة لكل شىء فى حياة الجميع وحياة أبنائهم ( بالمناسبة هل تذكر كيف
استخدم كيوبريك المعلق فى ’ بارى ليندون ‘ ؟ ) . حتى
ما يسمى زنا المحارم يمكن تمثله كمزيد من تأكيد قدرة ونجاح هذا الزواج الثلاثى
فى تخطى كل العقبات حتى السماوى منها . الفيلم هكذا لا يحتمل أية تأويلات ، ولا يكاد
يستحق المناقشة أصلا ، أما طوفان ما قاله النقاد عن كونه إدانة للهبوط
والإنحلال ، إلى آخر هذا الهراء ، فكان من الممكن تمثله من قبيل إما
الجهل وإما الفساد المعتادين منهم . حتى دفاع داود عبد السيد عن التطرف
الإسلامى فليس شيئا غريبا على أى أحد من المثقفين المصريين بغض النظر حتى عن
أديانهم . لذا كان مفاجأة كلية أنه ما أن كتب ناقد مثل عصام زكريا كلاما عن
محتوى الفيلم بالمعنى المذكور آنفا ، حتى اتضح أنه مس وترا حساسا للغاية
لدى الموجه ، فإذا بهذا الأخير ينفجر فى رد بالغ الحدة والغضب ضده . ترى هل فعلا داود عبد السيد متواطئ مع الإسلاميين
والثقافة السوقية ، بالذات بالنظر لخلفيته اليسارية التى تحولت تلقائيا عند
الجميع لنوع أعم من الأيديولوچية الجمهورية يتصالح مع التطرف الدينى ويتبنى
مواقف الطبقات الدنيا بشيك على بياض ؟ هل هى حالة أخرى من مسلسل الحاج متولى تسابق كل من فيه على التملص من محتواه الرجعى
الصارخ الذى لا يحتمل التأويل أيضا ، ذلك بمحاولة التمويه عليه بكافة أنواع
لوى المعانى والتشتتيت والتضليل ، عندما اكتشفوا تعرى ذلك المحتوى المتخلف
فى أعين الجميع ؟ هل بالتالى كل ما هناك أن ها هو داود عبد السيد
أيضا ، قد اكتشف فجأة كما المتوليين خطأ أن يجد نفسه محسوبا على الإسلاميين
والسوقيين ، فى عالم آخر لم يعد هو ذات العالم الذى تخيلوه عندما كتبوا هذه
الأعمال قبل 11 سپتمبر ؟ ! كواحد ممن يعرفون داود عبد السيد شخصيا ، نجزم
جميعا بأن هذه لم تكن أفكاره ، لكن بالطبع لا نملك فى نفس الوقت أن نستبعد
أن تكون هذه بداية الانقلاب . فلكل
الأشياء مرات أولى ، وهو لم يفعل أكثر مما فعله عشرات المثقفين غيره .
المفاجأة أننا عرفنا على لسان عصام زكريا نفسه أن هذا ليس هو الاحتمال
الإرجح ، وأنه لم يفكر فيه أصلا ، وأن داود عبد السيد يعتقد فعلا طوال
الوقت أنه صنع فيلما تقدميا يدين التخلف والتدين وتسيد الثقافة السوقية .
شخصيا لا أتصور كيف ، أو ربما كان هناك فيلم آخر لم نشاهده يقول هذا .
وتذكرت فقط ما يقوله المتدينون فى مثل هذه المواقف : لا حول ولا قوة إلا
بالله . من استمع لحديث داود عبد السيد المطول فى البى بى
سى ، يلحظ بوضوح أنه يفسر أفلامه بطريقة تختلف عما فهمه أغلب المشاهدين
منها ، عموما ومثقفين ونقادا . الفيلم الوحيد الذى لم يتطرق له فى هذا
الحديث ، لكنى أذكر أنه تحدث يوما عن محتواه وكان مطابقا لما فهمته شخصيا
من الفيلم ، كان فيلم ’ أرض الأحلام ‘ . هذا هو الفيلم
الوحيد الذى لم يكتبه بنفسه ! وبغض النظر أن حديث صانع أى فيلم عن محتوى
فيلمه هو عادة سيئة للغاية ولا وجود لها إلا فى بلادنا المتخلفة ، فإنه
باستثناء الفيلم الأخير كنت أميل للإعجاب بجميع أفلام داود عبد السيد
السابقة ، طبعا على النحو الذى فهمته منها . وحتى فى الحالات التى كان
يشرح فيها أفلامه بطريقة مختلفة ، إلا أنها كانت مستنيرة وجيدة على نحو عام ،
أو على الأقل غير متقاطعة جدا مع ما فهمته منها . وأذكر أن داود عبد السيد
نفسه كان واحدا من مشروعى المبكر فى أوائل الثمانينيات لتقديم من كنا نسميهم
آنذاك السينما المصرية الجديدة ‑وكنت شخصيا أقصد بها السينما ’ فوق‑المحلية ‘
أو الأميل للمذاق الاحترافى الأميركى . ذلك من خلال حوارات صحفية
معهم ، لعلها كانت الأولى فى الحياة المهنية لهذه لأسماء التى
حاورتها ، وهى الموجهين محمد خان وخيرى بشارة وداود عبد السيد ،
والكاتب بشير الديك ، وإن للأسف لم أتم الجزء الخامس من هذا المشروع ،
وكان مخططا له مع الصديق العزيز مدير التصوير سعيد الشيمى . مع الفيلم الجديد اختلف الوضع ، وبات واضحا أن
الحالة أكثر استعصاء حتى مما لم يخطر ببالنا أصلا من أنه كان يقول ما لا يقصد
طوال الوقت . مسار الصوت وحده فى فيلم المواطن ، يقف دليلا على الفصام
بين إحساسه الشخصى ، وبين ما يمكن أن يفهمه المتلقى ، وأقل الأمثلة أن
قدم الخادمة بينما موسيقى كارمن تنساب فى الخلفية ، وهى آخر ما يمكن أن
يناسبها ! والنتيجة النهائية إذن أنه إذا كان داود عبد السيد لا يعرف حقا أن الناس تفهم من أفلامه
أشياء أخرى غير تلك التى يقصدها ، فإنه الآن فى مشكلة حقيقية ! اكتب رأيك هنا
كل أفلام القصة داخل القصة أفلام سخيفة ،
أسخفها تأكيدا ’ كارمن ‘ ساورا ولا يقل سخفا كثيرا ’ النهار
لليل ‘ لتروفو أو ’ امرأة الملازم الفرنسى ‘ لرايس ، إلى
آخر ذلك الطوفان الأوروپى منها . ولعل أقصى استخدام مقبول لها فى نظر صناعة
السينما الأميركية وقطعا فى نظر الجمهور السينمائى الذى يكره كل ما هو ذهنى أو
يكسر اندماجه ، هو الاستخدام العابر وشبه الخفى لها ، مثل ذهاب البطل
والبطلة لمشاهدة أوپرا ’ لا تراڤياتا ‘ فى ’ امرأة
جميلة ‘ . إلا أن السخف فى ’ مذكرات مراهقة ‘ يأخذ بعدا
مختلفا تماما . إنه أول أفلام ’ الفيلم داخل فيلم ‘ أو
’ المسرحية داخل فيلم ‘ فى كل تاريخ السينما فى العالم ، لا ينهى
قصته الواقعية بنفس نهاية القصة الأصلية ، وهى فى هذه الحالة
كليوپاترا . صدق أو لا تصدق أن تم إنقاذ كليوپاترا من
الانتحار ؟ ! ( دع جانبا أن كليوپاترا ليست رمزا جدا
للرومانسية ) . أما عن الرسالة التى يريد الفيلم قولها فهى
بالتأكيد لا شىء بالمرة . وهذه تنويعة على حالة داود
عبد السيد أعلاه ، الذى يريد قول شىء فيصل للمتلقى غيره . هنا
تريد إيناس الدغيدى قول شىء فلا يصل أى شىء بالمرة . هل هذا هو المرض
الجديد فى صناعة السينما المصرية ، أو ما يمكن لنا إجمالا تسميته بلغة
الحوسبة ڤيروس ’ يوسف شاهين 2 ‘ ؟ حوارات لزجة طوال الوقت تقول إن الرومانسية لم تعد
تصلح هذه الأيام . لكن الدراما لا علاقة لها بما تعظ به الشفاه .
ويمضى الفيلم دون أن نعلم من المذنب العشاق الصغار أم المجتمع . أنا شخصيا
ظللت طوال العرض أسأل صديقى الناقد القديم ثم هل كان الحب كما عرفته السينما المصرية طبقا
لعبد الحليم حافظ مثلا ، يقاس بمعايير ’ الشرف ‘
و’ السمعة ‘ و’ كلام الناس ‘ و’ حفاظ البنت على
نفسها ‘ ، أم كان الاثنان يعطيان له نفسيهما بنفس القدر بلا
إرادة ، وكان هو نفسه بحكم التعريف تقريبا ، رفضا على طول الخط لهذه
القيم البالية ؟ أما قبل عبد الحليم بربع قرن ، وقبل ما كنا
نعتبره فى عصر البراءة پورنو فاضحا من قبيل ’ هات شوقك على شوقى وهات حبك على حبى ‘ ،
فإنه طبقا لنداء الثلاثينيات الشهير ’ يا حبيبى تعالى الحقنى شوف إللى جرى
لى ‘ ، فإن تعريف أسمهان للحب هو : ليه أخبى غرامى … وغرامى
هالكنى روحى وقلبى وجسمى وعقلى وجمالى
… فى يدّك يا للهول ! هذا كلام يكفى لقتل كل بنات العرب
والإبقاء فقط على الشيخة أم كلثوم ، لتراهن حتى آخر يوم فى حياتها على
التخلف والبداءة ، وتنال من الشأن أعظمه ! الحقيقة أنى لا أفهم لماذا
ثار المتدينون على الفيلم وهو ينتهج نفس أسلوبهم فى تمييع كل المواضيع بحيث لا
يحسم أى أمر ولا تخرج بأية نتيجة مفهومة . بغض النظر أن به لقطة رد فعل
قصيرة تتلقى فيها البطلة ( الممثلة التونسية هند صبرى ) ممارسة
شفوية ، ربما العكس هو الأصح . فالكلمات الدراجة التى فرضها التدين فى
السنوات الأخيرة حول مفاهيم الحب والجنس والزواج ، تسيل ببساطة على جميع
الألسنة فى الفيلم بلا استثناء ، وكأنها من المسلمات التى لا تقبل
الجدل ، ولم يفعل الفيلم أكثر من أن زادها ترسيخا . أيضا هناك إدانة
لصديقة البطلة المتحررة ( شمس ) بجعلها تخون وتكيد لصديقتها من حين
لآخر ، ناهيك عن أنها توصل لنا رسالة أن التحرر لا يعنى أكثر من إلهاب
مشاعر الذكور لكن دون أن تفقد هى ما يسمى بالعذرية ، بل وحتى دون أن تتورط
فى أية ممارسات جسدية أصلا ! رغم أننا لا نعلم ماذا تفعل بالضبط عندما
تختلى بالشبان ، إلا أن المؤكد أنها تتفوق فى جميع الأحوال على ربة الطهر
والعفاف پريتنى سپييرز شخصيا ! ببساطة ، بالمفهوم الواقعى ناهيك عن المفهوم
الدرامى ، لا يوجد فى هذا الفيلم أى حب أو أى تحرر ! نصيحة أخيرة تتعلق بآليات الفن الجماهيرى محور
اهتمام هذه الصفحة ، وأكتب هذا متوقعا كارثة تجارية للفيلم الذى يقال
قلنا فى الدراسة الرئيسة أعلاه إن ألعاب الڤيديو
فى طريقها لأن تصبح الشكل الرئيس للثقافة الإنسانية . ما أعلن اليوم خطوة
تاريخية فى هذا المجرى ، والدفعة أتت بالطبع من ظهور ثلاثة نظم جديدة لها
هذا العام هى كنصول GameCube ونسخته المحمولة Game
Boy Advance كلاهما من ناينتيندو وكنصول Xbox من مايكروسوفت ،
فضلا بالطبع عن السيادة التقليدية لنظام سونى PlayStation
2 والتى
واصلت تقدمها رغم المنافسين الشرسين من قدامى وجدد هؤلاء . مع ذلك الطريق لا يزال طويلا أمام تحقق النبوءة
بالكامل . فمبيعات الڤيديو تأجيرا وبيعا مباشرا ، بما فيه أقراص
الـ DVD
سريعة النمو هى الأخرى ، زادت بقوة هى الأخرى لتصل إلى
16.8 بليونا ، ناهيك عن التربع التقليدى للتليڤزيون بأكثر من ضعف هذا
الرقم . اكتب رأيك هنا
(Non-Official Group)
صفحتنا المهتمة بأساطير الفن الجماهيرى هذه ،
تجد ضالة مثيرة فى مثل هذه الحالة . مبدئيا هى ملحمة رهيبة كتبها شخص خطر
بباله فيما يبدو أن الأدويسا والإلياذة ربما لا تعدو لعب عيال ، فجاء بهذه
’ الأوديسا ‘ ( وعفوا لاستخدام الكلمة بمعناها الضروبى وليس لما
يسىء لطموحات تولكيين ! ) ، التى تحتشد بأضعاف مضاعفة من
الشخصيات والكائنات الخيالية التى تمر بها رحلة فتى صغير يسعى لإقاء الخاتم ذو
القوة الأعظم فى العالم فى بحر النيران ، المكان الوحيد الذى يمكن أن يدمر
هذا الخاتم ، والطريقة الوحيدة لمنع قوى الشر من الوصول إليه ، أو
بالأحرى وصول الخاتم نفسه إليها فهو يتوق لهذا . هذا هو موجز قصة فرودو
باجينز صبى صغير من العصور الوسطى أو ما تسميه الرواية الأرض الوسطى ،
يحارب لإنقاذ العالم من شر لورد الظلام ، هذا الذى لو وصل للخاتم المسحور
لأحكم قبضته الشريرة على كل العالم . باجينز ورفاقه ينتصرون فى النهاية
لإخلاصهم لقضيتهم ولإعلائهم لمعانى الصداقة والحب والخير والتضحية . إن الخير والشر مجسدان هنا بصورة نقية جدا ترقى لمستوى
أعظم الأساطير . لكن بكل الأسف تكمن فى هذا نفسه بذور النظرة الملتبسة
والمتوجسة دوما حول هذه الملحمة العملاقة ، بحيث لم تجد يوما الإجماع
النقدى الحقيقى على عظمتها . لقد صنفت من البداية كتجسيد للمنظور
الكاثوليكى الكلاسى للخير والشر ، ومن هنا وضعت فى ركن ضيق ، ووجدت من
يحبها ومن يستهين بها لهذا السبب فقط . على أن هذا لا يقلل من جماهيريتها
كاسحة الوقع ، والتى شملت الجميع رغم تشجيع الجهات الدينية بالأخص على
قراءتها . السبب أنها ظهرت بعيد الحرب الكورية ، ووجد الأميركيون فيها
تجسيدا مبسطا للخير والشر يريحهم فى نظرتهم للعالم ولأعدائهم . على أن
أجواء الوطنية المحمومة التى ميزت حقبة الخمسينيات ‑حقبة سپوتنيك .
فى الستينيات تجددت أسباب الشهرة ، لكن من باب آخر . عندما استعرت حرب
ڤييتنام وكان هناك أدبيات لا حصر لها تمتع وتشبع الشباب المعادى لهذه
الحرب والمنادى بالسلام ، فإن لورد الخواتم كانت الآن عادت أساسا بسبب هذا الفيلم ساحق النجاح الذى
أصبح من أنجح عشرة أفلام عالميا فى تاريخ السينما ، ويتجه حثيثا نحو المركز
الثانى أميركيا بعد تايتانيك ومتخطيا منافسه الأساسى لموسم أعياد شكر‑كريسماس
2001 ’ هارى پوتر ‘ . صورت أجزاؤه الثلاث معا ( نحو تسع
ساعات ) فى نيوزيلاندا بمخرج نيوزيلندى شاب ، پيتر چاكسون الذى عرفناه
من خلال بعض أفلام الرعب السيريالى الصغيرة جدا المقززة جدا مثل ’ مذاق
سىء ‘ ، لكن هذه المرة الأولى التى يجد تحت يديه فجأة 300 مليون دولار
لتصوير كامل هذه الثلاثية . لا نقول سوى أنها صدفة أن وقعت أحداث سپتمبر 2001
قبيل عرض الفيلم ، ومرة أخرى يكتشف الأميركيون أنهم أمام عدو شرس
وشرير ، وتعود النظرة البسيطة عن الخير والشر ، ويجد الملايين إشباعا
لهم فى قصة لورد الخواتم أو نسختها الهائلة على الشاشة لأول مرة ( الواقع
أنها صنعت من قبل بالرسوم المتحركة لكن لم تكن إنتاجا كبيرا ولا
ناجحا ) . الفيلم يخلص كثيرا للرواية ، لكن فيما يتعلق بالمسألة
المسيحية ، أعتقد أن مياها كثيرة جرت فى نصف القرن الأخير ، وظهرت
أساطير وأساطير ( بعضها تغلغل فى وجدان أجيال بكاملها مثل ’ حروب
النجوم ‘ ) . وتعقدت الصورة ، بحيث لم يعد يفرح المسيحى من
مجرد أن يجد أدبا يصنف العالم لخير وشر ، ولم يعد يستنفر العلمانى من
محاولة التصنيف التبسيطى للبشر هذا ، والذى كان يعد خطرا مباشرا ربما على
حياته نفسها فى أيام مواجهة الهوس الدينى تلك .
إذن الحقيقة أن ليست أحداث سپتمبر وحدها سر
النجاح ، بل تتقدم عليها المسألة التقانية المحضة . سواء فى الفيلم
الباهر بكل المعايير بصريا أو فى كثافة السرد ، أو فى ثراء التناقضات التى
تعتمل داخل كل شخصية … إلخ ، أو سواء لكون كل هذا ينطبق على الرواية
نفسها ، والتى أعتقد أن إيه أو إل تايم وارنر لم تعط هذا البعد الأخير
الوزن الذى يستحقه ( إيه أو إل تايم وارنر هى مالكة كلا من الستوديو العريق
وارنر براذرس صاحب هارى پوتر ، والذى حرص رئيس الشركة الأم على تقديمه
بنفسه فى عرض الافتتاح فى سابقة ربما لم تحدث منذ الأربعينيات ، ونيو لاين
الأصغر كثيرا منتجة ’ مملكة الخواتم ‘ ) . إنها رواية رفيعة
استحواذية أثرت فى حياة الملايين . من قرأوها فى طفولتهم هم الآن فى أواسط
عمرهم أو حتى فى كهولتهم . أى أنها مناسبة نادرة لصنع فيلم من نفس طراز
’ تايتانيك ‘ يشبع مبتغى كل الأعمار . لو كانت الشركة قد راعت هذا من البداية ولم تضع
القسط الأكبر من أسهمها وراء ’ هارى پوتر ‘ الذى لن يشاهده إلا
الأطفال ، لكانت فى تقديرى قد صنعت من لورد الخواتم أول أو على الأكثر ثانى
أنجح فيلم فى التاريخ . المؤكد فقط رغم هذا أن نتيجته فاقت توقعات الشركة
له بمراحل ، ناهيك بالطبع عن طوفان الجوائز الذى لم يكتسح هارى پوتر وحده
بل كل أفلام العالم . والحقيقة أن ليست أحداث سپتمبر وحدها سر
النجاح ، بل كونها رواية خالدة من قرأوها فى طفولتهم هم الآن فى أواسط
عمرهم أو حتى فى كهولتهم ، أى أنه مثل ’ تايتانيك ‘ فيلم يجذب كل
الأعمار . ولو كانت إيه أو إل تايم وارنر قد راعت هذا من البداية ولم تضع
القسط الأكبر من أسهمها وراء ’ هارى پوتر ‘ الذى لن يشاهده إلا
الأطفال ( ناهيك أنه كرواية ليس أكثر من تقليد لأصول أخرى أحد أكبرها
’ لورد الخواتم ‘ ) ، لكانت قد صنعت من لورد الخواتم أول أو
على الأكثر ثانى أنجح فيلم فى التاريخ . داخل أميركا على وشك تخطى هارى
پوتر ، فإن نيو لاين ليس لها ذات ذراع التوزيع الخارجى كوارنر ، ناهيك
عن أن لو الرهان الأكبر من البداية كان على لورد الخواتم لحقق ما هو أكبر داخل
أميركا نفسها . المؤكد فقط رغم هذا أن نتيجته فاقت توقعات الشركة له
بمراحل ، فضلا بالطبع عن طوفان الجوائز الذى لم يكتسح هارى پوتر وحده بل كل
أفلام العالم . تابع تطورات الحرب ضد ما بات يسمى محور الشر فى
صفحة سپتمبر … تابع تطورات
أوسكار 2001 فى صفحة التقنية …
اقرأ خلفيات أخرى من خلال مقابلة الناشيونال
ريڤيو مع چوزيف پييرس كاتب سيرة چيه . آر . آر .
تولكيين … اكتب رأيك هنا [ تحديث : 11 فبراير 2004 : تابع
بصفحة سينما ما بعد‑الإنسان مراجعة كامل السلسلة باكتمال عرضها .
الأمور بدت لنا أشد وطأة وجسامة بكثير مما قدمناه هنا ، هذا لدرجة أن كان الانطباع
العام بعد‑إنسانى أكثر من أى شىء آخر ، صورته المحورية أن قزم
الإنسان فى مواجهة هذه القوى الرهيبة حتى وإن كانت منبعها هى نفسها عقله
الأسطورى الدينى هو نفسه . هذا من ناحية يحمل الكثير من الاسقاطات عما
نواجهة حاليا من عصور ظلام جديدة تتمثل فى طغيان العرب والمسلمين على العالم أو
على الأقل برمجتهم لكامل أچندته لحسابهم الخاص . أيضا اكتمال الفيلم‑الثلاثية
قد يأتى من ناحية أخرى برؤية إضافية أو معدلة لبعض ما ورد هنا ، أقلها
إعفاؤه من تهمة المانوية أى تجسيد العالم كخير مطلق فى مواجهة شر مطلق
… فإلى هناك ! ] . Cover Story:
(Spring 2002)
العشر جوائز الرئيسة أو المسماة أيضا غير التقنية
( 3 أحسن فيلم ، 4 تمثيل ، 2 كتابة ، واحدة
إخراج ) ، جاءت اثنتان منها موافقة للتوقعات ، بينما صدمت
الثمانية الباقية كل التوقعات . المتوقعتان كانتا ’ شريك ‘ كأحسن فيلم
استحراك سمة ( راجع المدخل الأصلى عن الأوسكار فى صفحة التقنية ، وفيه اعتبرنا أن لا
مفاجآت فى الجوائز التقنية ككل ) ، وچينيفر كونيللى كأحسن ممثلة فى
دور داعم عن ’ عقل جميل ‘ . أما البقية فمفاجآت عظمى تستحق هذه
الوقفة المطولة للتحليل ومحاولة فهم ما حدث . تصدر تسميات الأوسكار بفارق وتميز واضحين فيلم
’ مملكة الخواتم ‘ . حصل على 13 تسمية ، بفارق خمس تسمياتعن
الفيلمين التاليين له ’ عقل جميل ‘ و’ موولان رووچ ‘ .
ولم يكن هناك من يشك كثيرا أنه سيكون الفائز بجائزة أوسكار أحسن متفوقا على
الأفلام الأربعة الأخرى وهى ’ عقل جميل ‘ و’ حديقة
جوسفورد ‘ و’ فى غرفة النوم ‘ و’ موولان رووچ ‘ .
فى نفس الوقت ذهبت معظم توقعات جائزة التوجيه لموجه ’ مملكة الخواتم ‘
پيتر چاكسون . لكن كما أصبحنا نعلم جميعا الآن أن الجائزتين ذهبتا لفيلم
’ عقل جميل ‘ وموجهه رون هاوارد . ثقل كبير للغاية يكاد يصل للإجماع فى الصحافة واستطلاعات
الرأى ، والأهم منها الجوائز الأخرى السابقة على الأوسكار ، وضع وراء
فوز راسيلل كرو بجائزة التمثيل عن دوره فى ’ عقل جميل ‘ . وإن
ليس بنفس الإجماع ، كان أغلب الحديث يدور عن سيسى سپاسيك كأحسن ممثلة عن
’ فى غرفة النوم ‘ ، ثم بدأ يكثر الحديث بعض الشىء عن نيكول
كيدمان ودورها فى ’ موولان رووچ ‘ . لكن أى من هؤلاء لم يفز
وجاءت النتيجة مفاجأة بالكامل فوز دينزل واشينجتون عن ’ يوم التدريب ‘
وهاللى پيرى عن ’ حفل راقص للمسخ ‘ Monster's
Ball .
نفس الحال بالنسبة لأحسن ممثل داعم حيث ذهبت لچيم برودبينت عن
’ أيريس ‘ ، بينما توقع الكل فوز السير إيان ماككيللين عن
’ مملكة الخواتم ‘ . وعندما نقول مفاجأة لا يعنى الأمر أن فيلما
أو دورا أقل جودة فاز على فيلم أكثر جودة . فالأرجح دائما أن مستويات
الأفلام ممتازة جميعا ومتقاربة جدا ، بل أن السؤال عادة ما يكون ليس على من
حصل على ترشيح بل على من لم يحصل . ما نقصده أن التيار العام الذى سرى فى
الصحافة واستطلاعات الرأى والجوائز التى منحتها جهات آخر خلقت رأيا عاما حول
مرشحين بعينهم ، فإذا بالأوسكار تذهب لأطراف كانت تحظى بأقل القليل من
الاهتمام . مثلا فى جائزة الفيلم بلغة أجنبية كان ’ أميلى ‘
قد اكتسح تقريبا كل جوائز العالم ، وكل استطلاعات الرأى كانت تعطيه 75 0/0
أو أكثر من نسب الأصوات ، ولا يحصل أى فيلم منافس إلا على أقل من 10 0/0 ،
مع ذلك جاءت النتيجة مفاجأة كلية وذهبت الجائزة للفيلم البوسنى ’ أرض لا
أحد ‘ . أخيرا وبالمثل جائزتا الكتابة ( الأصلية
والمطوعة ) ذهبتا بالترتيب لحديقة جوسفورد وعقل جميل ، بينما كان
الكلام أوفر على ’ ميمنتو ‘ و’ مملكة الخواتم ‘ . الآن
يجب أن نسأل عن السبب وراء كل هذه المفاجآت ! الإجابة بكلمة : هذا لم يكن أوسكار 2001 ، إنما أوسكار سپتمبر
2001 !
الروح الوطنية هى التى أملت الجوائز . هاللى
پيرى أول سمراء تحصل على الأوسكار طيلة سنواته الأربع والسبعين . السمر هم
أصل أميركا ، هذا أولا ، وثانيا التعاطف معهم هو تعبير عن الوحدة
الوطنية . من هنا فاز أيضا دينزل واشينجتون ليس بسبب لون بشرته فقط ،
إنما لثلاثة أسباب . السبب الثانى أن ’ يوم التدريب ‘ هو أول
فيلم ذو موضوع جاد يعرض بعد 11 سپتمبر ، وكان رمزا لعودة العجلة ولمواجهة
الواقع والحقائق . السبب الثالث أن راسيلل كرو نيوزيلندى . نعم لم يفز أى أجانب . لذا ضاع الإخراج
والسيناريو من پيتر چاكسون النيو زيلندى أيضا ، وضاع التمثيل الداعم من
السير ماككيلين . بهذا ضاعت ثلاثة جوائز كان ينظر لها كجوائز مؤكدة لمملكة
الخواتم ، بجائزة الجائزة الرابعة والأهم من الجميع أوسكار أحسن
فيلم . ذهبت الجائزة لفيلم قومى يأتى من مؤسسة
قومية ، وليس لفيلم خيالى صور فى نيو زيلندا . ’ عقل جميل ‘
يدور عن چون ناش . وهو ليس مجرد أحد الرموز العلمية لأميركا وأحد حائزى
نوبل فيها ، بل إن مشكلته النفسية نبعت أساسا من وطنيته الزائدة ،
وتحديدا الهواجس المفرطة تجاه الخطر السوڤييتى . رون هاوارد وبرايان
جريزر وشركتهما إيماچين هى صانعة أبوللو 13 الذى قدم فصلا من أخلد فصول العلم
الأميركى ، ثم ها هما يقدمان الآن رمزا علميا أميركيا آخر ، ومن ثم
يستحقان الاحتفاء والتكريم . إنهما مؤسسة ’ أميركية جدا ‘ فى
نظر الجميع ! لماذا لم يفز ’ أميلى ‘ وفاز ’ أرض
لا أحد ‘ رغم الإجماع الجارف على الأول جماهيريا ونقديا ومهرجاناتيا .
السبب واضح إنه يدور عن حرب البوسنة ، والتى كتبت أميركا الكلمة الأخيرة
فيها من خلال قيادتها لقوات حلف الأطلنطى . كل ما حدث هو كأن التاريخ يعيد نفسه . بعد ضرب
پيرل هاربور بشهور ، انتقى أعضاء الأكاديمية أكثر فيلم يعبر عن المعركة
والصمود ، وأغدقوا عليه كل الجوائز ، وكان طبعا فيلم ’ مسز مينيڤر ‘
1942 . لكن هل سيستمر هذا الشعور ؟ إنه شعور
مفهوم . الأميركيون يشعرون أنهم استضافوا كل قوميات العالم ، لكن
هؤلاء خانوهم وطعنوهم فى ظهرهم فى 11 سپتمبر . بمرور الوقت وبعد الانتصار
فى أفجانستان أو ما سوف يليها ، سوف يزول شعور التقوقع والتقنفذ أمام الغير
كخطر خارجى ، ويحل محله تدريجيا شعور القيادة والأبوية تجاه كل
العالم . لا يمكن تخيل أن يستمر الحكم بهذه الطريقة على موهبة راسيلل كرو
أو جمال نيكول كيدمان من خلال شكل جوازات سفرهم . نعم القاعدة التى نقولها مرارا لا تزال
سارية : التسميات هى الشىء الدقيق لأنها تمنح من الفروع بواسطة
المتخصصين ، أما الجائزة نفسها والتى يمنحها الأعضاء مجتمعين فالعوامل
العاطفية تلعب دورا رئيسا . لكن هل سرت هذه القاعدة على الجوائز التقنية
أيضا . لحسن الحظ لا . هذا بحكم طبيعتها لحد ما . التوضيب
( المونتاچ ) فى ’ سقوط الصقر الأسود ‘ لا يختلف عليه اثنان رغم أن مخرجه ريدلى سكوت إنجليزى وانضم
لقائمة مظاليم الأوسكار بعد فقده لها العام الماضى عن المصارع ، وهذا العام
عن هانيبال وسقوط الصقر الأسود .
موسيقى هاوارد شور فى ’ مملكة الخواتم ‘
تقول لك منذ الدقائق الحمس الأولى إنها كتبت للأوسكار . ستجد نفسك تقر بهذا
حتى لو كنت شاهدت فى اليوم السابق فيلمى چون ويلليامز ’ الذكاء
الاصطناعى ‘ و’ هارى پوتر ‘ وانبهرت بهما . هذا الكلام يسرى على التصوير والمؤثرات الخاصة
والتنميق ( الماكياچ ) فى نفس الفيلم ’ مملكة
الخواتم ‘ . ستقول أن تصميم الإنتاج ( المناظر ) فى
’ موولان رووچ ‘ شىء معتمد للجائزة . ومن طرائف الأوسكار الملفتة
أن ’ موولان رووچ ‘ 1952 لچون هيوستون قد فاز ايضا بجائزتى المناظر
والأزياء ! أيضا أزياء ’ هارى پوتر ‘ ملفتة ذكية بل
ومؤثرة دراميا . بالمثل من ’ سقوط الصقر الأسود ‘ سيلفت الصوت
أسماعك ، وإن كانت المنافسة متقاربة مع پيرل هابور مثلا . لكن پيرل
هاربور فاز بجدارة تامة بجائزة الصوت الأخرى وهى توضيب الصوت ، وهى الجائزة
التى نشأت بعد اختراع الصوت متعدد القنوات حول القاعة فى آخر السبعينيات ،
وغنى عن القول أنك تجد نفسك وسط المعركة فى پيرل هاربور تأتيك الأصوات من كل جهة
لكن دون تصنع أو افتعال أو إيقاظ لك من اندماجك فى الأحداث . كل الأغانى
المرشحة رائعة لكن فازت بها أغنية ’ إذا لم أحصل عليك ‘ من ’ حفل
راقص للمسخ ‘ ، ولو لم يكن كاتبها راندى نيومان قد فاز لدخل التاريخ
كأول من يسمى للأوسكار 16 مرة ولا يفوز ! قدمت الحفل النجمة السمراء هووپى جولدبيرج ،
وهى المرة الرابعة لها . أما المكان فقد كان مسرح كوداك وسط
هولليوود ، وهى أول عودة لهولليوود منذ سنة 1960 حيث كان تقام الحفلات فى
مسارح لوس أنچليس الأكبر وآخرها قاعة الضريح . هذا هو افتتاح مسرح كوداك
الذى تكلف 90 مليون دولار . اللحظات المؤثرة كانت تكريم روبرت ردفورد وسيدنى
پواتييه . هذا الأخير الذى كان أول ممثل اسود يحصل على جائزة أحسن ممثل عن
’ زنابق الحقل ‘ 1963 ، دخل التاريخ مرة أخرى بحصوله على تصفيق
من جمهور واقف لمدة 80 ثانية وهو رقم قياسى . اكتب رأيك هنا
ابن لطبيب شهير وتلقى تعليمه الثانوى فى
إنجلترا ، ولم يكمل تعليمه العالى من كلية التجارة جامعة القاهرة إلا
متأخرا ، نجيب محفوظ
( الأكبر بعشرين عاما ) هو أعظم وأشرس اسم لمثقف مصرى ازدرى عبد
الناصر وحقبته . وتظل بداية
ونهاية والفيلم المأخوذ عنها الأشغال الوحيدة التى
هاجمت صراحة الضباط فى عز فترة صولجانهم . وحتى مؤخرا كان من أحاديثه بخلاف هذا الاستثناء الكبير تظل حتى اليوم فاتن حمامة هى الدماغ
الأصلد والصوت الجهورى الأقوى بين كل رموز الثقافة المصرية الذى وقف بجرأة ضد كل
الأفكار اليسارية والسوقية . هذا ناهيك بالطبع عن الوضع فى الاعتبار تلك
القيود التى تفرضها النجومية والحاجة لعدم صدم الجمهور الواسع بكلمات مباشرة
طبقية أو علمانية . تلك كانت تحديدا الأشياء التى رفضتها فاتن حمامة
بقوة ، ووصل بها الأمر لحد النفى الاختيارى بعيدا عن مصر طيلة النصف الثانى
للستينيات والنصف الأول للسبعينيات . وجميع أعمالها إما تعادى صراحة
الفكرين الاشتراكى والدينى ، وإما تطرح قيما ليبرالية وتنويرية عامة
( فى آخر مسلسلاتها التليڤزيونية وجه القمر ، كان لها مونولوج
طويل عن الفشل المحتوم لحب ابنها لفتاة فقيرة ، فالفقراء للعون والتعاطف
وليسوا للزواج . كذا بإمكان المقربين منها نقل أفكار كثيرة من هذا
النوع . منها مثلا اتساقا مع ما قلناه للتو عن آراء أفلامها حول المرأة
أيضا لا يزال عمر الشريف يسبح ضد التيار
نفسه ، ولعل آخر موقف عمومى له أن قال حين عرضت عليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إنه سيذهب به إلى طابا وسيأتى إليه من هناك بكل يهود هولليوود .
وهو بالطبع الموقف النقيض بالضبط لرئيس المهرجان السابق المعادى لإسرائيل سعد
الدين وهبة . ولم تحتمل وزارة الثقافة المرتعشة مثل هذا التصريح وانصرفت
للبحث عن رئيس آخر ، ثم آخر ، ودخل المهرجان مرحلة الموت
العيادى . المفارقة أن معظم هذه الأسماء والأفلام تشير لشخص
آخر هو عز الدين ذو الفقار ، سواء بالفن أو بالصداقة أو حتى بالزواج أحيانا . لا شك
أنه كان ولا يزال العبقرية الأكبر وشبه الأوحد فى السينما المصرية ، وكان
ينتمى لهذه المجموعة طبقيا وروحيا وأجاد لأبعد مدى تقديم الطبيقة الأرستفراطية
بأرقى صورة ممكنة فى أفلامه ، لكنه من الناحية الأيديولوچية كان من أنصار
ما سمى بالعدالة الاجتماعية وفكرة تقارب الطبقات وما شابه . هذا التعاطف
الطبقى لم يكن بالشىء النادر آنذاك فى الأوساط الراقية ، ولذا لا يكاد يسلخ
عز الدين ذو الفقار من مبادئها العامة ، لا سيما مع الوضع فى الاعتبار
حرفته الفذة التى تتجاوز أحيانا الطموح الهولليوودى نفسه ‑نقصد مزج
الضروب السينمائية بنجاح مذهل بينما كانت ولا زالت هولليوود تعتبر هذا سما لشباك
التذاكر ، ولعل هذه كانت أرستقراطيته ذات السمة الشخصية المتفردة جدا‑
وكذا لو وضعنا فى الاعتبار حياته الشخصية شبه البوهيمية أو ’ الأكبر من
الحياة ‘ فى أقل وصف ممكن لها . على أية حال يظل من الصعب اعتبار هذا
المتصعلك دائم التمرد الاسم الأكثر كلاسية أو نطمية فى تجسيد ذلك العصر
الليبرالى المحافظ أو ’ البائد ‘ كما كانت تسميه أدبيات تلك
الفترة ، أو اعتباره رمزا لتلك اللمسة الأرستقراطية الرفيعة له والتى باتت
نادرة حقا بعد 1952 . الحقيقة أننا لو أردنا البحث فى حقل التوجيه
السينمائى عن ذلك النموذج القياسى لليبرالية ومسحتها الأرستقراطية ،
فالإجابة سوف نجدها أيضا عند فاتن حمامة ، هذه التى وجدت فى شخص يدعى هنرى بركات ضالتها
المنشودة بالكامل . وميزة بركات ‑أو ربما عيبه فى نظر البعض‑
أنه لا يعبر صراحة عن أية أفكار سياسية ، ويقول لا نريد الخروج عن حقل الفن بالحديث مثلا عن
پروفيسور الفلسفة عبد الرحمن بدوى وغيره كثيرون ، لكننا لو أردنا تمديد الكلام عن تلك النوعية من
النجوم لربما وجدنا عددا لا بأس به بدءا
من يوسف وهبى وليلى مراد وانتهاء بأحمد رمزى ولبنى عبد العزيز . وستجد دوما القاسم المشترك أن الجميع لم يحتمل العيش المتواصل فى
مصر الدهماء بعد 1952 ، وآثر
الرحيل للغرب فترات طالت أو قصرت . والسر إما عدم التأقلم مع الغثاء
السائد ، أو عدم الحصول على اعتماد كلى من ’ المؤسسة ‘ الثقافية
العطنة السائدة ، بسبب الخلفية الدينية غير المسلمة أو التعلم بالخارج أو
التمسك المتحدى بالقيم الغربية ( حلل وولتر آرمبروست هذا ذات مرة ،
منطلقا من الواقعة الشهيرة لوقوف أمينة
رزق فيما سمى يوم المسرح كما أن التخلف لا يتجزأ فإن
التحضر أيضا لا يتجزأ ، أو على الأقل لا يجب أن يتجزأ . وكما كان كل هؤلاء
رموزا للاتقان البالغ فى حرفهم ، ذلك المستوى من الاتقان الذى عندما يهيمن
عليك تجد نفسك لا تعرف أى من الحدود والانتماءات وتسمو فوق كل الأوطان
والأيديولوچيات ، فإن صالح سليم كان أيضا الأنموذج الذى لم يتكرر فى
حقله . ترأس مجلس النادى الأهلى [ تحديث : 7 يونيو 2002 : بمناسبة كأس العالم لكرة
القدم : التحديث يركز فى شق كبير منه على البعد
الثقافى العام وراء أزمة الكرة العربية ، وهو فى صفحة الثقافة ، وكان طبيعيا أن يرد
به المزيد عن تجربة صالح سليم عندما استقدم هيديكوتى لتدريب فريق النادى الأهلى
وأطلق يده وسانده على نحو مطلق ، وهو أمر نادرا جدا ما يحدث مع أى مدرب
أجنبى فى بلد عربى ! ] .
فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم وهى الجائزة رقم
2 للمهرجان الفيلم الفنلندى ’ الرجل بلا ماضى ‘ . لعلها أكثر
كلمات الشكر صدقا فى تاريخ كل الجوائز سينمائية كانت أو غير سينمائية ، تلك
التى جاءت من المخرج الفنلندى آكى كوريسماكى حيث قال باقتضاب شديد ’ أولا
أشكر نفسى ، ثم أشكر لجنة التحكيم ‘ . كلمة غير مسبوقة ،
لكنها تنطوى بالطبع على نوع من الغيظ الضمنى حيث كان فيلمه رائجا جدا بين النقاد
كالفيلم المحتمل للسعفة الذهبية . كان فوز پولانسكى مفاجأة له هو نفسه ، أولا
لأنها المرة الأولى التى يدعوه فيها المهرجان منذ 26 عاما ، حين تجاهلت
كلية لجنة التحكيم فيلمه ’ المستأجر ‘ . ربما رأوه مجرد فيلم رعب
لا يستحق الاهتمام ، وهو طبعا ليس كذلك ، لكنها النظرة التقليدية
السائدة فى كثير من رواد ومحكمى المهرجانات . ثانيا كل النقاد والصحافة لم
تصف ’ عازف الپيانو ‘ سوى بكلمة واحدة هى ’ عادى ‘ .
هو قصة حقيقية لعازف پيانو پولندى نجا من المحرقة لأن ضابطا ألمانيا كان يستخدمه
للعزف له شخصيا ، ثم حماه بعد ذلك . على الأقل رأى النقاد أنه لا
يضارع ’ قائمة شندلر ‘ مثلا . الحقيقة أنه فيلم غير عادى بالمرة . إنه يقول
بإمكانية المصالحة بين النازية واليهودية ، وهى المشكلة رقم 1 التى تؤرق
أوروپا سنة 2002 تحديدا ، والتى طالما أرقنا الحديث عنها فى موقعنا هذا
بدءا من الصيحة القديمة يا صفوة العالم
اتحدوا ، حتى الكلام الحافل منذ بداية العام عن ما بعد الفاشية . التوترات القديمة
بين الفاشية الجديدة وبين الأقليات عامة طفت للسطح مرة أخرى ، وتلمح أحيانا
عودة لعبارات الكراهية القديمة ضد اليهود . توقعنا من قبل أن هذه ظاهرة عابرة سرعان ما
ستزول ، وها هو بالفعل آخرون ‑منهم هذا الفيلم‑ يدعون لتركيز
اهتمام الأسرة الأوروپية أو الصفوة الحضارية للعالم ككل على الخطر الجديد ،
ألا وهو تحديدا الإسلام وهجرته الكثيفة ومعدلات إنجابه الأكثف ، كما وتدينا
معا ، والتى تكاد تعيد أوروپا وأميركا لحياة القرون الوسطى . هذا
الكلام بات يجد اليوم أصداءه فى الخطاب السياسى المعاصر ، وربما لجنة
التحكيم التى يغلب عليها الأميركيون ( ديڤيد لينش ، شارون ستون
… إلخ ) تستشعر مدى عمق أو نضج أو على الأقل أهمية مثل هذه
الرؤية . اكتب رأيك هنا Cover Story:
(Summer 2002)
نصف الدقيقة الأولى من فيلم
’ اللمبى ‘ يساوى مائة فيلم مصرى كاملة ، أو لعله أعلى نقطة
إطلاقا فى كل تاريخ الثقافة الناطقة بالعربية . البطل البلطجى السكير المعدم العاطل يترنح ليلا فى الشارع ويحاول
تذكر كلمات أغنية ما . تخيل أية أغنية ؟ ’ وقف
الخلق ‘ ، وهو يقف عند هاتين الكلمتين ، ويتركنا نتخيل أمجاد مصر
التى تحدثنا عنها بقية الأغنية ، بينما هو نفسه لا يستطيع الوقوف على ساقية
كما بقية ’ الخلق ‘ أى البشرية ، التى تحاول الأغنية إفهامنا
أنها متيمة انبهارا بعظمة مصر . هذا ليس مستغربا بالمرة على المؤلف أحمد
عبد الله ، بل وشخصية اللمبى نفسها مستقاة من فيلم ’ الناظر صلاح
الدين ‘ ( بذات الطريقة التى استقى بها فيلم الملك العقرب من أفلام
المومياء ! ) . التناقض المحورى هنا كما فى ’ صلاح
الدين ‘ ، الهوة بين الكلام والواقع . هنا الأمور أوضح ، ليس من نصف الدقيقة الأولى
بل من كل الفيلم . أسماء الشخصيات الثلاث الرئيسة هى إحالات أجنبية .
اللمبى اسم يشير للڤيسكاونت
الأول إدموند هنرى أللينبى ( هل تخيل هذا الفيلد مارشال الإنجليزى يوما أن
اسمه سوف يصبح بعد قرن من الزمان عنوانا لأنجح فيلم مصرى فى
التاريخ ! ) ، هو القائد العسكرى الذى حقق ما فشلت فيه الحروب
الصليبية وهو فتح القدس ، وهو صاحب كل الفتوحات البريطانية العظمى فى الشرق
الأوسط فى عشريات القرن العشرين ، بما فيها دحر الإمپراطورية
العثمانية ، وهو المندوب السامى البريطانى الذى عين خصيصا للقضاء على هوجة
الدهماء فى مصر المسماة ثورة 1919 ( هل تعتقد للحظة أن أحمد عبد الله الذى
استعرض عضلاته فى سرد كل التاريخ المصرى فى ’ الناظر ‘ وبمنظور فلسفى
خاص كتاريخ قهر وتخلف ، قد اختار اسم اللمبى فى سياق ذلك الفيلم
عبثا ؟ ) . حسب الشخصية وكلمات الأغانى ، اللمبى أو أللينبى
كلاهما رمز للقوة والجرأة والاقتحام أيا ما كانت الصعوبة . الأدهى أنك لو
سألت صناع اللمبى لماذا اختاروا هذا الاسم بالتحديد رمزا لكل هذه الصفات
الفذة ، على الأرجح ستكون إجابتهم نحن لم نختر شيئا ، الشعب المصرى هو
الذى اختار . نعم ، الشعب المصرى المحب كأى شعب فى الدنيا للمستعمر
المتقدم ، يسمى أبطاله بأسماء تعظيم مثل ناپوليون واللمبى ، ويسمى
الثورات ضد هذا المستعمر بأسماء تحقير مثل هوجة عرابى وهوجة سعد ! ربما كل تاريخ السينما المصرية لا
يقوى على منافسة نصف الدقيقة الأول من فيلم اللمبى ، لكن هذه النكتة التى
سمعتها من أحد الأصدقاء نزل سائح من
مطار وركب تاكسيا . انطلق التاكسى بسرعة هائلة فى طريق صلاح سالم .
انزعج السائح وراح يستجدى السائق التهدئة ، رد السائق بثقة كبيرة مشيرا
لنفسه لا تخف هذا Egyptian driver . بدأ الطريق
يزدحم والسائق مصمم على مراوغة الجميع والانطلاق بأقصى سرعة . يزداد ذعر
السائح لكن الأول يطمئنه من جديد مشيرا لنفسه لا تخف هذا Egyptian driver .
اقتربت إشارة حمراء والسيارة مندفعة تخترقها والسائح يرتعد بشدة والسائق يشير من
جديد لنفسه لا تخف هذا Egyptian driver .
الإشارة التالية كانت خضراء ، وبهدوء أوقف السائق التاكسى . السائح
يشير للضوء الأخضر ، ويسأله ما المشكلة ، تحرك ، إنها
خضراء . يشير السائق للطريق العرضى ويقول Maybe another Egyptian driver is coming !
نعم ، وقف الخلق ، فهى ’ مصر العظيمة ، مصر الهزيمة ‘ ( عبارتنا
المعهودة التى يبدو أنها وجدت أخيرا معادلا بصريا سينمائيا ما
لها ! ) ، ’ مصر أم
الدنيا ، أم كل كوارث الدنيا ‘ ، أم كل أخطاء الدنيا ،
بحيث ممارسة أى صواب فيها هو عين الخطأ . من هنا ، طبيعى للغاية أن
يكون اسم أم اللمبى فرنسا . امرأة متوسطة العمر تجمع ما بين بقايا الجمال الحاسر والدلال وخفة
الظل وأيضا التفكير المتفتح . وطبيعى أن يكون اسم صديقه هو باخ ، عازف الكمان
الكلاسى ومع ذلك يسكن ذات الحى الفقير مصر القديمة ويسد رمقه بالكاد .
عندما كان أحمد عبد الله يكتب لعلاء ولى الدين وشريف عرفة ، كانت الإحالات
الأجنبية سهلة ولا حصر لها ، بحكم شخصية البطل والمخرج معا . كانت
الأغانى الأجنبية تملأ شريط الصوت ، والسلوكيات المتحررة تملأ الصورة
والكلام … إلخ . وقد كنت مشفقا للغاية كيف سيجعل أحمد عبد الله من
اللمبى بطلا له ، وهو لا يرمز إلا لكل ما سفلى فى المجتمع المصرى .
لكن المعادلة نجحت نجاحا باهرا ، طبعا ليس فقط لتواجد الغرب وحضارته من
خلال الأسماء . إنما أساسا لأن الشخصية رائعة فى حد ذاتها . ومحمد سعد
أداء كوميدى بدنى ومواقفى لا يشبه أحدا ولا يقدر بمال ، ومستوى من تقمص
الشخصية الكوميدية لا نراه كل يوم ( ربما منذ شاپلن وچيرى ليويس ، لم
نره إلا فى چيم كارى ) ، والمؤكد أنه يستحق هو وكاتبه كل تذكرة حصداها
فى شباك التذاكر . الفيلم يحتفل بالخمر وبالرقص ، ويجد لهذا حلا
ليقدمه بحب وحسية فى مشاهد الأوساط الراقية كما فى مشاهد البسطاء . الفيلم
الذى بدأ محلقا مع ’ وقف الخلق ‘ ، يغلق أيضا بسخرية مقذعة أخرى
من أم كلثوم ( ليست غريبة على أحمد عبد الله صاحب مهزلة ‑أو قل مذبحة‑
الشيخ الشعراوى الشهيرة فى مسرحية ألاباندا ) . يبدأ العريس اللمبى
أغنية فلكلورية جدا عن الديوك والفراخ والكتاكيت ، لنكتشف بعد قليل أنها نفسها أغنية أم كلثوم ’ حب
إيه ؟ ‘ . الأغنية أصبحت هنا سوقية جدا ونوعا من الردح
الرخيص ، والسبب بسيط جدا : أن الأصل نفسه سوقى جدا ونوع من الردح
الرخيص ! ( تنبهوا لهذا فى الأيام الأخيرة وأمرت الرقابة بحذف الأغنية
من ألبوم الموسيقى ،
أضيف : لستم وحدكم يا صناع
اللمبى ! كلنا فى صبانا كنا ننظر ’ لكوكب الشرق ‘ كمغنية سوقية
أغلب الوقت ، رجعية بليدة ومتحجرة طوال الوقت . وكنا بفطرتنا لا نصدق ما
تقوله عن الحب وهى نفسها لم تعرفه أبدا . الكل كان يعرف أن أم كلثوم ليست
أكثر من مغنية ق . ع . ، قطاع عام يعنى ، مجرد سلعة أخرى من
سلع بطاقة التموين الفاسدة منتهية الصلاحية التى كان يوزعها عبد الناصر قسرا على
الشعب ، وحتى لو كان لديك نقود تكفى لشراء شىء أفضل فليس بوسعك ذلك لأن
الزعيم الملهم أمم كل شىء ولم يكن يسمح سوى ببطاقات التموين التى كانت أم كلثوم
أشهر وأفسد سلعها على وجه الإطلاق . للأسف هذا لا يزال مستمرا حتى اليوم فى
إذاعة حلمى بكر ، أقصد إذاعة بطاقة التموين ، المسماة بإذاعة الأغانى ،
مع فارق أن السوق مليئة الآن بالسلع ولا يوجد أحد مضطر لسماع تلك الإذاعة
المثيرة للشفقة والتقزز معا . أما فيما يخص الأغنية التى سخرتم منها تحديدا
فى الفيلم فقد كنت أنا شخصيا استخدمها فى صباى للسخرية من تلك المغنية البليدة
الأحفورة فاسدة الصلاحية المسماة بـ ’ الست ‘ ، وكنت أدفع قبضتى
فى كتف أو صدر من يحبونها قائلا ’ أم كلثوم إيه إللى أنت جاى تقول
عليه ‘ ، ولم يكن يهزمنى سوى زميل اسمه محمد عبد النبى يستخدم ألفاظا
أدبية رفيعة أفضل منى كأن يقول ’ بنت الوسـ.. لغاية ما تقول يا مسهرنى يكون
نص الجمهور نام ! ‘ . الأسوأ أنه رغم أنها كانت الصنم
الوحيد الرسمى بقرار جمهورى ، إلا أن الأمر لم يخل من خلق أصنام أخرى من كل
لم يستطيعوا احتواءه كمحمد عبد الوهاب مثلا الذى حاصروه وأفرغوه قدر الإمكان من
محتواه الحداثى . حتى الشباب الجيد حى الروح نسبيا كعبد الحليم حافظ ،
انتهى به الأمر فى مثل ذلك المناخ الاشتراكى الفقير ، وبعد رحيل رعيل
الشعراء العظام من جيل ما قبل يوليو ، انتهى إلى تبنى وفرة من السوقية
بالذات فى أغانى محمد حمزة الطويلة الأخيرة له ، ومع ذلك يهوى عبدة الأصنام
تصنيمه هو الآخر . هنا أنتم تستحقون تحية مزدوجة لكونكم مبدعين بارعين
ولكونكم من محطمى الأصنام ، ففى الواقع مسلسل التصنيم بالأوامر العليا لا
يزال مستمرا لأن أولئك الكهنة من نوعية معدومى الموهبة كحلمى بكر لا يتعيشون إلا
به . الآن هم يصنمون مثلا كلمات نزار قبانى سواء التى يغنيها أو لا يغنيها
كاظم الساهر . علما بأنه لا يوجد فى كل الأدب العربى ما يفوق أفكارها
ذكورية وفظاظة وپارانويا ، ناهيك عن أنها بلا استثناء تتحدث عن الحب بلغة
إدارة الأزمات أو بلغة أحمد سعيد فى إذاعة صوت العرب ، وتحتشد بكلمات تصلح
فقط لمانشيتات الصحف الحزبية السرية أو صحف حزب البعث ، وليس بالمرة للشعر
العاطفى الوجدانى . وهى ألفاظ ومصطلحات يتحشاها حتى أصحاب الشعر التحريضى
الملتهب أمثال محمود درويش الذى يكتب شعرا حقيقيا بغض النظر عن خطل فحواه
( رأينا دوما أن نجاة هى التى ظفرت بالقصيدة أو اثنتين الجيدتين للسيد
قبانى ، وكانت بالمناسبة عن مشاعر المرأة وليس مشاعر سى السيد . أم
كلثوم وعبد الحليم وفايزة قبلوا من بعد بما هو ’ نص لبة ‘ ، أما
المسكين كاظم الساهر فهو يرتع فى القمامة لا أكثر ! ) . القومجيون العربجيون ( كما
تعلم ! ) أناس مرهفو الحس فهموا وترجموا الهجوم على أم كلثوم على كونه
هجوما على عبد الناصر . بصراحة هم محقون تماما ! ما استفز كل المؤسسة
الثقافية فى فيلم اللمبى أنه أول هجوم مضاد من الثقافة الجماهيرية يفضح جهلهم
وعجزهم ورجعية أفكارهم . هم اعتادوا على أن يهاجموا هم طوال الوقت ،
ولا يهاجمهم أحد . الكل يخجلون أمام ’ ثقافتهم ‘ ومزايداتهم .
لذا فالهجوم عليهم هو تهديد ’ للمؤسسة ‘ ككل بعطونتها الضاربة وتعيشها
من الإرهاب الفكرى لكل الناس ، ويزعزع ’ ثوابتها ‘ ( إن
اردنا استعمال التعبير الأثير لبشار
الأسد ) العتيدة التى لا تلين مهما تغير العالم . هم لم يروا أنفسهم فقط على شاشة
اللمبى ، فالأسوأ أن كثيرا من الأمور خارج الشاشة كانت مشخصنة جدا ،
والشخصنة هى الشىء الذى يصل لمداركهم المحدودة بأسرع طريق ممكن . نشوى
مصطفى عضو ‑أو نحو ذلك‑ فى حزب التجمع اليسارى ، والسخرية
المباشرة من الراقصة المثقفة المتحذلقة المنافقة فى التتابع الأخير هى سخرية ليس
من المثقفين كمثقفين فقط ، إنما من نشوى مصطفى شخصيا وبالتالى من حزب
التجمع نفسه . الأسوأ ما حدث مع عبلة كامل وهى أحد الأركان الكبرى والعريقة
فى ذات الحزب المذكور . لأول مرة تضحك وترقص وتغنى وتضع البسمة على شفاه
الناس ، بعد أن اعتادوها محجبة متجهمة كئيبة فى بلاهات أسامة أنور عكاشة
التليڤزيونية ، وظيفتها أن تقطع الخميرة ( من الخمر ) من
البيت وتجعلك تفكر فى التخلص من حياتك لأنها خميرة ( من
الخمار ) . بالنسبة للتجمع وللناصريين معا ، الذين يعد السيد
عكاشة بالأحرى أحد آلهتهم ، فإن ظهور عبلة كامل بهذا الشكل الجماهيرى
المحبب هو سرقة واغتصاب لفنانة طالما احتسبوها ضلعا فى معسكرهم الظلامى ،
وجريمة لا يمكن أن تغتفر للسيد أحمد عبد الله وشركاه . الأسوأ من هذا وذاك أم
كلثوم طبعا ، وحدث ولا حرج فيما تمثل أم كلثوم عند الناصريين . هى أهم
بمراحل من عبلة كامل وأسامة أنور عكاشة ، والسخرية منها كفر صريح
بالمقدسات . فى رأيهم هى الذراع الأيمن لدعاوى ناصر العربجية ، وهى
النصر الوحيد الذى تجسدت فيه تلك الدعوة الشوفينية الهمجية بينما منيت بالخرى
والعار فى كل ساحات المعارك الأخرى . كثيرون لا يرون صوتها الأجش
جميلا ، وكثيرون ( بمن فيهم وفرة من اليسارين كيوسف إدريس مثلا )
يرونها سقيمة ومملة . طبعا هى ليست بجمال صوت أسمهان ولا فيروز ، لكن
حتى لو كانت أجمل أو أقوى فما الفائدة وقد وظفت لتكريس التخلف والبداءة وموسيقى
الطرب وتنويم السلطان مع إيقاظ شهوته ، موسيقى ربع النغمة الوضيعة
البائدة ، المسماة الموسيقى
العربية ، بينما ما كان يجب لها إلا أن تنقرض وتتلاشى وتحل محلها موسيقات
أكثر حداثة .
الناصريون لا يقولون هذا طبعا ، وقد مست سخرية اللمبى منها وترا هائل
الحساسية فيهم ! لو خرجنا من الشخصنة قليلا لن تجد الأوضاع أقل
سوءا . بينما أولئك المثقفون العرب غارقون جميعا فى أچندة المروق ومعاداة
العالم المتقدم صهيونيا إمپرياليا استعماريا جلوبيا ، أو أيا ما كان ،
فإن حبيبة البطل هى العكس لكل ما يبشرون به ، من ماضوية وانغلاق وپارانويا
ومواجهة ’ للغزو الثقافى ‘ . هى فتاة تعانى من قمع والدها
الانتهازى الجشع الذى يريد تزويجها من مدرس ثرى . والفيلم اختار لهذا الأب
غطاء رأس ياسر عرفات الشهير ، رمزا لجيل القهر والهزيمة والارتزاق ،
ربما فى أول استخدام سلبى لهذه الأيقونة المقدسة عربيا وإسلاميا وشيوعيا ،
والتى لم يكسر جلالها سوى مرة واحدة فى كاريكاتورات مصطفى حسين أيام أنور
السادات ، ولم يكسر فى وسيط فائق الجماهيرية كالسينما أبدا . هى
الوحيدة ذات الاسم المصرى نوسة ، وتصفها أغنية فى ألبوم الموسيقى بالفتاة
الشعبية المتعلمة الساعية للارتقاء بنفسها إلى آخر الأوصاف التى افتقدناها منذ
زهرة ميرامار . نوسة هذه تصالح بطلها وتتزوجه رغم مشاهدتها له فى ليلة
حمراء ، ذلك أن الحب أقوى . ويا لها من معانى تحررية طال افتقادنا لها
منذ سينما أوائل السبعينيات .
وأخيرا تماما ثم اختتام بإحالة أجنبية أخرى لا ترضى
مثقفينا كثيرا ، ذلك بعد خمس سنوات من زواج من الواضح أنه سعيد ، وابن
أللينبى يتعلم الحروف الإنجليزية ( لغة المستعمر ) عن أبيه ، هذا
الذى يبدو الآن أكثر استعدادا لتجاوز ماضيه الجاهل الوضيع ، فلا تنسى أن
الصورة المحورية كما عبرت عنها الدراما وتطور الشخصيات ، وأيضا كل كلمات
الأغانى تحررية المعانى ، هو الرغبة فى الارتقاء وحب التحضر
والمتحضرين ، والحب كان فقط الدافع الذى حرك عند اللمبى هذه الرغبة
( المشكلة الوحيدة أن ذلك التغيير قتل للمبى ، ومن ثم لا يفتح مجالا
كبيرا للمبى 2 ، لكن يظل كل شىء
ممكنا مع كاتب بموهبة وخيال أحمد عبد الله ) . إجمالا : إن ما نراه فى
حارة اللمبى هو نوع من الجلوبة التصالحية الجميلة التى تستخف جذريا بكل ما يقوله
ليلا ونهارا مثقفو وساسة العالم الثالث الفاشلين عن مقاومة الجلوبة والغزو
الثقافى … إلخ . اللمبى بكل وضاعة حالة لا يعدم أيا من الصفات المميزة
للچنرال الإنجليزى العظيم إدموند أللينبى ، وحسب الناظر صلاح الدين الناس
هم الذين أطلقوا عليه هذا ، وهذه حقيقة واقعة حتى اليوم فى حوارينا من
إطلاق أسماء المشاهير الأجانب على المميزين من عموم الشعب ، والأغرب أن
بعضهم يصبح مشهورا كلاعبى الكرة مثلا ويظل يحمل الاسم الأجنبى ! والكل يفعل
هذا بحب وإعجاب ، ولا يفكر فى الغزو الثقافى أو الدين إلى آخر ما تعج به
الصحافة . أمه الفهلوية البخيلة السليطة لكن الفطرية معا ، لا تعدم
صفات فرنسا ، التى يرى فيها المثقفون عندنا على الأقل ( وإن كنا لسنا منهم ) رمزا للجمال والثقافة
والفن ، وتاريخيا إسلاميو حى مصر القديمة ‑أو المتعصبين الدهماء حسب
الجبرتى‑ هم الذين طردوها من مصر . باخ الأشعث رغم كل إحباطاته وفقره
والتخلف الهائل المحيط به ، لا يزال يعزف الموسيقى الكلاسية بحب ،
ويكفينا المشهد الكوميدى الذى يحاول بغيظ أن يخرق فيه بعصا الكمان أذن اللمبى
الفاسدة . نوسة ‑أو مصر إذا ما جاز اعتبارها رمزا‑ حبيسة لقيود
الفقر الاجتماعى والتزمت الأخلاقى معا ، لكن روح الحياة لم تمت فيها
أبدا . وفى مشهد طريف وصريح تخبر خطيبها أنها هى أيضا عندها شهوة
جنسية ، فما كان منه إلا أن تعجب بمرح حيث كان يعتقد أنها خاصية أو حق
للرجال فقط ، أو هذا ما أفهمه إياه المجتمع الذكورى . والمهم طبعا أن
كل تلك القيم التحررية ، وتحديدا الثلاثة أجانب الأسماء ، هم من
كافحوا كى يتحقق حلم الحب لديها ، هذا بنفس القدر الذى لعبت إرادة الحياة
عندها ووقفتها الصارمة أمام أبيها الدور الفصل عندما جاءت اللحظة الحاسمة .
أحمد عبد الله ليس أسامة أنور عكاشة ، الذى
يكره من هم أرقى منه حضاريا ويشكك فى نواياهم ويجزم بأنهم يتآمرون على الشعب
المصرى ( بالذات ! ) أسوأ المؤامرات . ولعل هذا قد يغرينا
بأن ننمى نظرية فحواها أن من يؤلف
الأفلام المصرية اثنان لا ثالث لهما : أحمد عبد الله وأسامة أنور عكاشة .
مدرسة تقول نحن متخلفون حتى آخر تعريف ممكن عرفته البشرية للكلمة ، وإنه لا
خروج من التخلف إلا بالتعلم ممن هم أفضل منا وحبهم واحترامهم والاستماع
إليهم . ومدرسة تقول إننا كنز الأرض وفردوسها المفقود ، وكل العالم
يتهافت على نهبنا و’ استهدافنا ‘ والتآمر علينا . وبينما لا يوجد بعد تلاميذ كثيرون للأول ، فتلاميذ الثانى لا
نهاية لهم ، وليسوا فقط من جيله المهزوم ، بل تمت تربية أجيال جديدة
’ انتفاضية ‘ وافرة . فقط ‑ومع الاقتصار على أفلام هذا
الصيف‑ تأمل حجم الپارانويا التى يحفل بها فيلم ’ هو فى إيه ‘
( الشركات العالمية عصابات غامضة تصحو وتنام تحلم بنهب خيرات مصر الوفيرة
جدا ! ) ، أو فيلم ’ مافيا ‘ ( الذى يهبط لدرجة
أن يساير الفكرة السوقية جدا أن الموساد وراء كل شىء بما فيه المنظمات الإرهابية
بكافة مشاربها ! ) ، أو فيلم هنيدى الجديد ’ صاحب صاحبه ‘
( كارثته مزدوجة كما سنرى ) ، أو تأمل حجم الأبوية التى يورث بها
جيل الهزيمة أفكاره المقدسة للأجيال الجديدة ، بينما اللمبى لا يصرخ صرخته
المكبوتة الشهيرة ’ أنا اتخنقت ‘ قدر ما يصرخ بها لأمه ، بل
ولأبيه رغم أن هذا الأخير ميت . وهى صورة بصرية رائعة لأنها ذات الوقت
موجعة جدا لمن يفهم ، لجيل يعانى من محاولة فرض الجيل السابق لأچندته عليه
من القبر ، بل الواقع كلمة ’ اتخنقت ‘ هى بالضبط أدق لسان حال
لكل حالم ونصير للحضارة فى مصر بل وكل العالمين العربى والإسلامى ، اختنق
بما يحيط به من تخلف وغثاء . أيضا من المثير للفضول أن كاتب فيلم هنيدى هذه
المرة ، هو ماهر عواد وهو من رموز مدرسة الأفلام ’ الفنية جدا ‘
التى قتلت زوجته سعاد حسنى وحاولت قتل شريف عرفة
ومئات غيرهما . وطبعا عواد وشركاه هم فى صدارة من وسموا كل نجوم الكوميديا
الجدد وعلى رأسهم هنيدى بالطبع ، بالهبوط والسوقية والانحطاط الفكرى .
هل تريد دليلا أكثر على انتهازية الشيوعيين وسائر المثقفين أكثر من هذا ؟
أم لعلهم اكتشفوا متأخرا ما قلناه منذ سنوات فى صدر الدراسة الرئيسة
أعلاه ، من أن هنيدى وعكاشة وجهان لعملة واحدة ؟ أم لعلنا قصدنا أن عكاشة
هو الكاتب المثالى لهنيدى ، وهنيدى هو الممثل المثالى لعكاشة ؟ وما
فعله عواد هو خطوة نحو لقاء لا شك أنه كان يستعصى على خيال الجميع حين كتبنا ما
كتبنا ( طبعا لا أشك أنهم سوف يسمونه ’ لقاء العمالقة ‘ ،
وهو بالأحرى لقاء الأقزام ليس فقط لقصر قامتيهما ، إنما باعتبار أن عواد
مجرد بشير ، ومما يحب دوما التبشير به أن بأن الأقزام قادمون . ما أردنا قوله إن أحمد عبد الله هنا ، تمكن من
التوصل للمعادلات التى ربما بدت لوهلة مستحيلة ، لقالب الحكى النمطى القديم
له . وهو دخول ولى الدين ابن العز لدنيا الدهماء فى عبود وصلاح الدين وابن
عز ( تمادى فى هذا الأخير فى ازدراء الطبقات الدنيا فعوقب بقسوة فى شباك
التذاكر ) . الآن أصبح دخول اللمبى للعوالم العليا ينقل نفس المعانى
تقريبا من رفض التخلف ، وهذا خبر سعيد جدا بالنسبة لنا ، لأنه سيفتح
آفاق أعمال كثيرة لأحمد عبد الله ، تخرجه من قالب عبود على الحدود . اللمبى من قاع المجتمع لكن لديه من الذكاء وانبساط
الشخصية ما يجعله يفهم بسرعة كيف تسير الأمور فى فنادق شرم الشيخ أو فى منزل
الراقصة التونسية ( ولاحظ أنه كما أن عبد الله ليس عكاشة ، فإن سعد
بدوره ليس هنيدى ) . وهو يتأقلم كل مرة مع وظيفته بسرعة وبمرح ،
إلى أن يطرد منها لأسباب تخرج عن إرادته ( تحديدا الحكومة ، هذه التى
يبدو أنها تقف بالمرصاد لحرية التجارة وحرية الفرد معا أو كل على حدة .
وحتى لو هذه تلفيقة ما من الفيلم إلا أنها أدت الغرض جيدا ! ) .
إن ذلك العالم الفوقى للأثرياء غير مدان ، وهذه العادة دائما عند أحمد عبد
الله ، ذلك إلى العكس بالضبط عند هنيدى وعكاشة . ومثلا الغناء الغربى
إما أن ينطلق فى الناظر صلاح الدين ( أو أمير الظلام الذى سنتحدث عنه للتو
من مدرسة تقدمية أخرى عريقة هى عادل إمام ) ، وأشباههما ، بهدف
المتعة ولأنها موسيقى جميلة ولأنها تتيح لنا رؤية حسناوات يرقصن عليها ،
وإما أن تصاحب هذه الأغانى فى ’ هو فى إيه ؟ ‘ وكل المدرسة
العكاشية ، عرضا للأزياء هو ستار للصوص الأجانب الذين ينهبون البلد . المشكلة ‑والأمر يستوى فى
قالب حكى ولى الدين ابن العز أو قالب حكى سعد ابن الحضيض ، حيث كلاهما يعرف
ما هو التقدم ويقف فى صفه‑ المشكلة كما قلنا فى الهوة بين الكلام
والواقع . هنا ينتهى دور الأفلام وتعتبر أدت رسالتها على أكمل وجه ،
ويبدأ دور المشاهد الذى عليه أن يفهم من الصورة الإجمالية التى قدمتها ،
الفارق بين أن نقول بديماجوچية أننا لسنا ضد العلم ولا التقنية ولا البيزنس ولا
التحرر الاجتماعى ، وبين أن كل خلية فينا ترفض هذا بحسم . وأن يدرك أن
كل خطابنا الإعلامى والثقافى المعادى لأميركا وإسرائيل أو أيا ما كانت رموز
التقدم ، يعادل بالضبط أن نقول ’ وقف الخلق ‘ ، بينما لا
نقوى أنفسنا على الوقوف على ساقينا ، أو لا تقوى ذاكرتنا حتى على تذكر بقية
العبارة ! وعلى ذكر المؤلف هنا ، من نافلة القول أنه لا يجب بالضرورة
أن يكون قد ’ نظّر ‘ لكل شىء حرفيا كما نفعل نحن هنا ، فالإبداع
، بالذات الكوميدى منه ، لا يخضع لتنظيرات مسبقة ، وكثير منه يأتى
عفو اللحظة ويفرض نفسه . لكن فى النهاية ها هى إليك حالة كيف يشتغل عقل
تحررى مستنير عندما يبدع ، وكيف تتسلل أشياء رائعة إلى أدنى التفاصيل ربما
دون تعمد منه . فقط من عقله الباطن إلى الورق مباشرة .
نعم ، أفلام قليلة للغاية
( وطبعا نكت قليلة أيضا ! ) تلك التى أمسكت بما يمكن تسميته
المسألة المصرية . نذكر منها ’ للحب قصة أخيرة ‘ ، و’ النوم
فى العسل ‘ . المسألة المصرية : مسألة التخلف ،
مسألة تكلس نمط الحياة لسبعة آلاف سنة ، ومن ثم اللواذ بالخرافة وغياب
الاستعداد للمصالحة مع حقائق العصر ، والتمنع فى التواضع والحب نحو الغير
المتقدم ، وفى المحصلة النهائية الكسل والعجز والهزيمة المطلقة
جميعا . ’ اللمبى ‘ ( مثله مثل ’ خللى بالك من
زوزو ‘ اللذان يشتركان معا فى بساطة الظاهر ) واحد من هذه
الأفلام . هذا من حيث محتواه التقدمى
الراقى ، أما ككل من حيث القيمة الكلية أى المحتوى والإمتاع الفنى
معا ، فهو بلا شك ( مثل ’ زوزو ‘ أيضا ) واحد من أفضل
الأفلام المصرية إطلاقا منذ رحيل عز الدين ذو الفقار ( ومثل
’ زوزو ‘ أيضا ليس غريبا أن استحق أن يصبح فى حينه ’ أنجح فيلم
فى تاريخ السينما المصرية ‘ . وعامة لا يرقى للقب أحسن فيلم منذ رحيل
عز الدين ذو الفقار سوى حفنة أفلام محدودة جدا جمعت كل الفضائل معا جماهيرية
وفنا ورؤية وفكرا ، ولعل أبرزها جميعا ’ ضربة شمس ‘ لمحمد
خان ) . لكل هذه الأسباب وتلك
مجتمعة ، كان ’ اللمبى ‘ أحد أخطر التهديدات التى تعرضت لها
’ المؤسسة ‘ فى الحقبة الأخيرة . وبهجومه الساحق المفاجئ وغير
المتوقع عليهم فى عقر دارهم ، فضح عطونتهم وشعر المثقفون بأن الأرض تهتز
تحت أقدامهم ، وهم الذين طالما تحصنوا بعش
الدبابير والعناكب والصراصير المسمى بالثوابت ، فما بالك إذا كان
الهجوم بكشاف ضوء قدرته 25 مليون جنيه مصرى ! … عادل إمام يقدم فى أمير الظلام
عملا بذات هذا المستوى المعتدل ‑أى غير الصارخ أو المسرف‑ من
استعقاد المعانى ، لكن بجرعة أكبر كثيرا من الغضب . هو ’ بطل ‘ من أبطال حرب أكتوبر ، لكن لم يتح لنا
الفيلم تلك نصف الدقيقة اللمباوية ، قبل أن يكسر هالة هذه البطولة ،
إذ يباغته مدير دار المكفوفين : ’ عارف يا سيدى ! بس كل الشعب
كان أبطال فى حرب أكتوبر ! ‘ . وفى منتصف الفيلم نعرف المزيد عن
بطولة هذا الشعب ، ونعرف أن فلاحى إحدى القرى هم من أوسعوا هذا البطل
الطيار ضربا وكانوا السبب أن أفقدوه بصره . وهى لحظة معبرة عما هو أعمق من
ترنح اللمبى فى افتتاحية فيلمه ، وإن لم تكن مبتكرة بصريا وسينمائية جدا
مثلها . ببساطة هذا يقول إن كرهنا
الزائد عن الحد لأعدائنا قد أدى بنا للعمى . عادل إمام بتاريخه وكاريزميته المهيبة يكاد يرعبك
بغضبه هذا ، الذى تحس أنه غضب شخصى من كل ما حولنا من تخلف . أفلام عادل
إمام التى كانت المكان الوحيد فى الثقافة العربية الذى يمكن أن يقال فيه إن
بكارة الفتاة فى الغرب تستدعى إرسالها لطبيب نفسى ، يخطو خطوة أخرى هذه
المرة . ترى ما هى البطولة التى سيقوم بها اليوم بطل حرب أكتوبر
الضرير ، الذى شغلته اليومية الوحيدة كيفية التسلل من الدار الصارمة
بيروقراطيا بحثا عن بعض المتعة فى الخارج ؟ إنها إنقاذ ضيف كبير قادم للبلد
من الاغتيال ، والتلميحات بالحديث عن مدى أهميته وكون منظمات الإرهاب
تستهدفه ، تتركك تتخيل أنه الرئيس الأميركى بالذات ، دع جانبا أن سبق
الفيلم بعض الربط الصحفى بينه وبين الأفلام الأميركية المشابهة . طبعا ليس
هناك علم على سيارة هذا الرئيس ، لكن هذا يندرج فى إطار الحنكة المحدودة
للموجه الجديد رامى إمام ( ابن عادل ) ، وهفواته التى لا
تنتهى . ومنها مثلا أن نرى المغتال يسب بكلمات بذيئة ، بينما المفروض
أن لا يفقد أعصابه أبدا . ومنها الاستخدام المراهق للقطات مؤثرات كلها
بدائية ولا لزوم لها ( رغم هذا يظل التتابع الأخير الحافل بالنشاط تتابعا
متواضع الطموح ، لكن جيد التنفيذ كثيرا فى هذه الحدود . هنا تجدر
المقارنة بفيلم نشاط أكثر طموحا هو ’ مافيا ‘ ، لكنه لهذا السبب
كان أقل إقناعا ، وعلى الأقل كان من الممكن حذف نصف ساعة لتحسين
الإيقاع ، منها بالطبع كل ذلك الوعظ الوطنى السخيف زائد المباشرة . ورغم التنفيذ
’ المقبول ‘ لبعض المشاهد التى عادة ما تثير السخرية فى السينما المصرية ،
ورغم أنه بالتأكيد جهد وطموح وجدية تستحق التقدير جميعا ، فإن هذا لا ينفى
كونه فيلما خاليا من الروح . وتظل المنافسة غير واردة بينه وبين أفضل فيلمى
نشاط مصريين لما بعد فترة العصر الذهبى ، وهما ’ دائرة
الانتقام ‘ و’ ضربة شمس ‘ ، حيث للعنف روح حية فى
الأول ، ويعد الثانى أحد أفضل الأفلام الوجودية المصرية ) . شيرين سيف النصر ، يحيلنا لقاؤها الثانى هذا
مع عادل إمام لفيلم النوم
فى العسل ، وهو لفريق وحيد حامد وشريف عرفة ، وأحد أغضب وأجرأ الأفلام
المصرية نقدا للتخلف والديماجوچية والعجز فى الفكر والثقافة المصرية . أيضا
كما اللمبى ، لا ينسى عادل إمام أن يقدم فى أمير الظلام تلك التحية العابرة
للكمان الذى يعزف موسيقى غربية ، وتلك التحية العريضة جدا للخمر ،
التى يعلم الجميع أنه يحبها هو شخصيا ، وكلاهما تنفيس عن غضب دفين آخر مما
نعانيه من قهر وكبت هائلين على صعيد الحقوق الشخصية
والفردية ، باسم الدين أو الوطنية أو غيرهما . الخلاصة : على العكس من النوم
فى العسل ، وعلى نحو بالغ الشبه من ’ اللمبى ‘ ، ليس
هناك شىء كبير يقال ، لكن الغضب من الذات ومن التخلف يتسلل إلى كل مشهد
بطريقة أو بأخرى . وهذا يوصلنا للب القصيد ، أن لم تعد السينما
المصرية الجماهيرية تحتمل المحتويات الضخمة أو الصارخة للعب مع الكبار والإرهاب
والكباب وطيور الظلام ( مع إعجابنا الكامل بها ) ، إنما فقط بعض
المعانى والأفكار الجميلة التقدمية التى توضع على نحو عابر جدا وفنى جدا فى سياق
الترفيه . هذا يقربنا كثيرا من أسلوب السينما الأميركية ، وأن بدأ عصر
وحيد حامد فى التراجع وعصر أحمد ’ اللمبى ‘ عبد الله فى التصدر ،
ما هو إلا علامة نضج !
بمناسبة وحيد حامد فهو فى الفيلم الأخير’ محامى خلع ‘ لم
يسع لمحتوى كبير يذكر ، فقط بعض الانتقادات الاجتماعية العابرة ، أخف
حتى بكثير مما يحتمله اللمبى مثلا ، ويكاد ينحصر المحتوى الوحيد ذو الشأن
فى مجرد الكلام فى حد ذاته عما يسمى الخلع ، ذلك لتكريس كونه حقيقة واقعة
وبديهية لحق المرأة فى التطليق ( مع غض النظر عن كثير من الظلم والتمييز
ضدها مقارنة بما لو كان من طلب الطلاق هو الرجل ، والنابع من كونه ليس
الطلاق المدنى العلمانى الذى يعرفه كل العالم ، إنما هو نسخة مستقاة من
الشريعة الإسلامية ، وطبعا الفيلم لم يتعرض لشىء كهذا بالمرة ) .
المهم هنا أن وحيد حامد بكل تراثه فى المحتوى الصارخ ، هو الذى تحول للا
محتوى تقريبا . إنه وعى مذهل وبصراحة غير متوقع ، بأن هذه هى طبيعة
السينما فى كل زمان ومكان ، ناهيك بالأحرى عن فترات الكساد الاقتصادى
( ناقشنا من قبل ظاهرة رواج الترفيه فى فترات
الأزمة ) . أرقام الإيرادات أثبتت كم كان وحيد حامد على حق ،
ونجح فيلمه بينما فشلت پارانويات هنيدى ومحمد فؤاد ، التى تريد أن تأتى
بالناس للسينما لتقول لهم ذات الأشياء التى قرفوا منها فى تليڤزيونات
الانتفاضة وخطب صحف المعارصة . نعم ، السينما لا تحتمل إلا أن يكون
المحتوى خفيا تحرريا وممتعا للعقل الباطن وليس أكثر كما اللمبى ، أو لا
محتوى على الإطلاق كمحامى الخلع . المدهش أن حنجوريى النقد لا يميزون حتى
بين الاثنين ، ويسمونهما سواء بسواء تغييب الوعى . كذلك من مظاهر النضج أيضا أن بدأت دعايات الأفلام
تنسب الأفلام لكتاب تمثيلية الشاشة screenplay لأول مرة ، كعبارة
’ فيلم للمؤلف وحيد حامد ‘ . أنا حقيقة لا أعرف شيئا تقريبا عن موجهى أى من تلك
الأفلام . كل ما أتخيله أنهم شباب صغير جدا منخفض الأجر جدا . هذا
يشبه أيضا الوضع الحالى فى السينما الأميركية ، الأبعد إن لم يكن أيضا يشبه
على نحو ما العودة لنظام الاستوديوهات القديم ، عندما كان
’ الموجهون ‘ directors لا يعرفون ماذا ’ سيوجهون ‘ direct إلا صبيحة يوم التصوير . نعم الموجه ليس بحال المبدع الأساسى أو
المهم ، بل شخص يأتى يوم التصوير للقيام بمهمة إشرافية ما ثم تنتهى علاقته
بما صوره فى مساء نفس اليوم ، أو بالعامية المصرية ’ يأخذ حسنته
ويمشى ‘ . أما المبدع الحقيقى فهو المؤلف ، ولا مبدع أعلى منه
إلا المنتج ، ولا مبدع أعلى منهما ومن الجميع إلا الستوديو نفسه كمدير وككيان ،
هذا الذى تكتسب الأفلام شخصيتها منه قبل اكتسابها شيئا من أى أحد آخر .
وطبعا هذه قصص أفضنا فيها فى صفحة هولليوود ،
وقبلها عقود من الكتابة لا تأتى إلا بوجع الدماغ ، انتظارا لأن يفهم أحد
يوما شيئا ! فهل يفهمون اليوم ؟ … وبعد ، وبمناسبة الموقف المخجل للغاية للنقاد
من الأفلام الناجحة عامة ومن اللمبى بالذات الذى واجه هجمة شرسة مذرية ، ما
كان من محمد سعد إلا أن سفهها بطريقة طريفة وذكية حقا ، عندما قال من هنا قد يطول الكلام ويكفينا فيه إيجازا تكرار ما
كتبناه أعلاه على هامش الدراسة الرئيسة لهذه الصفحة : ’ الناقد يجلس فى قاعة العرض ليكتب ما شعر به تجاه
الفيلم . هذه ليست وظيفته . وظيفته أن يكتب مشاعر المشاهد فى المقعد
المجاور . مشكلة النقاد أنهم يفترضون أن الأفلام تصنع لتعزية هواجسهم هم
الذهنية ، بينما الحقيقة أنها تصنع من أجل الناس . فقط دور الناقد
التأكد من أنها تناسب المستوى العقلى والوجدانى لهذا العموم من الناس ‘ . نضيف سؤالا جديدا هذه المرة تطرحه هذه الأفلام التى
نتكلم عنها اليوم : لماذا يقبل
النقاد من الرسم والباليه والموسيقى أن تكون فنونا تعبيرية ، يحتل المحتوى
فيها مكانا ثانويا أو خفيا أو لا وجود له بالمرة ، ويستنكرون ذات الشىء على
السينما ؟ أو بلاش ، إليكم هذا السؤال الأسهل : أى شىء تغزلتم فيه فى أفلام من تسمونهم بالمهمشين
ممن صنعها المتمتعون بخاتم الحصانة الأيديولوچى ( ’ ليه يا
بنفسج ‘ مثلا ، حيث الغزل فيه كثير جدا سواء محليا أو من الأممية
الشيوعية العالمية المسماة بمهرجانات السينما ) ، وليس موجودا فى
’ اللمبى ‘ بشكل أرقى وأمتع بل وأكثر فلسفية وتأملا ؟ بلاش دى كمان . سأذكركم بكلمة أخرى أسهل وأسهل
من الدراسة الرئيسة إياها : سينما
الكوميديا إللى موش عاجباكم دى ، هى البداية لتأسيس السينما كصناعة لأول
مرة فى مصر ، دى إللى كانت طول عمرها سينما هواة ( حاشا للسيلليوليد
لم أقصدكم أنتم إنما قصدت عز الدين ذو الفقار وكمال الشيخ وبركات وصلاح أبو
سيف ، وارجعوا للكلام فوق ) . عارف
بأفكرككم بيها ليه ؟ علشان أقول لكم موتوا بغيظكم ! السينما المصرية
تجاوزت الآن كل هذا وكل السجلات القياسية : إنها اليوم سينما عريقة تضرب
بجذورها فى أعماق تاريخ ، عمرها تجاوز الآن الست سنوات ! اكتب رأيك هنا [ تحديث : 7 سپتمبر 2002 : مؤخرا
انبرت بعض الأصوات للدفاع عن ’ اللمبى ‘ . بعضهم من الصناعة
نفسها ، وبعضهم [ تحديث : 15 سپتمبر 2002 : اليوم تحدث محمد هلال صاحب كلمات أغانى اللمبى فى جريدة اسمها التجمع . الكلام جاء صدى لما قاله بالأمس مؤلف موسيقى عصام كاريكا فى ملحق التليڤزيون مع مجلة الأهرام العربى ، وإن تركز معظمه على أغنيتهما معا ’ شنكوتى ‘ . عصام كاريكا تحدث أكثر عن اللمبى . قال صراحة أنه أراد السخرية من أم كلثوم ، وأن أغنيتها ’ ردح ‘ فعلا ! واعترف بذات المعنى الذى توقعناه عاليه أنه لم يفعل سوى أن نقلها عن أحد الأفراح الفلكلورية . أيضا أفاد فى موضوعات شتى منها قوله مثلا إن محاكاة الغرب مطلوبة ، وبدونها لن نصل بفنونا لمستوى العالمية ، وأن مسألة ما يسمونه الفن الهابط كلها حقد فى غيظ من أعداء النجاح . الشجاعة عملة نادرة هذه الأيام ، من ثم كل التحية لكاريكا ، وإن كنت لا أفهم جدا معنى هذا الاسم ، ولا بأس ، ففى الفن الجماهيرى ليس مطلوبا أن تفهم كل شىء ! ] . |
| FIRST | PREVIOUS | PART I | NEXT | LATEST |